( وهي ) أي اللغة نوعان ( مفرد ، كزيد ، ومركب ، كعبد الله ) أما المفرد فلا نزاع في وضع العرب له ، وأما المركب ، فالصحيح : أنه من اللغة . وعليه الأكثر ، وأن المركب مرادف للمؤلف ، لترادف التركيب والتأليف .
ثم اعلم أن المفرد في اصطلاح النحاة : هو الكلمة الواحدة ، كما مثلنا في المتن ، وعند المناطقة والأصوليين : لفظ وضع لمعنى ، ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له . فشمل ذلك أربعة أقسام . الأول : ما لا جزء له ألبتة ، كباء الجر . [ ص: 33 ] الثاني : ما له جزء ، ولكن لا يدل مطلقا ، كالزاي من زيد . الثالث : ما له جزء يدل ، لكن لا على جزء المعنى . كإن من حروف إنسان . فإنها لا تدل على بعض الإنسان ، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي . الرابع : ما له جزء يدل على جزء المعنى ، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا : حيوان ناطق ، علما على شخص .
واعلم أيضا : أن المركب عند النحاة : ما كان أكثر من كلمة ، فشمل التركيب المزجي ، كبعلبك ، وسيبويه ، وخمسة عشر ، ونحوها ، والمضاف ، ولو علما ، كما مثلنا في المتن . وعند المناطقة والأصوليين : ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له ، فشمل الإسنادي ، كقام زيد ، والإضافي : كغلام زيد ، والتقييدي ، كزيد العالم . وأما نحو " يضرب " فمفرد على مذهب النحاة ، ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين ; لأن الياء منه تدل على جزء معناه ، وهو المضارعة .
( والمفرد ) من حيث هو قسمان قسم ( مهمل ) كأسماء حروف الهجاء ; لأن مدلولاتها هي عينها . فإن مدلول الألف : " أ " ومدلول الباء " ب " . وهكذا إلى آخرها . وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء . قال ابن العراقي وغيره : ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف ، وهو مهمل ، لا معنى له ، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره ( و ) قسم ( مستعمل ) .
إذا تقرر هذا ( ف ) المفرد المستعمل ( إن استقل بمعناه . فإن دل بهيئته على زمن ) من الأزمنة ( الثلاثة ) وهي الماضي والحال والاستقبال ( ف ) هو ( الفعل ) ( هو ) أي الفعل ثلاثة أنواع . أحدها ( ماض ) كقام ونحوه ( ويعرض له الاستقبال بالشرط ) نحو إن قام زيد قمت . فأصل وضعه للماضي . وقد يخرج عن أصله لما يعرض له ( و ) النوع الثاني ( مضارع ) كيقوم ونحوه ( ويعرض له المضي بلم ) نحو لم يقم زيد . فأصل وضعه للحال والاستقبال .
وقد يخرج عن أصله لما يعرض له ، وللعلماء فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة . المشهور منها : أنه مشترك بين الحال والاستقبال . قال ابن مالك : إلا أن الحال يترجح عند التجرد . الثاني : أنه [ ص: 34 ] حقيقة في الحال ، مجاز في الاستقبال . الثالث : أنه حقيقة في الاستقبال ، مجاز في الحال . الرابع : أنه حقيقة في الحال ، ولا يستعمل في الاستقبال أصلا ، لا حقيقة ولا مجازا . الخامس : أنه حقيقة في الاستقبال ، ولا يستعمل في الحال أصلا ، لا حقيقة . ولا مجازا . وأما استعماله فيما يعرض له ، فمجاز وفاقا ( وأمر ) أي والنوع الثالث من الأفعال : فعل الأمر كقم .
( وتجرده ) أي تجرد الفعل ( عن الزمان ) أي عن أحد الأزمنة الثلاثة ( للإنشاء ) كزوجت وقبلت ( عارض ) بوضع العرف ( وقد يلزمه ) أي يلزم الفعل التجرد عن الزمان ( كعسى ) فإنه وضع أولا للماضي ، ولم يستعمل فيه قط ، بل في الإنشاء . قال القاضي عضد الدين : وكذا " حبذا " فإنه لا معنى لها في الأزمنة ( وقد ) يتجرد الفعل عن الزمان و ( لا ) يلزمه التجرد ( كنعم ) وبئس ، فإنهما تارة يستعملان على أصلهما ، كنعم زيد أمس ، وبئس زيد أمس . وتارة يستعملان لا بنظر إلى زمان ، بل لقصد المدح أو الذم مطلقا كنعم زيد ، وبئس زيد . ( وإلا ) أي وإن لم يدل المفرد المستعمل بمعناه بهيئته على أحد الأزمنة ( ف ) هو ( الاسم ) فصبوح ، وغبوق . وأمس ، وغد : وضارب أمس ، وضارب اليوم ، ونحو ذلك : يدل بنفسه على الزمان ، لكن لم يدل وضعا ، بل لعارض .
كاللفظ بالاسم ومدلوله . فإنه لازم كالمكان ، ونحو : صه ، دل على " اسكت " وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال ، والمضارع إن قيل : مشترك بين الحال والاستقبال فوضعه لأحدهما ، واللبس عند السامع . ( وإن لم يستقل ) اللفظ المفرد بمعناه ، كعن ولن ( ف ) هو ( الحرف ) . والصحيح أنه يحد ( وهو ما دل على معنى في غيره ) ليخرج الاسم والفعل . وقيل : لا يحتاج إلى حد ، لأن ترك العلامة له علامة ورد بأن الحد لتعريف حقيقة المحدود ، ولا تعرف حقيقة بترك تعريفها .
( و ) أما ( المركب ) من حيث هو أيضا : فقسمان ، قسم ( مهمل ) وهو ( موجود ) في اختيار البيضاوي والتاج السبكي . ومثلاه بالهذيان . فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل . وقال الرازي : والأشبه أنه غير موجود ، لأن الغرض [ ص: 35 ] من التركيب الإفادة . وهذا إنما يدل على أن المهمل غير موضوع ، لا على أنه لم يوضع له اسم ، واتفقوا على أن المهمل ( لم تضعه العرب ) قطعا . ( و ) القسم الثاني ( مستعمل وضعته ) العرب خلافا للرازي ، وابن مالك وجمع ، ويدل على صحة وضعه : أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها ، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية ، كتقديم المضاف إليه على المضاف ، وإن كان مقدما في غير لغة العرب . وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول ، وغير ذلك مما لا ينحصر فحجروا في التركيب . كما في المفردات . قال القرافي : وهو الصحيح ، وعزاه غيره إلى الجمهور .
والقول الثاني : أن العرب لم تضع المركب ، بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد ، بل يدركه ضرورة [ و ] لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب . كالمفردات . قال البرماوي : والتحقيق أن يقال : إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع ، وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك .
قال في شرح التحرير : ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب ؟ وأن العلاقة هل تشترط في آحاده ؟ ونحو ذلك ( وهو ) أي المركب الذي وضعته العرب نوعان . أحدهما ( غير جملة ، كمثنى ) لأنه مركب من مفرده ومن علامة التثنية ( وجمع ) لتركبه من المفرد وعلامة الجمع . ( و ) النوع الثاني ( جملة ، وتنقسم ) الجملة ( إلى ما ) أي إلى لفظ ( وضع لإفادة نسبة . وهو ) أي واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو ( الكلام ) لا غيره ( ولا يتألف ) الكلام ( إلا من اسمين ) نحو زيد قائم ( أو ) من ( اسم وفعل ) نحو قام زيد ; لأن الكلام يتضمن الإسناد ، وهو يقتضي مسندا ومسندا إليه . ولما كان الاسم يصح أن يسند وأن يسند إليه صح تأليف الكلام من جنس الاسم فقط . ولما كان الفعل يصلح أن يسند ، ولا يصلح أن يسند إليه : صح تأليف الكلام منه ، إذا كان مع اسم لا بدونه ، بشرط أن يكون المسند والمسند إليه ( من ) متكلم ( واحد ) قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم .
وقال جمع : يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر ، بأن يتفقا على أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل ، أو أحدهما المبتدأ ، والآخر الخبر ، ورد بأن الكلام لا بد له من إسناد ، وهو [ ص: 36 ] لا يكون إلا من واحد . فإن وجد من كل واحد منهما إسناد بالإرادة ، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب ، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه . فلم يوجد كلام من متكلمين ، بل كلامان من اثنين . انتهى . قال في شرح التحرير : وهو التحقيق ، ثم قال : وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك . وهو ما إذا قال رجل : امرأة فلان طالق . فقال الزوج : ثلاثا . قال الشيخ تقي الدين : هي تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : صحاح . وفيها وجهان . قال : وهذا أصل في الكلام من اثنين ، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها : هل يكون متمما للأول ، أم لا ؟ انتهى . ( وحيوان ناطق ، وكاتب ، في زيد كاتب ، لم يفد نسبة ) قال في شرح التحرير : هذا جواب عن سؤال مقدر ، تقديره : أن الحد المذكور للجملة غير مطرد ضرورة صدقه على المركب التقييدي ، وعلى نحو " كاتب " في قولك : زيد كاتب ، والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين ، أو من اسم وفعل ، بحيث يكون الثاني قيدا في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد ، مثل حيوان ناطق ، والذي يكتب . فإنه يقوم مقام الأول : الإنسان ، ومقام الثاني : الكاتب ، وإنما قلنا : الحد يصدق عليهما ; لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية ، والثاني : وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله .
والجواب عن السؤال المقدر أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ، لأن المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها ، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك ، انتهى .
ولما تقدم أن الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة ، وإلى غير ما وضع لإفادة نسبة ، وانتهى الكلام على الأول . شرع في الكلام على الثاني ، فقال : ( وإلى غير ) أي غير ما وضع لإفادة نسبة . وذكر مثاله بقوله ( كجملة الشرط ) بدون جزاء ( أو ) جملة ( الجزاء ) بدون شرط ( ونحوهما ) أي ونحو ذلك فيندرج فيه المركبات التقييدية وكاتب في " زيد كاتب " و " غلام زيد " ونحو ذلك ( ويراد بمفرد ) في بعض إطلاقاته ( مقابلها و ) يراد به في بعض ( مقابل مثنى وجمع ، و ) يراد به في بعض ( مقابل مركب ) فيقال : مفرد وجملة ، ومفرد ومثنى ومجموع ، [ ص: 37 ] ومفرد ومركب ، ويكون إطلاقه في الصور الثلاث إطلاقا متعارفا ( و ) يراد ( بكلمة : الكلام ) في الكتاب والسنة ، وكلام العرب .
قال سبحانه وتعالى ( { قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها } ) فسمى ذلك كله كلمة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل } فسمى ذلك كله كلمة ، وهو مجاز مهمل في عرف النحاة ، فقيل : هو من تسمية الشيء باسم بعضه ، وقيل : لما ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض ، حصل له بذلك وحده ، فشابه به الكلمة . فأطلق عليه كلمة ( و ) يراد به ، أي بالكلام ( الكلمة ) عكس ما قبله ، فيقال : تكلم بكلام ، ومرادهم " بكلمة " قال سيبويه في قولهم : من أنت زيد ، معناه : من أنت كلامك زيد ( و ) يراد بالكلام أيضا ( الكلم الذي لم يفد ) ومنه حديث البراء رضي الله تعالى عنه { أمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام } فيشمل الكلمة الواحدة ، والكلم الذي لم يفد ، والحالف أن لا يتكلم يحنث بمطلق اللفظ ( وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ والمعنى جميعا ، كالإنسان ) أي كتناول لفظ الإنسان ( للروح والبدن ) .
قال الشيخ تقي الدين : عند السلف والفقهاء ، والأكثر . وقال كثير من أهل الكلام : مسمى الكلام هو اللفظ ، وأما المعنى : فليس جزأه ، بل مدلوله ، وقاله النحاة : لتعلق صناعتهم باللفظ فقط . وعكس عبد الله بن كلاب وأتباعه ذلك ، فقالوا : مسمى الكلام المعنى فقط ، وقال بعض أصحاب ابن كلاب : الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى ، فيسمى اللفظ كلاما حقيقة ، ويسمى المعنى كلاما حقيقة ، وروي عن الأشعري وبعض الكلابية : أن الكلام حقيقة في لفظ الآدميين ، لأن حروف الآدميين تقوم بهم ، مجاز في كلام الله سبحانه وتعالى ، لأن الكلام العربي عندهم لا يقوم به تعالى .
وقال الشيخ تقي الدين : اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله تعالى ، فإن كان كلامه هو المعنى فقط . والنظم العربي الذي يدل على المعنى ليس كلام الله [ ص: 38 ] تعالى كان مخلوقا ، خلقه الله تعالى في غيره ، فيكون كلاما لذلك الغير ، لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل ، فيكون الكلام العربي ليس كلام الله تعالى ، بل كلام غيره . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى ، لا كلام غيره . انتهى .
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية

شرح الكوكب المنير
الفتوحي - تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
 صفحة
33
صفحة
33
 جزء
1
جزء
1
( وَهِيَ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=20916_20896اللُّغَةُ نَوْعَانِ ( مُفْرَدٌ ، كَزَيْدٍ ، وَمُرَكَّبٌ ، كَعَبْدِ اللَّهِ ) أَمَّا الْمُفْرَدُ فَلَا نِزَاعَ فِي وَضْعِ الْعَرَبِ لَهُ ، وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ ، فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ مِنْ اللُّغَةِ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَأَنَّ الْمُرَكَّبَ مُرَادِفٌ لِلْمُؤَلَّفِ ، لِتَرَادُفِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُفْرَدَ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ : هُوَ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ ، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ ، وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ : لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ، وَلَا جُزْءَ لِذَلِكَ اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ . فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ . الْأَوَّلُ : مَا لَا جُزْءَ لَهُ أَلْبَتَّةَ ، كَبَاءِ الْجَرِّ . [ ص: 33 ] الثَّانِي : مَا لَهُ جُزْءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ مُطْلَقًا ، كَالزَّايِ مِنْ زَيْدٍ . الثَّالِثُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ ، لَكِنْ لَا عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى . كَإِنْ مِنْ حُرُوفِ إنْسَانٍ . فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِانْفِرَادِهَا تَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ النَّفْيِ . الرَّابِعُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى ، لَكِنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَضْعِ كَقَوْلِنَا : حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، عَلَمًا عَلَى شَخْصٍ .
وَاعْلَمْ أَيْضًا : أَنَّ الْمُرَكَّبَ عِنْدَ النُّحَاةِ : مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَةٍ ، فَشَمِلَ التَّرْكِيبَ الْمَزْجِيَّ ، كَبَعْلَبَكّ ، وَسِيبَوَيْهِ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَنَحْوِهَا ، وَالْمُضَافَ ، وَلَوْ عَلَمًا ، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ . وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ : مَا دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، فَشَمِلَ الْإِسْنَادِيَّ ، كَقَامَ زَيْدٌ ، وَالْإِضَافِيَّ : كَغُلَامِ زَيْدٍ ، وَالتَّقْيِيدِيَّ ، كَزَيْدٍ الْعَالِمِ . وَأَمَّا نَحْوُ " يَضْرِبُ " فَمُفْرَدٌ عَلَى مَذْهَبِ النُّحَاةِ ، وَمُرَكَّبٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ ; لِأَنَّ الْيَاءَ مِنْهُ تَدُلُّ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ ، وَهُوَ الْمُضَارَعَةُ .
( وَالْمُفْرَدُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) كَأَسْمَاءِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ ; لِأَنَّ مَدْلُولَاتِهَا هِيَ عَيْنُهَا . فَإِنَّ مَدْلُولَ الْأَلِفِ : " أَ " وَمَدْلُولَ الْبَاءِ " بَ " . وَهَكَذَا إلَى آخِرِهَا . وَهَذِهِ الْمَدْلُولَاتُ لَمْ تُوضَعْ بِإِزَاءِ شَيْءٍ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّادَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا الْحَرْفِ ، وَهُوَ مُهْمَلٌ ، لَا مَعْنَى لَهُ ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ الصِّغَارُ فِي الِابْتِدَاءِ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ ( وَ ) قِسْمٌ ( مُسْتَعْمَلٌ ) .
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَ ) الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ ( إنْ اسْتَقَلَّ بِمَعْنَاهُ . فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ ) مِنْ الْأَزْمِنَةِ ( الثَّلَاثَةِ ) وَهِيَ الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالِاسْتِقْبَالُ ( فَ ) هُوَ ( الْفِعْلُ ) ( هُوَ ) أَيْ الْفِعْلُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ . أَحَدُهَا ( مَاضٍ ) كَقَامَ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ ) نَحْوَ إنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْت . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْمَاضِي . وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( مُضَارِعٌ ) كَيَقُومُ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الْمُضِيُّ بِلَمْ ) نَحْوَ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ .
وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ ، nindex.php?page=treesubj&link=20829وَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ الْمُضَارِعُ مَذَاهِبُ خَمْسَةٌ . الْمَشْهُورُ مِنْهَا : أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ . قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : إلَّا أَنَّ الْحَالَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ . الثَّانِي : أَنَّهُ [ ص: 34 ] حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ، مَجَازٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ ، مَجَازٌ فِي الْحَالِ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَصْلًا ، لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا . الْخَامِسُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَالِ أَصْلًا ، لَا حَقِيقَةً . وَلَا مَجَازًا . وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ ، فَمَجَازٌ وِفَاقًا ( وَأَمْرٌ ) أَيْ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَفْعَالِ : فِعْلُ الْأَمْرِ كَقُمْ .
( وَتَجَرُّدُهُ ) أَيْ تَجَرُّدُ الْفِعْلِ ( عَنْ الزَّمَانِ ) أَيْ عَنْ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ ( لِلْإِنْشَاءِ ) كَزَوَّجْتُ وَقَبِلْت ( عَارِضٌ ) بِوَضْعِ الْعُرْفِ ( وَقَدْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ يَلْزَمُ الْفِعْلَ التَّجَرُّدُ عَنْ الزَّمَانِ ( كَعَسَى ) فَإِنَّهُ وُضِعَ أَوَّلًا لِلْمَاضِي ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ قَطُّ ، بَلْ فِي الْإِنْشَاءِ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : وَكَذَا " حَبَّذَا " فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لَهَا فِي الْأَزْمِنَةِ ( وَقَدْ ) يَتَجَرَّدُ الْفِعْلُ عَنْ الزَّمَانِ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ ( كَنِعْمَ ) وَبِئْسَ ، فَإِنَّهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلَانِ عَلَى أَصْلِهِمَا ، كَنِعْمَ زَيْدٌ أَمْسِ ، وَبِئْسَ زَيْدٌ أَمْسِ . وَتَارَةً يُسْتَعْمَلَانِ لَا بِنَظَرٍ إلَى زَمَانٍ ، بَلْ لِقَصْدِ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ مُطْلَقًا كَنِعْمَ زَيْدٌ ، وَبِئْسَ زَيْدٌ . ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ ( فَ ) هُوَ ( الِاسْمُ ) فَصَبُوحٌ ، وَغَبُوقٌ . وَأَمْسُ ، وَغَدٌ : وَضَارِبُ أَمْسِ ، وَضَارِبُ الْيَوْمِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ : يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الزَّمَانِ ، لَكِنْ لَمْ يَدُلَّ وَضْعًا ، بَلْ لِعَارِضٍ .
كَاللَّفْظِ بِالِاسْمِ وَمَدْلُولِهِ . فَإِنَّهُ لَازِمٌ كَالْمَكَانِ ، وَنَحْوُ : صَهٍ ، دَلَّ عَلَى " اُسْكُتْ " وَبِوَاسِطَتِهِ عَلَى سُكُوتٍ مُقْتَرِنٍ بِالِاسْتِقْبَالِ ، وَالْمُضَارِعُ إنْ قِيلَ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فَوَضْعُهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَاللُّبْسُ عِنْدَ السَّامِعِ . ( وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ ) اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ بِمَعْنَاهُ ، كَعَنْ وَلَنْ ( فَ ) هُوَ ( الْحَرْفُ ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَدُّ ( وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ ) لِيَخْرُجَ الِاسْمُ وَالْفِعْلُ . وَقِيلَ : لَا يَحْتَاجُ إلَى حَدٍّ ، لِأَنَّ تَرْكَ الْعَلَامَةِ لَهُ عَلَامَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدَّ لِتَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ ، وَلَا تُعْرَفُ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا .
( وَ ) أَمَّا ( الْمُرَكَّبُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْضًا : فَقِسْمَانِ ، قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) وَهُوَ ( مَوْجُودٌ ) فِي اخْتِيَارِ nindex.php?page=showalam&ids=13926الْبَيْضَاوِيِّ وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ . وَمَثَّلَاهُ بِالْهَذَيَانِ . فَإِنَّهُ لَفْظٌ مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ . وَقَالَ الرَّازِيّ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ [ ص: 35 ] مِنْ التَّرْكِيبِ الْإِفَادَةُ . وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ ( لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ ) قَطْعًا . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي ( مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ ) الْعَرَبُ خِلَافًا لِلرَّازِيِّ ، وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ : أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا ، وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً ، كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ . وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا فِي التَّرْكِيبِ . كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لَا يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الْإِسْنَادِ ، بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً [ وَ ] لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لَافْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ . كَالْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ : إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ .
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ ؟ وَأَنَّ الْعَلَاقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ الْعَرَبُ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا ( غَيْرُ جُمْلَةٍ ، كَمُثَنَّى ) لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ ( وَجَمْعٍ ) لِتَرَكُّبِهِ مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلَامَةِ الْجَمْعِ . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( جُمْلَةٌ ، وَتَنْقَسِمُ ) الْجُمْلَةُ ( إلَى مَا ) أَيْ إلَى لَفْظٍ ( وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَهُوَ ) أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِي وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ هُوَ ( الْكَلَامُ ) لَا غَيْرُهُ ( وَلَا يَتَأَلَّفُ ) الْكَلَامُ ( إلَّا مِنْ اسْمَيْنِ ) نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ( أَوْ ) مِنْ ( اسْمٍ وَفِعْلٍ ) نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَضَمَّنُ الْإِسْنَادَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ الِاسْمُ يَصِحُّ أَنْ يُسْنَدَ وَأَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ مِنْ جِنْسِ الِاسْمِ فَقَطْ . وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ : صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ مِنْهُ ، إذَا كَانَ مَعَ اسْمٍ لَا بِدُونِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إلَيْهِ ( مِنْ ) مُتَكَلِّمٍ ( وَاحِدٍ ) قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ جَمْعٌ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ فَأَكْثَرَ ، بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا الْفِعْلَ وَالْآخَرُ الْفَاعِلَ ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْمُبْتَدَأَ ، وَالْآخَرُ الْخَبَرَ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إسْنَادٍ ، وَهُوَ [ ص: 36 ] لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ وَاحِدٍ . فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْنَادٌ بِالْإِرَادَةِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ مُرَكَّبٍ ، وَلَكِنْ حُذِفَ بَعْضُهُ لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ . فَلَمْ يُوجَدْ كَلَامٌ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ ، بَلْ كَلَامَانِ مِنْ اثْنَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ التَّحْقِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فَرْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى ذَلِكَ . وَهُوَ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ . فَقَالَ الزَّوْجُ : ثَلَاثًا . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِيَ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ : لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ ، فَقَالَ : صِحَاحٌ . وَفِيهَا وَجْهَانِ . قَالَ : وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْكَلَامِ مِنْ اثْنَيْنِ ، إنْ أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا : هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلْأَوَّلِ ، أَمْ لَا ؟ انْتَهَى . ( وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، وَكَاتِبٌ ، فِي زَيْدٌ كَاتِبٌ ، لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ، تَقْدِيرُهُ : أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ ، وَعَلَى نَحْوِ " كَاتِبٌ " فِي قَوْلِك : زَيْدٌ كَاتِبٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ : الْمُرَكَّبُ مِنْ اسْمَيْنِ ، أَوْ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ ، مِثْلُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، وَاَلَّذِي يَكْتُبُ . فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ : الْإِنْسَانُ ، وَمَقَامَ الثَّانِي : الْكَاتِبُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : الْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَفْظٌ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ ، وَالثَّانِي : وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ .
وَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ : إفَادَةُ نِسْبَةٍ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20881الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، وَإِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، وَانْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الْأَوَّلِ . شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الثَّانِي ، فَقَالَ : ( وَإِلَى غَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَذَكَرَ مِثَالَهُ بِقَوْلِهِ ( كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ ) بِدُونِ جَزَاءٍ ( أَوْ ) جُمْلَةِ ( الْجَزَاءِ ) بِدُونِ شَرْطٍ ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْمُرَكَّبَاتُ التَّقْيِيدِيَّةُ وَكَاتِبٌ فِي " زَيْدٌ كَاتِبٌ " وَ " غُلَامُ زَيْدٍ " وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ ) فِي بَعْضِ إطْلَاقَاتِهِ ( مُقَابِلُهَا وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُثَنَّى وَجَمْعٍ ، وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُرَكَّبٍ ) فَيُقَالُ : مُفْرَدٌ وَجُمْلَةٌ ، وَمُفْرَدٌ وَمُثَنَّى وَمَجْمُوعٌ ، [ ص: 37 ] وَمُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ ، وَيَكُونُ إطْلَاقُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إطْلَاقًا مُتَعَارَفًا ( وَ ) يُرَادُ ( بِكَلِمَةٍ : الْكَلَامُ ) فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكَلَامِ الْعَرَبِ .
قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=99قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْت كَلًّا إنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا } ) فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=52688أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ : كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ } فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً ، وَهُوَ مَجَازٌ مُهْمَلٌ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ ، فَقِيلَ : هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ ، وَقِيلَ : لَمَّا ارْتَبَطَتْ أَجْزَاءُ الْكَلَامِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ ، فَشَابَهَ بِهِ الْكَلِمَةَ . فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةً ( وَ ) يُرَادُ بِهِ ، أَيْ بِالْكَلَامِ ( الْكَلِمَةُ ) عَكْسُ مَا قَبْلَهُ ، فَيُقَالُ : تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ ، وَمُرَادُهُمْ " بِكَلِمَةٍ " قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ : مَنْ أَنْتَ زَيْدٌ ، مَعْنَاهُ : مَنْ أَنْتَ كَلَامُك زَيْدٌ ( وَ ) يُرَادُ بِالْكَلَامِ أَيْضًا ( الْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ { أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ } فَيَشْمَلُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ ، وَالْكَلِمَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ ، وَالْحَالِفُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ يَحْنَثُ بِمُطْلَقِ اللَّفْظِ ( وَتَنَاوُلُ الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا ، كَالْإِنْسَانِ ) أَيْ كَتَنَاوُلِ لَفْظِ الْإِنْسَانِ ( لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ ) .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عِنْدَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ ، وَالْأَكْثَرِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ : مُسَمَّى الْكَلَامِ هُوَ اللَّفْظُ ، وَأَمَّا الْمَعْنَى : فَلَيْسَ جُزْأَهُ ، بَلْ مَدْلُولَهُ ، وَقَالَهُ النُّحَاةُ : لِتَعَلُّقِ صِنَاعَتِهِمْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ . وَعَكَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِلَابٍ وَأَتْبَاعُهُ ذَلِكَ ، فَقَالُوا : مُسَمَّى الْكَلَامِ الْمَعْنَى فَقَطْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ كِلَابٍ : الْكَلَامُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى ، فَيُسَمَّى اللَّفْظُ كَلَامًا حَقِيقَةً ، وَيُسَمَّى الْمَعْنَى كَلَامًا حَقِيقَةً ، وَرُوِيَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ وَبَعْضِ الْكِلَابِيَّةِ : أَنَّ الْكَلَامَ حَقِيقَةٌ فِي لَفْظِ الْآدَمِيِّينَ ، لِأَنَّ حُرُوفَ الْآدَمِيِّينَ تَقُومُ بِهِمْ ، مَجَازٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، لِأَنَّ الْكَلَامَ الْعَرَبِيَّ عِنْدَهُمْ لَا يَقُومُ بِهِ تَعَالَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : nindex.php?page=treesubj&link=28425_28424_20758اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ هُوَ الْمَعْنَى فَقَطْ . وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ [ ص: 38 ] تَعَالَى كَانَ مَخْلُوقًا ، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ كَلَامًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ إذَا خُلِقَ فِي مَحَلٍّ كَانَ كَلَامًا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ الْعَرَبِيُّ لَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ كَلَامُ غَيْرِهِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ : أَنَّ الْكَلَامَ الْعَرَبِيَّ الَّذِي بَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا كَلَامُ غَيْرِهِ . انْتَهَى .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُفْرَدَ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ : هُوَ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ ، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ ، وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ : لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ، وَلَا جُزْءَ لِذَلِكَ اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ . فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ . الْأَوَّلُ : مَا لَا جُزْءَ لَهُ أَلْبَتَّةَ ، كَبَاءِ الْجَرِّ . [ ص: 33 ] الثَّانِي : مَا لَهُ جُزْءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ مُطْلَقًا ، كَالزَّايِ مِنْ زَيْدٍ . الثَّالِثُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ ، لَكِنْ لَا عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى . كَإِنْ مِنْ حُرُوفِ إنْسَانٍ . فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِانْفِرَادِهَا تَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ النَّفْيِ . الرَّابِعُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى ، لَكِنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَضْعِ كَقَوْلِنَا : حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، عَلَمًا عَلَى شَخْصٍ .
وَاعْلَمْ أَيْضًا : أَنَّ الْمُرَكَّبَ عِنْدَ النُّحَاةِ : مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَةٍ ، فَشَمِلَ التَّرْكِيبَ الْمَزْجِيَّ ، كَبَعْلَبَكّ ، وَسِيبَوَيْهِ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَنَحْوِهَا ، وَالْمُضَافَ ، وَلَوْ عَلَمًا ، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ . وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ : مَا دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، فَشَمِلَ الْإِسْنَادِيَّ ، كَقَامَ زَيْدٌ ، وَالْإِضَافِيَّ : كَغُلَامِ زَيْدٍ ، وَالتَّقْيِيدِيَّ ، كَزَيْدٍ الْعَالِمِ . وَأَمَّا نَحْوُ " يَضْرِبُ " فَمُفْرَدٌ عَلَى مَذْهَبِ النُّحَاةِ ، وَمُرَكَّبٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ ; لِأَنَّ الْيَاءَ مِنْهُ تَدُلُّ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ ، وَهُوَ الْمُضَارَعَةُ .
( وَالْمُفْرَدُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) كَأَسْمَاءِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ ; لِأَنَّ مَدْلُولَاتِهَا هِيَ عَيْنُهَا . فَإِنَّ مَدْلُولَ الْأَلِفِ : " أَ " وَمَدْلُولَ الْبَاءِ " بَ " . وَهَكَذَا إلَى آخِرِهَا . وَهَذِهِ الْمَدْلُولَاتُ لَمْ تُوضَعْ بِإِزَاءِ شَيْءٍ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّادَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا الْحَرْفِ ، وَهُوَ مُهْمَلٌ ، لَا مَعْنَى لَهُ ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ الصِّغَارُ فِي الِابْتِدَاءِ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ ( وَ ) قِسْمٌ ( مُسْتَعْمَلٌ ) .
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَ ) الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ ( إنْ اسْتَقَلَّ بِمَعْنَاهُ . فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ ) مِنْ الْأَزْمِنَةِ ( الثَّلَاثَةِ ) وَهِيَ الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالِاسْتِقْبَالُ ( فَ ) هُوَ ( الْفِعْلُ ) ( هُوَ ) أَيْ الْفِعْلُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ . أَحَدُهَا ( مَاضٍ ) كَقَامَ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ ) نَحْوَ إنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْت . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْمَاضِي . وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( مُضَارِعٌ ) كَيَقُومُ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الْمُضِيُّ بِلَمْ ) نَحْوَ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ .
وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ ، nindex.php?page=treesubj&link=20829وَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ الْمُضَارِعُ مَذَاهِبُ خَمْسَةٌ . الْمَشْهُورُ مِنْهَا : أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ . قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : إلَّا أَنَّ الْحَالَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ . الثَّانِي : أَنَّهُ [ ص: 34 ] حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ، مَجَازٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ ، مَجَازٌ فِي الْحَالِ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَصْلًا ، لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا . الْخَامِسُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَالِ أَصْلًا ، لَا حَقِيقَةً . وَلَا مَجَازًا . وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ ، فَمَجَازٌ وِفَاقًا ( وَأَمْرٌ ) أَيْ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَفْعَالِ : فِعْلُ الْأَمْرِ كَقُمْ .
( وَتَجَرُّدُهُ ) أَيْ تَجَرُّدُ الْفِعْلِ ( عَنْ الزَّمَانِ ) أَيْ عَنْ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ ( لِلْإِنْشَاءِ ) كَزَوَّجْتُ وَقَبِلْت ( عَارِضٌ ) بِوَضْعِ الْعُرْفِ ( وَقَدْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ يَلْزَمُ الْفِعْلَ التَّجَرُّدُ عَنْ الزَّمَانِ ( كَعَسَى ) فَإِنَّهُ وُضِعَ أَوَّلًا لِلْمَاضِي ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ قَطُّ ، بَلْ فِي الْإِنْشَاءِ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : وَكَذَا " حَبَّذَا " فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لَهَا فِي الْأَزْمِنَةِ ( وَقَدْ ) يَتَجَرَّدُ الْفِعْلُ عَنْ الزَّمَانِ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ ( كَنِعْمَ ) وَبِئْسَ ، فَإِنَّهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلَانِ عَلَى أَصْلِهِمَا ، كَنِعْمَ زَيْدٌ أَمْسِ ، وَبِئْسَ زَيْدٌ أَمْسِ . وَتَارَةً يُسْتَعْمَلَانِ لَا بِنَظَرٍ إلَى زَمَانٍ ، بَلْ لِقَصْدِ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ مُطْلَقًا كَنِعْمَ زَيْدٌ ، وَبِئْسَ زَيْدٌ . ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ ( فَ ) هُوَ ( الِاسْمُ ) فَصَبُوحٌ ، وَغَبُوقٌ . وَأَمْسُ ، وَغَدٌ : وَضَارِبُ أَمْسِ ، وَضَارِبُ الْيَوْمِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ : يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الزَّمَانِ ، لَكِنْ لَمْ يَدُلَّ وَضْعًا ، بَلْ لِعَارِضٍ .
كَاللَّفْظِ بِالِاسْمِ وَمَدْلُولِهِ . فَإِنَّهُ لَازِمٌ كَالْمَكَانِ ، وَنَحْوُ : صَهٍ ، دَلَّ عَلَى " اُسْكُتْ " وَبِوَاسِطَتِهِ عَلَى سُكُوتٍ مُقْتَرِنٍ بِالِاسْتِقْبَالِ ، وَالْمُضَارِعُ إنْ قِيلَ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فَوَضْعُهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَاللُّبْسُ عِنْدَ السَّامِعِ . ( وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ ) اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ بِمَعْنَاهُ ، كَعَنْ وَلَنْ ( فَ ) هُوَ ( الْحَرْفُ ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَدُّ ( وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ ) لِيَخْرُجَ الِاسْمُ وَالْفِعْلُ . وَقِيلَ : لَا يَحْتَاجُ إلَى حَدٍّ ، لِأَنَّ تَرْكَ الْعَلَامَةِ لَهُ عَلَامَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدَّ لِتَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ ، وَلَا تُعْرَفُ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا .
( وَ ) أَمَّا ( الْمُرَكَّبُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْضًا : فَقِسْمَانِ ، قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) وَهُوَ ( مَوْجُودٌ ) فِي اخْتِيَارِ nindex.php?page=showalam&ids=13926الْبَيْضَاوِيِّ وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ . وَمَثَّلَاهُ بِالْهَذَيَانِ . فَإِنَّهُ لَفْظٌ مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ . وَقَالَ الرَّازِيّ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، لِأَنَّ الْغَرَضَ [ ص: 35 ] مِنْ التَّرْكِيبِ الْإِفَادَةُ . وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ ( لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ ) قَطْعًا . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي ( مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ ) الْعَرَبُ خِلَافًا لِلرَّازِيِّ ، وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ : أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا ، وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً ، كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ . وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا فِي التَّرْكِيبِ . كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لَا يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الْإِسْنَادِ ، بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً [ وَ ] لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لَافْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ . كَالْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ : إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ .
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ ؟ وَأَنَّ الْعَلَاقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ الْعَرَبُ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا ( غَيْرُ جُمْلَةٍ ، كَمُثَنَّى ) لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ ( وَجَمْعٍ ) لِتَرَكُّبِهِ مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلَامَةِ الْجَمْعِ . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( جُمْلَةٌ ، وَتَنْقَسِمُ ) الْجُمْلَةُ ( إلَى مَا ) أَيْ إلَى لَفْظٍ ( وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَهُوَ ) أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِي وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ هُوَ ( الْكَلَامُ ) لَا غَيْرُهُ ( وَلَا يَتَأَلَّفُ ) الْكَلَامُ ( إلَّا مِنْ اسْمَيْنِ ) نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ( أَوْ ) مِنْ ( اسْمٍ وَفِعْلٍ ) نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَضَمَّنُ الْإِسْنَادَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ الِاسْمُ يَصِحُّ أَنْ يُسْنَدَ وَأَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ مِنْ جِنْسِ الِاسْمِ فَقَطْ . وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ : صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلَامِ مِنْهُ ، إذَا كَانَ مَعَ اسْمٍ لَا بِدُونِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إلَيْهِ ( مِنْ ) مُتَكَلِّمٍ ( وَاحِدٍ ) قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ جَمْعٌ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ فَأَكْثَرَ ، بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا الْفِعْلَ وَالْآخَرُ الْفَاعِلَ ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْمُبْتَدَأَ ، وَالْآخَرُ الْخَبَرَ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إسْنَادٍ ، وَهُوَ [ ص: 36 ] لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ وَاحِدٍ . فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْنَادٌ بِالْإِرَادَةِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ مُرَكَّبٍ ، وَلَكِنْ حُذِفَ بَعْضُهُ لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ . فَلَمْ يُوجَدْ كَلَامٌ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ ، بَلْ كَلَامَانِ مِنْ اثْنَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ التَّحْقِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فَرْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى ذَلِكَ . وَهُوَ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ . فَقَالَ الزَّوْجُ : ثَلَاثًا . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِيَ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ : لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ ، فَقَالَ : صِحَاحٌ . وَفِيهَا وَجْهَانِ . قَالَ : وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْكَلَامِ مِنْ اثْنَيْنِ ، إنْ أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا : هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلْأَوَّلِ ، أَمْ لَا ؟ انْتَهَى . ( وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، وَكَاتِبٌ ، فِي زَيْدٌ كَاتِبٌ ، لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ، تَقْدِيرُهُ : أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ ، وَعَلَى نَحْوِ " كَاتِبٌ " فِي قَوْلِك : زَيْدٌ كَاتِبٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ : الْمُرَكَّبُ مِنْ اسْمَيْنِ ، أَوْ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ ، مِثْلُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، وَاَلَّذِي يَكْتُبُ . فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ : الْإِنْسَانُ ، وَمَقَامَ الثَّانِي : الْكَاتِبُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : الْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَفْظٌ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ ، وَالثَّانِي : وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ .
وَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ : إفَادَةُ نِسْبَةٍ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20881الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، وَإِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، وَانْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى الْأَوَّلِ . شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الثَّانِي ، فَقَالَ : ( وَإِلَى غَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَذَكَرَ مِثَالَهُ بِقَوْلِهِ ( كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ ) بِدُونِ جَزَاءٍ ( أَوْ ) جُمْلَةِ ( الْجَزَاءِ ) بِدُونِ شَرْطٍ ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْمُرَكَّبَاتُ التَّقْيِيدِيَّةُ وَكَاتِبٌ فِي " زَيْدٌ كَاتِبٌ " وَ " غُلَامُ زَيْدٍ " وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ ) فِي بَعْضِ إطْلَاقَاتِهِ ( مُقَابِلُهَا وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُثَنَّى وَجَمْعٍ ، وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُرَكَّبٍ ) فَيُقَالُ : مُفْرَدٌ وَجُمْلَةٌ ، وَمُفْرَدٌ وَمُثَنَّى وَمَجْمُوعٌ ، [ ص: 37 ] وَمُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ ، وَيَكُونُ إطْلَاقُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إطْلَاقًا مُتَعَارَفًا ( وَ ) يُرَادُ ( بِكَلِمَةٍ : الْكَلَامُ ) فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكَلَامِ الْعَرَبِ .
قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=99قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْت كَلًّا إنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا } ) فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=52688أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ : كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ } فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً ، وَهُوَ مَجَازٌ مُهْمَلٌ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ ، فَقِيلَ : هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ ، وَقِيلَ : لَمَّا ارْتَبَطَتْ أَجْزَاءُ الْكَلَامِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ ، فَشَابَهَ بِهِ الْكَلِمَةَ . فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةً ( وَ ) يُرَادُ بِهِ ، أَيْ بِالْكَلَامِ ( الْكَلِمَةُ ) عَكْسُ مَا قَبْلَهُ ، فَيُقَالُ : تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ ، وَمُرَادُهُمْ " بِكَلِمَةٍ " قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ : مَنْ أَنْتَ زَيْدٌ ، مَعْنَاهُ : مَنْ أَنْتَ كَلَامُك زَيْدٌ ( وَ ) يُرَادُ بِالْكَلَامِ أَيْضًا ( الْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ { أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ } فَيَشْمَلُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ ، وَالْكَلِمَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ ، وَالْحَالِفُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ يَحْنَثُ بِمُطْلَقِ اللَّفْظِ ( وَتَنَاوُلُ الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا ، كَالْإِنْسَانِ ) أَيْ كَتَنَاوُلِ لَفْظِ الْإِنْسَانِ ( لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ ) .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عِنْدَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ ، وَالْأَكْثَرِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ : مُسَمَّى الْكَلَامِ هُوَ اللَّفْظُ ، وَأَمَّا الْمَعْنَى : فَلَيْسَ جُزْأَهُ ، بَلْ مَدْلُولَهُ ، وَقَالَهُ النُّحَاةُ : لِتَعَلُّقِ صِنَاعَتِهِمْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ . وَعَكَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِلَابٍ وَأَتْبَاعُهُ ذَلِكَ ، فَقَالُوا : مُسَمَّى الْكَلَامِ الْمَعْنَى فَقَطْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ كِلَابٍ : الْكَلَامُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى ، فَيُسَمَّى اللَّفْظُ كَلَامًا حَقِيقَةً ، وَيُسَمَّى الْمَعْنَى كَلَامًا حَقِيقَةً ، وَرُوِيَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ وَبَعْضِ الْكِلَابِيَّةِ : أَنَّ الْكَلَامَ حَقِيقَةٌ فِي لَفْظِ الْآدَمِيِّينَ ، لِأَنَّ حُرُوفَ الْآدَمِيِّينَ تَقُومُ بِهِمْ ، مَجَازٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، لِأَنَّ الْكَلَامَ الْعَرَبِيَّ عِنْدَهُمْ لَا يَقُومُ بِهِ تَعَالَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : nindex.php?page=treesubj&link=28425_28424_20758اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ هُوَ الْمَعْنَى فَقَطْ . وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ [ ص: 38 ] تَعَالَى كَانَ مَخْلُوقًا ، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ كَلَامًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ إذَا خُلِقَ فِي مَحَلٍّ كَانَ كَلَامًا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ الْعَرَبِيُّ لَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ كَلَامُ غَيْرِهِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ : أَنَّ الْكَلَامَ الْعَرَبِيَّ الَّذِي بَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا كَلَامُ غَيْرِهِ . انْتَهَى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام


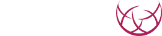








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات