قال : والذي ذكره أصحابنا إنما هو مجاز ، فأجروا الحد مجرى الاسم توسعا ، وقال الرازي : ضروري إذ به تعرف الأشياء فلو عرف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه ، والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم الدور ، ثم قال في موضع آخر : هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط ، فكأنه قال بأنه ضروري ويحد وهذا تناقض .
فإن قيل : الذهني تعريفه تصديقي ، والمدعى معرفته تصوري فلا تناقض . قلنا : إن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصور ; لأن النسبة ليست تصديقا بل مقررة . وقال غيره : ضروري ولا يحد . وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه ، والموجود في المحصول " ما ذكرته أولا ، وقال إمام الحرمين ، والقشيري ، والغزالي : يعسر تعريفه بالحد الحقيقي . وإنما يعرف بالتقسيم والمثال ، ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين أضداده [ ص: 77 ] واعترض عليهم الآمدي بأن القسمة المذكورة إن لم تكن مميزة له عما سواه فليست معرفة ، وإن كانت مميزة فذلك رسم . وهذا إنما يرد لو أحالا الرسم ، وهو غير ظاهر من كلامهم . والمختار : أنه يعرف بالحد الحقيقي كغيره ، فقال القدماء : هو معرفة المعلوم على ما هو به . .
وأورد بأنه تعريف الشيء بنفسه ، وبما لا يعرف إلا بعد معرفته ، وهو باطل ; لأن المعلوم مشتق من العلم ، ورتبة المشتق في المعرفة متأخرة عن رتبة المشتق منه ، وقد أخذ في تعريف العلم فيلزم ما ذكرنا . وأجيب بأنهم تجوزوا في المعلوم ، وقيل : إنه منقوض بعلم الله ، فإنه لا يسمى معرفة إجماعا كما قاله الآمدي ، وبمعرفة المقلد إذ ليست علما ، وبأن فيه زيادة وهو قوله : على ما هو به : إذ المعرفة عندهم هي العلم ، والعلم إنما يكون مطابقا واحدا ، ولهذا قال الإمام : لو اقتصر على قوله : معرفة ، لكفى . وقيل : ذكرت للإشعار بأنها من الصفات المتعلقة ، وللإشارة إلى نفي قول من يقول بوجود علم ولا معلوم ، وهم بعض المعتزلة . واستحسن ابن عقيل قول بعضهم : إنه وجدان النفس الناطقة الأمور بحقائقها ، وهذا تعريف المجهول بمثله ، أو دونه ، فإن العلم أظهر من وجدان النفس أو مثله .
ثم هو غير جامع لخروج علم الله ، وغير مانع لوجدان المقلد ، وليس بعلم [ ص: 78 ] وقال القفال الشاشي : إثبات الشيء على ما هو به ، وقال ابن السمعاني : الأحسن أنه إدراك العلوم على ما هو به . والأولى كما قاله في التلخيص " : إنه معرفة العلوم فيشمل الموجود والمعدوم ، ولا نظر إلى الاشتقاق حتى يلزم الدور . قال : ولو قلت : ما يعلم به العلوم لكان أسد وقد أومأ شيخنا أبو الحسن إلى أنه ما أوجب لمحله الاتصاف بكونه عالما ، وقيل : تبين المعلوم على ما هو به ، وقيل : هو المعرفة . ورد بأنه لا يقال لعلم الله : معرفة . ولا يقال له : عارف ، وحكى الأستاذ أبو إسحاق في كتاب " شرح ترتيب المذهب " إجماع المتكلمين على أن الله تعالى لا يسمى عارفا ، ودفع الاستدلال بحديث : { تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة } بأنه لا يقطع به .
ونقل المقترح في شرح الإرشاد " عن القاضي أنه سمي علم الله معرفة لهذا الحديث ، ثم ضعفه بأن الخطاب لم يسق لبيان العلم ، ولا أطلق لفظ المعرفة هاهنا عليه ، وإنما أراد ثمرة العلم وهو الإقبال في الإلطاف عليه ، ولهذا لا يسمى الباري عارفا . انتهى . وقيل المراد : المجازاة . وخرج عليه قول ابن الفارض :
قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف
.

 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام





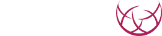








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات