2- القراءة البنائية:
- التأويل البنائي المتكامل أو الوحدة البنائية للقرآن الكريم:
من الدراسات الجادة التي سعت إلى وضع تصور منهجي لقراءة القرآن الكريم وفهمه الفهم السليم الذي يوافق مراد منزله، كتاب "الوحدة البنائية للقرآن المجيد" [1] ، وهو كتاب دعا فيه صاحبه إلى معالجة نصوص القرآن [ ص: 46 ] الكريم من جهة كونه وحدة بنائية بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وكلماته، كالجملة الواحدة أو البناء المحكم الذي يمتنع اختراقه لمتانته وقوته، ولا يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدد فيه أو التجزئة في آياته، ولولا هذه الوحدة البنائية لما استوعب القرآن "خبر ما بعدنا" حيث استوعب مستقبل البشرية. وبمنهج التعامل بهذه الوحدة البنائية لن نستطيع أن نهتم بجانب من جوانب القرآن الكريم كالأحكام الفقهية أو الفوائد البلاغية، ونهمل الجوانب الأخرى؛ لأن معاني الآيات لن تسفر عن وجهها حتى تقرأ في سياقها وموقعها وبيئتها، وتدرك العلاقة بين الآية والقرآن الكريم كله؛ لأن القرآن بناء محكم واحد، ونظم متفرد واحد، تسري فيه كله روح واحدة تحوله إلى كائن حي يخاطبك كفاحا ويشتبك معك في جدل شامل يجيب به عن أسئلتك [2] .
كيف ظهرت بذور القول بالوحدة البنائية للنص القرآني؟
لقد شغل جيل التلقي بالتعلم للعمل والتطبيق، وشغل جيل الرواية بتتبع الروايات وتمحيصها، وشغل جيل الفقه بإنتاج الفقه للاستجابة لمستجدات الحياة، وانتشر مع مناهج الفقهاء النظر الجزئي في الآيات والمسارعة إلى الدليل الجزئي. [ ص: 47 ]
ولكن المفسرين بالرغم من اقتنـاعهم بأن القرآن يفسر بعـضه بعضا لم يؤد انشغالهم بالتفسير إلى الكشف عن الوحدة البنائية للقرآن الكريم، وقد ذم الله عز وجل المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين أي مفرقا، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وقد كان الذم كافيا للدفع إلى اكتشاف منهج للقراءة الواحدة غير المجزئة لاكتشاف الوحدة البنائية.
والحقيقة أن الذين وجدت عندهم بذور القول بالوحدة البنائية هم أهـل البلاغة والبيان وأصحاب نظرية النظم، وعلى رأسهم الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني.
ونظرية الوحدة البنائية لا تقل خطرا عن نظرية النظم، وهما معا حجر الزاوية في المنظومة الداخلية للكتاب المجيد، التي تحفظه وتجمع أجزاءه من الداخل، أما الوسائل الخارجية الحافظة ففي مقدمتها علوم المقاصد، وهي التوحيد والكلام والتفسير والفقه وأصوله وعلوم الحديث. لكن كثيرا من المتكلمة تجادلوا في اليقينيات العقدية فصارت هذه مادة جديدة للجدل، فبدأ علم الكلام يفكك الأمة التي بناها القرآن ليجعل منها فرقا وشيعا، واستعملت الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتأصيل الأحوال الشاذة، وأقاموا علما جديدا سموه علم الملل والنحل، واقتطعوا آيات من القرآن عن سياقها وبتروها من نظمها ووحدتها ونسقها ليتخذوها موضع شاهد، وليحملوها على ما أرادوه.
والحقيقة أنه لا مخرج من هذا التراث المعطوب المفكك إلا بعرضه كاملا على القرآن في وحدته البنائية. [ ص: 48 ]
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- كتاب الأمة

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بو درع
- نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
- بلاغة النص في القرآن مقاربة من زاوية علم لغة النص
- نماذج من القراءات النصية
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
[2] القراءة البنائية
 صفحة
46
صفحة
46
 جزء
1
جزء
1
2- القِراءَة البِنائيّةُ:
- التّأويلُ البِنائيُّ المُتَكامِلُ أو الوَحدَةُ البِنائيّةُ للقُرآنِ الكَريمِ:
مِنَ الدِّراساتِ الجادّةِ التي سَعَتْ إلى وَضعِ تصوُّرٍ مَنْهَجيٍّ لقراءةِ القُرآنِ الكَريمِ وفهمِه الفَهمَ السّليمَ الذي يُوافقُ مُرادَ مُنزِّلِه، كتابُ "الوَحْدَة البِنائيّة للقُرآنِ المَجيد" [1] ، وهو كتابٌ دَعا فيه صاحبُه إلى مُعالَجَة نُصوصِ القُرآن [ ص: 46 ] الكَريم مِن جهةِ كونِه وَحدةً بنائيّةً بكلّ سُوَرِه وآياتِه وأجزائِه وأحزابِه وكَلِماتِه، كالجُملةِ الواحدَةِ أو البِناءِ المُحكَمِ الذي يمتنعُ اخْتراقُه لِمتانتِه وقُوّتِه، ولا يَقبلُ بِناؤُه وإحكامُ آياتِه التّعدُّدَ فيه أو التّجزئةَ في آياتِه، ولَولا هذه الوَحْدَةُ البنائيّةُ لَما استوعَبَ القُرآنُ "خَبَرَ ما بَعْدَنا" حيثُ استوعَبَ مُستقبَلَ البشريّةِ. وبمَنهج التّعامُلِ بهذه الوحدةِ البنائيّةِ لَن نستطيعَ أن نهتمَّ بجانبٍ من جَوانبِ القُرآن الكَريمِ كالأحْكامِ الفِقْهيّةِ أو الفوائدِ البلاغيّةِ، ونُهمِل الجَوانبَ الأخرى؛ لأنّ مَعانيَ الآياتِ لَن تُسفرَ عن وَجهِها حتّى تُقرأَ في سِياقِها ومَوقعِها وبيئتِها، وتُدْرَكَ العَلاقةُ بينَ الآيَةِ والقُرآنِ الكريمِ كلِّه؛ لأنّ القرآنَ بناءٌ مُحكَمٌ واحدٌ، ونَظمٌ مُتفرّدٌ واحدٌ، تَسري فيه كلّه روحٌ واحِدةٌ تحوّلُه إلى كائنٍ حيٍّ يُخاطبُك كِفاحًا ويَشتبكُ مَعك في جَدَلٍ شاملٍ يُجيبُ بِه عن أسئلتِكَ [2] .
كَيْفَ ظَهَرَت بُذورُ القولِ بالوَحدَةِ البِنائيّةِ للنّصّ القُرآنيّ؟
لَقَد شُغِلَ جيلُ التّلقّي بالتّعلّمِ للعَمَلِ والتّطبيقِ، وشُغِلَ جيلُ الرّوايَةِ بِتتبُّعِ الرِّواياتِ وتَمْحيصِها، وشُغِلَ جيلُ الفقهِ بإنتاجِ الفِقْهِ للاستجابَةِ لمُسْتجدّاتِ الحَياةِ، وانْتَشَرَ مع مَناهجِ الفُقَهاءِ النّظَرُ الجُزئيُّ في الآياتِ والمُسارَعَةُ إلى الدّليلِ الجُزئيِّ. [ ص: 47 ]
ولكنّ المُفسّرينِ بالرّغمِ من اقْتنـاعِهِم بأنّ القُرآنَ يُفسّرُ بعـضُه بَعضًا لم يُؤدِّ انشغالُهُم بالتّفسيرِ إلى الكَشْفِ عن الوَحدةِ البنائيّةِ للقُرآن الكَريم، وقَد ذمّ الله عزّ وجلّ المُقْتَسِمينَ الذينَ جَعَلوا القُرآنَ عِضينَ أي مُفرَّقًا، وآمَنوا ببعضِ الكتابِ وكَفَروا ببعضٍ، وقَد كانَ الذّمُّ كافيًا للدّفعِ إلى اكتشافِ مَنْهَجٍ للقِراءَةِ الواحدَة غير المُجَزِّئَةِ لاكْتِشافِ الوَحْدةِ البِنائيّةِ.
والحَقيقَةُ أنّ الذين وُجدَتْ عِندَهُم بُذورُ القَولِ بالوَحْدَةِ البنائيّةِ هُم أهـلُ البَلاغَةِ والبَيانِ وأصحابُ نَظريّةِ النّظمِ، وعَلى رأسِهم الجاحظُ وعبدُ القاهِر الجُرجانيّ.
ونَظريّةُ الوَحدَةِ البِنائيّةِ لا تقلُّ خَطَرًا عَن نظريّةِ النّظمِ، وهُما مَعًا حجَرُ الزّاويةِ في المَنظومةِ الدّاخليّةِ للكتابِ المَجيدِ، التي تَحفَظُه وتَجْمَع أجزاءَه من الدّاخِلِ، أمّا الوَسائلُ الخارجيّةُ الحافظةُ ففي مُقدّمتِها عُلومُ المَقاصدِ، وهي التّوحيدُ والكَلامُ والتّفسيرُ والفقْهُ وأصولُه وعُلومُ الحَديثِ. لكنّ كثيرًا من المُتكلِّمَةِ تَجادَلوا في اليقينيّاتِ العَقَديّةِ فصارَت هذه مادّةً جَديدةً للجَدَلِ، فبدأ علمُ الكَلامِ يُفكِّكُ الأمّةَ التي بَناها القُرآنُ ليجعَلَ منها فِرَقًا وشِيَعًا، واستُعمِلَت الأحاديثُ الضَّعيفةُ والمَوضوعَةِ لتأصيلِ الأحوالِ الشّاذّةِ، وأقاموا علمًا جَديدًا سَمّوْه علمَ المِلَلِ والنِّحَل، واقْتَطَعوا آياتٍ من القُرآنِ عَن سِياقِها وبَتَروها مِن نَظمِها ووَحْدتِها ونَسَقِها ليتّخذوها مَوضِعَ شاهِدٍ، وليَحْملوها عَلى ما أرادوه.
والحّقيقةُ أنّه لا مَخْرجَ من هذا التُّراثِ المَعْطوبِ المُفَكَّكِ إلاّ بعَرْضِه كاملًا على القُرآن في وَحدتِه البِنائيّةِ. [ ص: 48 ]
- التّأويلُ البِنائيُّ المُتَكامِلُ أو الوَحدَةُ البِنائيّةُ للقُرآنِ الكَريمِ:
مِنَ الدِّراساتِ الجادّةِ التي سَعَتْ إلى وَضعِ تصوُّرٍ مَنْهَجيٍّ لقراءةِ القُرآنِ الكَريمِ وفهمِه الفَهمَ السّليمَ الذي يُوافقُ مُرادَ مُنزِّلِه، كتابُ "الوَحْدَة البِنائيّة للقُرآنِ المَجيد" [1] ، وهو كتابٌ دَعا فيه صاحبُه إلى مُعالَجَة نُصوصِ القُرآن [ ص: 46 ] الكَريم مِن جهةِ كونِه وَحدةً بنائيّةً بكلّ سُوَرِه وآياتِه وأجزائِه وأحزابِه وكَلِماتِه، كالجُملةِ الواحدَةِ أو البِناءِ المُحكَمِ الذي يمتنعُ اخْتراقُه لِمتانتِه وقُوّتِه، ولا يَقبلُ بِناؤُه وإحكامُ آياتِه التّعدُّدَ فيه أو التّجزئةَ في آياتِه، ولَولا هذه الوَحْدَةُ البنائيّةُ لَما استوعَبَ القُرآنُ "خَبَرَ ما بَعْدَنا" حيثُ استوعَبَ مُستقبَلَ البشريّةِ. وبمَنهج التّعامُلِ بهذه الوحدةِ البنائيّةِ لَن نستطيعَ أن نهتمَّ بجانبٍ من جَوانبِ القُرآن الكَريمِ كالأحْكامِ الفِقْهيّةِ أو الفوائدِ البلاغيّةِ، ونُهمِل الجَوانبَ الأخرى؛ لأنّ مَعانيَ الآياتِ لَن تُسفرَ عن وَجهِها حتّى تُقرأَ في سِياقِها ومَوقعِها وبيئتِها، وتُدْرَكَ العَلاقةُ بينَ الآيَةِ والقُرآنِ الكريمِ كلِّه؛ لأنّ القرآنَ بناءٌ مُحكَمٌ واحدٌ، ونَظمٌ مُتفرّدٌ واحدٌ، تَسري فيه كلّه روحٌ واحِدةٌ تحوّلُه إلى كائنٍ حيٍّ يُخاطبُك كِفاحًا ويَشتبكُ مَعك في جَدَلٍ شاملٍ يُجيبُ بِه عن أسئلتِكَ [2] .
كَيْفَ ظَهَرَت بُذورُ القولِ بالوَحدَةِ البِنائيّةِ للنّصّ القُرآنيّ؟
لَقَد شُغِلَ جيلُ التّلقّي بالتّعلّمِ للعَمَلِ والتّطبيقِ، وشُغِلَ جيلُ الرّوايَةِ بِتتبُّعِ الرِّواياتِ وتَمْحيصِها، وشُغِلَ جيلُ الفقهِ بإنتاجِ الفِقْهِ للاستجابَةِ لمُسْتجدّاتِ الحَياةِ، وانْتَشَرَ مع مَناهجِ الفُقَهاءِ النّظَرُ الجُزئيُّ في الآياتِ والمُسارَعَةُ إلى الدّليلِ الجُزئيِّ. [ ص: 47 ]
ولكنّ المُفسّرينِ بالرّغمِ من اقْتنـاعِهِم بأنّ القُرآنَ يُفسّرُ بعـضُه بَعضًا لم يُؤدِّ انشغالُهُم بالتّفسيرِ إلى الكَشْفِ عن الوَحدةِ البنائيّةِ للقُرآن الكَريم، وقَد ذمّ الله عزّ وجلّ المُقْتَسِمينَ الذينَ جَعَلوا القُرآنَ عِضينَ أي مُفرَّقًا، وآمَنوا ببعضِ الكتابِ وكَفَروا ببعضٍ، وقَد كانَ الذّمُّ كافيًا للدّفعِ إلى اكتشافِ مَنْهَجٍ للقِراءَةِ الواحدَة غير المُجَزِّئَةِ لاكْتِشافِ الوَحْدةِ البِنائيّةِ.
والحَقيقَةُ أنّ الذين وُجدَتْ عِندَهُم بُذورُ القَولِ بالوَحْدَةِ البنائيّةِ هُم أهـلُ البَلاغَةِ والبَيانِ وأصحابُ نَظريّةِ النّظمِ، وعَلى رأسِهم الجاحظُ وعبدُ القاهِر الجُرجانيّ.
ونَظريّةُ الوَحدَةِ البِنائيّةِ لا تقلُّ خَطَرًا عَن نظريّةِ النّظمِ، وهُما مَعًا حجَرُ الزّاويةِ في المَنظومةِ الدّاخليّةِ للكتابِ المَجيدِ، التي تَحفَظُه وتَجْمَع أجزاءَه من الدّاخِلِ، أمّا الوَسائلُ الخارجيّةُ الحافظةُ ففي مُقدّمتِها عُلومُ المَقاصدِ، وهي التّوحيدُ والكَلامُ والتّفسيرُ والفقْهُ وأصولُه وعُلومُ الحَديثِ. لكنّ كثيرًا من المُتكلِّمَةِ تَجادَلوا في اليقينيّاتِ العَقَديّةِ فصارَت هذه مادّةً جَديدةً للجَدَلِ، فبدأ علمُ الكَلامِ يُفكِّكُ الأمّةَ التي بَناها القُرآنُ ليجعَلَ منها فِرَقًا وشِيَعًا، واستُعمِلَت الأحاديثُ الضَّعيفةُ والمَوضوعَةِ لتأصيلِ الأحوالِ الشّاذّةِ، وأقاموا علمًا جَديدًا سَمّوْه علمَ المِلَلِ والنِّحَل، واقْتَطَعوا آياتٍ من القُرآنِ عَن سِياقِها وبَتَروها مِن نَظمِها ووَحْدتِها ونَسَقِها ليتّخذوها مَوضِعَ شاهِدٍ، وليَحْملوها عَلى ما أرادوه.
والحّقيقةُ أنّه لا مَخْرجَ من هذا التُّراثِ المَعْطوبِ المُفَكَّكِ إلاّ بعَرْضِه كاملًا على القُرآن في وَحدتِه البِنائيّةِ. [ ص: 48 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام

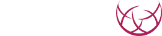








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات