- نماذج من القراءات النصية:
1- القراءة التناسبية:
التناسب قانون كوني كلي، دل عليه قوله تعالى: ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) (الملك:1-4).
والقراءة التناسبية دراسة تتناول أوجه التناسب المعنوي واللفظي والصوتي في البيان القرآني، بطريقة تجمع بين النظرية والتطبيق [1] ، ومفتاح دراسة التناسب في النص القرآني قوله تعالى: ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم [ ص: 42 ] إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ) (الزمر:23)، فالتشـابه في الآية يشير إلى ذكر الشيء مع نظيره، والمثاني ذكر الشيء مع مقابله؛ فالقرآن مثاني من وجه ومتشابه من وجه. وقد استفاد الكاتب من هذا المفتاح في دراسة أوجه التناسب المعنوي في البيان القرآني، فأوضح كيف تنتظم فيه المعاني المتوافقة المتشابهة، وكيف تنتظم المعاني المتقابلة، وبين كيف تراعى وحدة السورة في إيراد المعاني وانتقاء المبـاني، وكيف تأتي الـكلمة المفردة بمعنـاها ومبناها متمكنة في موقعها لا يسد مسدها شيء.
فالقرآن أحسن الحديث من حيث تناسب المعاني وتناسب المباني والأصوات؛ فهو حديث يروق الأسماع ويبعث اللذة في النفوس، وذلك لتناسب ألفاظه ومبانيه ومقاطعه وأصواته.
وقد بين الكاتب أن هذه الدراسة التناسبية، ليست منحصرة في علم واحد من علوم القرآن، ولا في جانب واحد من بلاغة القرآن، بل هي دراسة تركيبية تقوم على التقاط ثمرات علوم كثيرة وتسخيرها في تدبر خصائص البيان القرآني [2] .
وقد ألف في علم التناسب أو علم المناسبة من القدماء ابن الزبير الغرناطي كتاب "البرهان في ترتيب سور القرآن" وألف بعده البقاعي [ ص: 43 ] كتاب "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" [3] ، ثم ألف السيوطي كتاب "قطف الأزهار في كشف الأسرار" وكتاب "تناسق الدرر في تناسب السور" وكتاب "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" [4] .
وكتب فيه من المحدثين مصطفى صادق الرافعي، فقد خص حديثه عن الإعجاز القرآني في كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، وبين فيه القيمة الجمالية لتركيب الأصوات وتلاؤمها وتناسب الألفاظ وحسن ائتلافها وتناسب الفواصل وتناسب المعاني [5] .
وكتب فيه أيضا سيد قطب، في كتاب "التصوير الفني في القرآن"، ومحمد عبد الله دراز، في كتابه "النبأ العظيم".
ومما له صلة وثيقة بالتناسب في النظم القرآني علم توجيه متشابهات القرآن [6] ، وهو علم يبحث في توجيه ما تكرر من الآيات لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير، أو بعض زيادة في التعبير، عن علل الائتلاف والاختلاف. /14 ووجه الصلة بين المناسبة والمتشابه، أن المتشابه يبحث في تركيب الآيات [ ص: 44 ] وألفاظها، ويبين وجه مناسبة كل تركيب للسياق الذي وردت فيه الآية. والمشتبهات نوع يتداخل مع نوع المناسبات [7] .
أما صـاحب كتاب "التناسـب البياني في القرآن" فقد قسم دراسته إلى قسمين: قسـم للتناسب المعنوي وقسم للتناسب اللفظي والإيقاعي. فأما التناسب المعنوي ففيه تناسب المعاني المتوافقة، وهو الذي يكون في وحدة السورة، كأن تكون الوحدة بين مطلع السورة وموضوعها أو بين مطلعها وختامها أو بين الحلقات القصصية وموضوع السورة. وقد يكون تناسب المعاني في آيات العقيدة، أو في التعقيبات التي ترد في خواتم الآيات أو في أعقاب القصص القرآني. وقد تكون تلك المعاني متناسبة تناسب تقابل وطباق. وقد تكون المناسبة المعنوية في اختيار المفردات واختيار التراكيب.
وأما التناسب اللفظي الإيقاعي فيظهر في قيمة التناسب بين أصوات القرآن، وأثر ذلك في جمال الإيقاع وروعة القرآن وتأثيره في نفوس السامعين وإن لم يكونوا غير ناطقين بالعربية. ومن التناسب اللفظي أيضا تناسب المشاكلة وتناسب المجاورة والإتباع. ومن مظاهر تناسب الأصوات القرآنية أيضا التوازن في النظم الصوتي وتناسب الفواصل.
وهكذا فقد كشف منهج الكتاب أن التناسب البياني في القرآن الكريم مبني على نظم عجيب تألفت درره وتناسبت عناصره، فلا تفاوت ولا تنافر ولا تباين ولا اختلاف في شيء منه، وهو نظم متناسب في معانيه ومبانيه، في ألفاظه وأصواته، في إيقاعه وفواصله. والسورة منه بنية محكمة البناء، [ ص: 45 ] مطلعها يناسب موضوعها ومقاصدها وخاتمتها، ومعانيها الجزئية ومقاطعها متناسبة تناسبا يرتكز على التوافق ومراعاة النظير، وعلى التقابل ومراعاة التضاد. ويبدو أن التوافق المعنوي أبرز عناصر الوحدة في كل سورة، ومن مظاهر التوافق افتتاح السورة بما يناسب غرضها وروحها وختمها، واختتامها بما يناسب فاتحتها.
ومن مزايا هذه الدراسة أنها استطاعت جمع ما تناثر من أطراف موضوع التناسب القرآني في دراسة واحدة بعد أن كانت موزعة في كثير من فروع الدراسات القرآنية والبلاغية.
وقد دعا الباحث إلى تعميم مصطلح التناسب للتخلص من كثرة المصطلحات المرهقة. وتخليص البحث في إعجاز القرآن مما علق به من آثار الخلاف في قضية اللفظ والمعنى [8] .
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- كتاب الأمة

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بو درع
- نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
- بلاغة النص في القرآن مقاربة من زاوية علم لغة النص
- نماذج من القراءات النصية
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
[1] القراءة التناسبية
 صفحة
42
صفحة
42
 جزء
1
جزء
1
- نَماذج من القِراءات النصية:
1- القراءَة التّناسُبِيّةُ:
التَّناسُبُ قانونٌ كَوْنيٌّ كُلّيّ، دلّ عَليْه قولُه تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=1 ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=2الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=3الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلَقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ) (المُلْك:1-4).
والقِراءةُ التّناسُبيّةُ دِراسةٌ تتَناولُ أوجُهَ التّناسُبِ المَعنويِّ واللّفظيِّ والصّوتيّ في البَيانِ القُرآنيّ، بطريقةٍ تجمَعُ بينَ النّظريّةِ والتّطبيقِ [1] ، ومفْتاحُ دِراسَةِ التّناسُبِ في النّصِّ القُرآنيّ قولُه تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=23 ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ [ ص: 42 ] إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَنْ هَادٍ ) (الزُّمَر:23)، فالتّشـابُه في الآيَةِ يُشيرُ إلى ذِكْرِ الشّيءِ مَع نَظيرِه، والمَثاني ذِكْرُ الشّيءِ مَعَ مُقابلِه؛ فالقُرآنُ مَثاني مِن وَجْه ومُتَشابِه من وَجْهٍ. وقَد اسْتَفادَ الكاتبُ مِنْ هذا المفتاحِ في دِراسةِ أوجُه التّناسُبِ المَعنويّ في البَيانِ القُرآنيّ، فأوضَحَ كَيفَ تنْتظمُ فيه المَعاني المُتَوافقَةُ المُتشابهةُ، وكيْفَ تنتظمُ المَعاني المُتقابِلَةُ، وبيّنَ كيْفَ تُراعى وحدَةُ السّورَةِ في إيرادِ المَعاني وانتقاءِ المَبـاني، وكَيْفَ تأتي الـكلمةُ المُفرَدةُ بمَعنـاها ومَبْناها مُتمكِّنةً في مَوقعِها لا يسدُّ مَسدَّها شيءٌ.
فالقُرآنُ أحسَنُ الحَديثِ منْ حَيثُ تناسُب المَعاني وتَناسُب المَباني والأصْواتِ؛ فَهُوَ حَديثٌ يَروقُ الأسماعَ ويبعثُ اللّذّةَ في النّفوسِ، وذلِكَ لِتَناسُبِ ألفاظِه ومَبانيه ومَقاطعِه وأصْواتِه.
وقَد بيّنَ الكاتبُ أنّ هذه الدّراسَةَ التّناسُبيّةَ، لَيْسَت مُنحَصِرةً في عِلْمٍ واحدٍ من عُلومِ القُرآنِ، ولا في جانبٍ واحدٍ من بَلاغَةِ القُرآنِ، بَل هي دِراسَةٌ تَركيبيّةٌ تَقومُ عَلى الْتقاطِ ثَمراتِ عُلومٍ كَثيرةٍ وتَسخيرِها في تَدبُّرِ خَصائصِ البَيانِ القُرآنيّ [2] .
وقَد ألّفَ في علمِ التّناسُبِ أو علمِ المُناسبَةِ من القُدَماءِ ابنُ الزّبَيْر الغَرناطيّ كتابَ "البُرهان في تَرتيبِ سُوَر القُرآن" وألّفَ بعدَه البقاعيُّ [ ص: 43 ] كتابَ "نَظْم الدُّرَر في تَناسُبِ الآياتِ والسُّوَر" [3] ، ثُمّ ألَّفَ السّيوطيّ كتابَ "قَطْف الأزْهار في كَشْفِ الأسْرارِ" وكتابَ "تَناسُق الدُّرَر في تَناسُبِ السُّوَر" وكتابَ "مَراصد المُطالِع في تَناسُبِ المَقاطِع والمَطالِع" [4] .
وكَتبَ فيهِ منَ المُحْدَثينَ مُصطَفى صادق الرّافعيّ، فقَد خَصّ حَديثَه عَن الإعْجازِ القُرآنيّ في كتابِه "إعْجاز القُرْآنِ والبَلاغةُ النّبَويّة"، وبيّنَ فيه القيمةَ الجَماليّةَ لتَرْكيبِ الأصواتِ وتَلاؤُمِها وتَناسُبِ الألفاظِ وحُسنِ ائتِلافِها وتَناسُبِ الفَواصِلِ وتَناسُبِ المَعاني [5] .
وكَتَبَ فيه أيضًا سَيّد قُطْب، في كتابِ "التّصوير الفَنّي في القُرآن"، ومحمّد عَبْد الله دَرّاز، في كِتابِه "النّبأ العَظيم".
وممّا لَه صِلةٌ وَثيقَةٌ بالتَّناسٌبِ في النّظمِ القُرآنيّ عِلْمُ تَوجيهِ مُتَشابهاتِ القُرآنِ [6] ، وهو عِلمٌ يَبحثُ في تَوجيه ما تَكرَّرَ من الآياتِ لَفظًا أو اخْتلَفَ بتَقديمٍ أو تأخيرٍ، أو بَعضِ زيادةٍ في التّعبيرِ، عَن علل الائْتِلافِ والاخْتلافِ. /14 ووجهُ الصّلَةِ بينَ المُناسَبَة والمُتَشابِه، أنّ المُتشابِه يبحثُ في تَركيبِ الآياتِ [ ص: 44 ] وألْفاظِها، ويُبيِّنُ وَجْهَ مُناسبَةِ كُلِّ تَركيبٍ للسِّياقِ الذي وَرَدَت فيه الآيَةُ. والمُشتَبِهاتُ نَوعٌ يَتداخلُ مَعَ نَوعِ المناسَباتِ [7] .
أمّا صـاحبُ كِتابِ "التّناسُـب البَيانيّ في القُرآنِ" فقَد قسّمَ دراستَه إلى قِسْمَيِن: قِسْـمٍ للتّناسُبِ المَعْنَويّ وقِسمٍ للتّناسُبِ اللّفظِيّ والإيقاعيّ. فأمّا التّناسُبُ المَعْنَويّ ففيه تَناسُبُ المَعاني المُتَوافقَة، وهو الذي يَكونُ في وَحْدَةِ السّورَةِ، كأن تكونَ الوَحْدَةُ بينَ مطلَعِ السّورةِ ومَوضوعِها أو بَيْن مَطْلَعِها وخِتامِها أو بيْنَ الحَلقاتِ القَصَصيّةِ ومَوضوعِ السّورَةِ. وقَد يَكونُ تَناسُبُ المَعاني في آياتِ العَقيدَةِ، أو في التَّعْقيباتِ التي تَرِدُ في خَواتِمِ الآياتِ أو في أعْقابِ القَصَصِ القُرآنيِّ. وقَد تَكونُ تلكَ المَعاني مُتَناسِبَةً تَناسُبَ تَقابُلٍ وطِباقٍ. وقَد تَكونُ المُناسَبَةُ المعنويّةُ في اخْتيارِ المُفرَداتِ واختيارِ التَّراكيبِ.
وأمّا التّناسُبُ اللَّفْظيُّ الإيقاعيُّ فيَظهَرُ في قيمَةِ التّناسُبِ بَيْنَ أصواتِ القُرآنِ، وأثَرِ ذلِكَ في جَمالِ الإيقاعِ ورَوْعَةِ القُرآنِ وتأثيرِه في نُفوسِ السّامِعينَ وإنْ لَم يَكونوا غيرَ ناطقينَ بالعربيّةِ. ومنَ التَّناسُبِ اللّفظيّ أيضًا تَناسُبُ المُشاكَلَةِ وتَناسُبُ المُجاوَرَةِ والإتْباعِ. ومِنْ مَظاهِرِ تَناسُبِ الأصْواتِ القُرآنيّةِ أيضًا التَّوازُنُ في النّظمِ الصّوتيّ وتَناسُبُ الفَواصلِ.
وهكَذا فقَد كَشَفَ منهَجُ الكتابِ أنّ التناسُبَ البيانيَّ في القُرآنِ الكَريمِ مَبْنيٌّ على نظمٍ عَجيبٍ تألَفَت دُرَرُه وتَناسَبَت عَناصرُه، فَلا تَفاوُتَ ولا تَنافُرَ ولا تَبايُنَ ولا اخْتلافَ في شيْءٍ منه، وهو نَظمٌ مُتَناسبٌ في مَعانيه ومَبانيه، في ألفاظِه وأصْواتِه، في إيقاعِه وفَواصلِه. والسّورَةُ منه بنيةٌ مُحكَمَةُ البِناءِ، [ ص: 45 ] مَطلعُها يُناسبُ مَوضوعَها ومَقاصدهَا وخاتمتَها، ومَعانيها الجُزئيّةُ ومَقاطعُها مُتناسبةٌ تناسبًا يرتكزُ عَلى التّوافُقِ ومُراعاةِ النَّظيرِ، وعلى التَّقابُلِ ومُراعاةِ التّضادِّ. ويَبدو أنّ التّوافُقَ المَعْنويَّ أبرزُ عَناصرِ الوحدَةِ في كلِّ سورةٍ، ومن مَظاهِرِ التّوافُقِ افْتتاحُ السّورةِ بِما يُناسبُ غَرَضَها وروحَها وخَتْمَها، واخْتِتامُها بِما يُناسبُ فاتِحَتَها.
ومن مَزايا هذه الدّراسَةِ أنّها استطاعَتْ جَمعَ ما تَناثَرَ من أطرافِ مَوضوعِ التّناسُبِ القُرآنيّ في دراسةٍ واحدَةٍ بعدَ أن كانَت موزّعَةً في كثيرٍ مِنْ فُروعِ الدِّراساتِ القُرآنيّةِ والبَلاغيّةِ.
وقَد دَعا الباحثُ إلى تَعْميمِ مُصطَلَحِ التَّناسُبِ للتّخلُّصِ من كثرةِ المُصطَلَحاتِ المُرهِقَة. وتَخْليص البَحْثِ في إعْجازِ القُرآنِ ممّا عَلِقَ بِه من آثارِ الخلافِ في قضيّةِ اللّفظِ والمَعْنى [8] .
1- القراءَة التّناسُبِيّةُ:
التَّناسُبُ قانونٌ كَوْنيٌّ كُلّيّ، دلّ عَليْه قولُه تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=1 ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=2الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=3الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلَقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ) (المُلْك:1-4).
والقِراءةُ التّناسُبيّةُ دِراسةٌ تتَناولُ أوجُهَ التّناسُبِ المَعنويِّ واللّفظيِّ والصّوتيّ في البَيانِ القُرآنيّ، بطريقةٍ تجمَعُ بينَ النّظريّةِ والتّطبيقِ [1] ، ومفْتاحُ دِراسَةِ التّناسُبِ في النّصِّ القُرآنيّ قولُه تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=23 ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ [ ص: 42 ] إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَنْ هَادٍ ) (الزُّمَر:23)، فالتّشـابُه في الآيَةِ يُشيرُ إلى ذِكْرِ الشّيءِ مَع نَظيرِه، والمَثاني ذِكْرُ الشّيءِ مَعَ مُقابلِه؛ فالقُرآنُ مَثاني مِن وَجْه ومُتَشابِه من وَجْهٍ. وقَد اسْتَفادَ الكاتبُ مِنْ هذا المفتاحِ في دِراسةِ أوجُه التّناسُبِ المَعنويّ في البَيانِ القُرآنيّ، فأوضَحَ كَيفَ تنْتظمُ فيه المَعاني المُتَوافقَةُ المُتشابهةُ، وكيْفَ تنتظمُ المَعاني المُتقابِلَةُ، وبيّنَ كيْفَ تُراعى وحدَةُ السّورَةِ في إيرادِ المَعاني وانتقاءِ المَبـاني، وكَيْفَ تأتي الـكلمةُ المُفرَدةُ بمَعنـاها ومَبْناها مُتمكِّنةً في مَوقعِها لا يسدُّ مَسدَّها شيءٌ.
فالقُرآنُ أحسَنُ الحَديثِ منْ حَيثُ تناسُب المَعاني وتَناسُب المَباني والأصْواتِ؛ فَهُوَ حَديثٌ يَروقُ الأسماعَ ويبعثُ اللّذّةَ في النّفوسِ، وذلِكَ لِتَناسُبِ ألفاظِه ومَبانيه ومَقاطعِه وأصْواتِه.
وقَد بيّنَ الكاتبُ أنّ هذه الدّراسَةَ التّناسُبيّةَ، لَيْسَت مُنحَصِرةً في عِلْمٍ واحدٍ من عُلومِ القُرآنِ، ولا في جانبٍ واحدٍ من بَلاغَةِ القُرآنِ، بَل هي دِراسَةٌ تَركيبيّةٌ تَقومُ عَلى الْتقاطِ ثَمراتِ عُلومٍ كَثيرةٍ وتَسخيرِها في تَدبُّرِ خَصائصِ البَيانِ القُرآنيّ [2] .
وقَد ألّفَ في علمِ التّناسُبِ أو علمِ المُناسبَةِ من القُدَماءِ ابنُ الزّبَيْر الغَرناطيّ كتابَ "البُرهان في تَرتيبِ سُوَر القُرآن" وألّفَ بعدَه البقاعيُّ [ ص: 43 ] كتابَ "نَظْم الدُّرَر في تَناسُبِ الآياتِ والسُّوَر" [3] ، ثُمّ ألَّفَ السّيوطيّ كتابَ "قَطْف الأزْهار في كَشْفِ الأسْرارِ" وكتابَ "تَناسُق الدُّرَر في تَناسُبِ السُّوَر" وكتابَ "مَراصد المُطالِع في تَناسُبِ المَقاطِع والمَطالِع" [4] .
وكَتبَ فيهِ منَ المُحْدَثينَ مُصطَفى صادق الرّافعيّ، فقَد خَصّ حَديثَه عَن الإعْجازِ القُرآنيّ في كتابِه "إعْجاز القُرْآنِ والبَلاغةُ النّبَويّة"، وبيّنَ فيه القيمةَ الجَماليّةَ لتَرْكيبِ الأصواتِ وتَلاؤُمِها وتَناسُبِ الألفاظِ وحُسنِ ائتِلافِها وتَناسُبِ الفَواصِلِ وتَناسُبِ المَعاني [5] .
وكَتَبَ فيه أيضًا سَيّد قُطْب، في كتابِ "التّصوير الفَنّي في القُرآن"، ومحمّد عَبْد الله دَرّاز، في كِتابِه "النّبأ العَظيم".
وممّا لَه صِلةٌ وَثيقَةٌ بالتَّناسٌبِ في النّظمِ القُرآنيّ عِلْمُ تَوجيهِ مُتَشابهاتِ القُرآنِ [6] ، وهو عِلمٌ يَبحثُ في تَوجيه ما تَكرَّرَ من الآياتِ لَفظًا أو اخْتلَفَ بتَقديمٍ أو تأخيرٍ، أو بَعضِ زيادةٍ في التّعبيرِ، عَن علل الائْتِلافِ والاخْتلافِ. /14 ووجهُ الصّلَةِ بينَ المُناسَبَة والمُتَشابِه، أنّ المُتشابِه يبحثُ في تَركيبِ الآياتِ [ ص: 44 ] وألْفاظِها، ويُبيِّنُ وَجْهَ مُناسبَةِ كُلِّ تَركيبٍ للسِّياقِ الذي وَرَدَت فيه الآيَةُ. والمُشتَبِهاتُ نَوعٌ يَتداخلُ مَعَ نَوعِ المناسَباتِ [7] .
أمّا صـاحبُ كِتابِ "التّناسُـب البَيانيّ في القُرآنِ" فقَد قسّمَ دراستَه إلى قِسْمَيِن: قِسْـمٍ للتّناسُبِ المَعْنَويّ وقِسمٍ للتّناسُبِ اللّفظِيّ والإيقاعيّ. فأمّا التّناسُبُ المَعْنَويّ ففيه تَناسُبُ المَعاني المُتَوافقَة، وهو الذي يَكونُ في وَحْدَةِ السّورَةِ، كأن تكونَ الوَحْدَةُ بينَ مطلَعِ السّورةِ ومَوضوعِها أو بَيْن مَطْلَعِها وخِتامِها أو بيْنَ الحَلقاتِ القَصَصيّةِ ومَوضوعِ السّورَةِ. وقَد يَكونُ تَناسُبُ المَعاني في آياتِ العَقيدَةِ، أو في التَّعْقيباتِ التي تَرِدُ في خَواتِمِ الآياتِ أو في أعْقابِ القَصَصِ القُرآنيِّ. وقَد تَكونُ تلكَ المَعاني مُتَناسِبَةً تَناسُبَ تَقابُلٍ وطِباقٍ. وقَد تَكونُ المُناسَبَةُ المعنويّةُ في اخْتيارِ المُفرَداتِ واختيارِ التَّراكيبِ.
وأمّا التّناسُبُ اللَّفْظيُّ الإيقاعيُّ فيَظهَرُ في قيمَةِ التّناسُبِ بَيْنَ أصواتِ القُرآنِ، وأثَرِ ذلِكَ في جَمالِ الإيقاعِ ورَوْعَةِ القُرآنِ وتأثيرِه في نُفوسِ السّامِعينَ وإنْ لَم يَكونوا غيرَ ناطقينَ بالعربيّةِ. ومنَ التَّناسُبِ اللّفظيّ أيضًا تَناسُبُ المُشاكَلَةِ وتَناسُبُ المُجاوَرَةِ والإتْباعِ. ومِنْ مَظاهِرِ تَناسُبِ الأصْواتِ القُرآنيّةِ أيضًا التَّوازُنُ في النّظمِ الصّوتيّ وتَناسُبُ الفَواصلِ.
وهكَذا فقَد كَشَفَ منهَجُ الكتابِ أنّ التناسُبَ البيانيَّ في القُرآنِ الكَريمِ مَبْنيٌّ على نظمٍ عَجيبٍ تألَفَت دُرَرُه وتَناسَبَت عَناصرُه، فَلا تَفاوُتَ ولا تَنافُرَ ولا تَبايُنَ ولا اخْتلافَ في شيْءٍ منه، وهو نَظمٌ مُتَناسبٌ في مَعانيه ومَبانيه، في ألفاظِه وأصْواتِه، في إيقاعِه وفَواصلِه. والسّورَةُ منه بنيةٌ مُحكَمَةُ البِناءِ، [ ص: 45 ] مَطلعُها يُناسبُ مَوضوعَها ومَقاصدهَا وخاتمتَها، ومَعانيها الجُزئيّةُ ومَقاطعُها مُتناسبةٌ تناسبًا يرتكزُ عَلى التّوافُقِ ومُراعاةِ النَّظيرِ، وعلى التَّقابُلِ ومُراعاةِ التّضادِّ. ويَبدو أنّ التّوافُقَ المَعْنويَّ أبرزُ عَناصرِ الوحدَةِ في كلِّ سورةٍ، ومن مَظاهِرِ التّوافُقِ افْتتاحُ السّورةِ بِما يُناسبُ غَرَضَها وروحَها وخَتْمَها، واخْتِتامُها بِما يُناسبُ فاتِحَتَها.
ومن مَزايا هذه الدّراسَةِ أنّها استطاعَتْ جَمعَ ما تَناثَرَ من أطرافِ مَوضوعِ التّناسُبِ القُرآنيّ في دراسةٍ واحدَةٍ بعدَ أن كانَت موزّعَةً في كثيرٍ مِنْ فُروعِ الدِّراساتِ القُرآنيّةِ والبَلاغيّةِ.
وقَد دَعا الباحثُ إلى تَعْميمِ مُصطَلَحِ التَّناسُبِ للتّخلُّصِ من كثرةِ المُصطَلَحاتِ المُرهِقَة. وتَخْليص البَحْثِ في إعْجازِ القُرآنِ ممّا عَلِقَ بِه من آثارِ الخلافِ في قضيّةِ اللّفظِ والمَعْنى [8] .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام


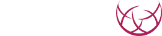








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات