- التأكيد بالقصر: القصر تخصيص شيء بشيء معهود [1] ، أو هو تخصيص أحد طرفي الكلام بالآخر، ويؤتى به لتأكيد الحكم لمنكره، أو هو "جعل أحد طرفي النسبة في الكلام، سواء كانت إسنادية أو غيرها، مخصوصا بالآخر، بحيث لا يتجاوزه" [2] . وللقصر طرق منها: النفي والاستثناء، ومنها العطف بلا أو بل، ومنها تقديم المعمول، نحو: ( إياك نعبد وإياك نستعين ) (الفاتحة:5)، ومنها إنما وأنما.
وسأقتصر على إيراد بعض الشواهد الحديثية التي استعمل فيها أسلوب القصر بإنما. وأداة الحصر "إنما" لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة، وساعد معناها على الانحصار [ ص: 115 ] صح ذلك وترتب، كقوله تعالى: ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) (الكهف:110)، وغير ذلك من الأمثلة. وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار، بقيت إنما للمبالغة فقط، كقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الربا في النسيئة" [3] .
ومن الأحاديث التي ورد بها القصر بإنما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) [4] .
يعد هذا الحديث البليغ من جوامع الكلم، وهو حديث مشهور أجمع العلماء على عظيم فائدته، حتى قال بعض الفقهاء: "حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم"، وروي عن الشافعي أنه قال: "هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه" [5] . [ ص: 116 ]
ومن قواعد الفقه التي استخرجت من هذا الحديث الجامع، قاعدة "الأمور بمقاصدها"، واتفقوا على صحة الحديث وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه "الصحيح"، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له [6] . وروي عن الإمام أحمد قوله: "إن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث عائشة "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وحديث النعمان بن بشير ( الحلال بين والحرام بين ) [7] . وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال : "جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وجمع أمر الدنيا في كلمة واحدة: "إنما الأعمال بالنيات"، يدخلان في كل باب" [8] .
يفيد حديث ( إنما الأعمال بالنيات ... ) قصر الموصوف (وهو الأعمال) على الصفة (وهي الارتباط بالنيات). وفيه حذف، وتقدير المحذوف: إنما صحة الأعمال أو كمالها أو قبولها، بالنيات. كما ورد في [ ص: 117 ] حديث آخر: ( إنما الأعمـال بالخواتيـم ) [9] ، أي صـلاحها وفسادها، أو قبولها وعدمها بحسب الخاتمة. والمقصود بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وشرعت النية لتمييز العادة عن العبادة. والراجح أن النية في الحديث، إنما يراد بها الإرادة والقصد المصاحب للفعل كما ورد في قوله تعالى: ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) ، (آل عمران :152) أما تسمية هذا المعنى بلفظ النية فقد ورد كثيرا في السنة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( من غزا في سبيل الله، ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى ) [10] ، وقوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ( إنما يبعث الناس على نياتهم ) [11] .
وقد أطلق لفظ ( الأعمال ) وأريد به أعمال الطاعات دون أعمال المباحات، ولا دخل للأعمـال المحرمة أو المكروهة في المراد من اللفظ. [ ص: 118 ] وهذا الإطلاق تقيده نصوص أخرى، وهو في ذاته يستوعب المعاني المحتملة، فيكون اللفظ العام في الحديث كالقاعدة لما تحتها من المعاني المحتملة، وبهذا يعلم ما روى الإمام أحمـد أن أصول الإسـلام ثلاثة أحاديث: حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وحديث "الحلال بين والحرام بين". فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. فنص الحديث بهذا المعنى الكلام البليغ ومن جوامع الكلم؛ لأنه يتخذ كالقاعدة الكلية التي تجمع وتستوعب ما تحتها مما يندرج في باب النية والإخلاص.
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- كتاب الأمة

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بو درع
- نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
- بلاغة النص في الحديث النبوي الشريف مقاربة من زاوية علم لغة النص
- من مظاهر بلاغة النص الحديثي
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
التأكيد بالقصر
 صفحة
115
صفحة
115
 جزء
1
جزء
1
- التَّأكيد بالقَصْرِ: القَصْرُ تَخْصيصُ شيْءٍ بشيْءٍ مَعْهودٍ [1] ، أو هو تَخْصيص أحد طرفي الكلام بالآخَرِ، ويُؤْتى به لتأكيدِ الحُكْمِ لمُنْكِرِه، أو هو "جعْلُ أحدِ طرَفَي النّسِبَةِ في الكلامِ، سواء كانت إسناديةً أو غيرها، مخْصوصًا بالآخَرِ، بحيثُ لا يتجاوزُه" [2] . وللْقصْرِ طُرقٌ منْها: النّفْي والاسْتِثْناء، ومنها العطْفُ بِلا أو بلْ، ومنها تقديمُ المعمولِ، نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5 ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (الفاتِحَة:5)، ومنْها إِنَّما وأَنَّما.
وسأقْتَصِرُ على إيرادِ بعضِ الشّواهِدِ الحَديثيّةِ التي استعمِلَ فيها أُسْلوبُ القصْرِ بإنّما. وأداةُ الحَصْرِ "إنّما" لفظٌ لا تُفارِقُه المبالَغَةُ والتّأكيدُ حيثُ وقعَ، ويصْلُحُ مع ذلِك للحصْرِ، فإذا دخلَ في قصّةٍ، وساعدَ معناها على الانْحِصارِ [ ص: 115 ] صحّ ذلِك وترتّبَ، كقولِه تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110 ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (الكَهْف:110)، وغَيْر ذلِك مِن الأمْثِلةِ. وإذا كانت القصّةُ لا تتأتّى للانْحِصارِ، بقيتْ إِنَّما للمُبالغةِ فقط، كقولِه صلى الله عليه وسلم : "إِنَّما الرِّبا في النَّسيئَةِ" [3] .
ومن الأحاديثِ التي ورَدَ بِها القصْرُ بإِنَّما قوْلُه صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الذي رَواهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رضي الله عنه :
( إِنَّما الأَعْمالُ بِالنّيّاتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى، فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إِلى اللهِ ورَسولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسولِهِ، ومنْ كانتْ هجْرتُه لِدُنْيا يُصيبُها أو امْرَأَةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُه إلى ما هاجَرَ إليْه ) [4] .
يُعدُّ هذا الحديثُ البَليغُ من جَوامِعِ الكلِمِ، وهوَ حديثٌ مَشْهورٌ أَجْمَعَ العُلَماءُ عَلى عَظيمِ فائِدَتِهِ، حَتّى قالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: "حديثُ النّيّةِ يدْخُلُ في ثَلاثينَ بابًا من العِلْمِ"، ورُوِيَ عنِ الشّافِعِيّ أنّهُ قالَ: "هذا الحديثُ ثُلُثُ العِلْمِ، ويدْخُلُ في سَبْعينَ بابًا مِن الفِقْهِ" [5] . [ ص: 116 ]
ومِنْ قَواعِدِ الفِقْهِ التي اسْتُخْرِجَتْ مِن هذا الحَديثِ الجامِعِ، قاعِدَةُ "الأُمور بِمَقاصِدِها"، واتّفَقوا على صِحَّةِ الحديثِ وتلقّيهِ بالقَبولِ، وبِهِ صَدَّرَ البُخاري كِتابَه "الصَّحيح"، وأقامَه مقامَ الخُطْبَةِ لَهُ، إشارَةً إلى أنّ كُلَّ عملٍ لا يُرادُ بِه وَجْهُ اللهِ فهُو باطِلٌ لا ثَمَرَةَ لَه [6] . ورُوِيَ عن الإمامِ أحمدَ قوْلُه: "إِنَّ أُصولَ الإسْلامِ على ثَلاثَةِ أَحاديثَ: حَديث عُمَرَ "إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيّاتِ"، وحديثُ عائِشَةَ "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ"، وحَديثُ النُّعْمانِ بْنِ بَشيرٍ ( اَلْحَلالُ بَيِّنٌ والْحَرامُ بَيِّنٌ ) [7] . ورَوَى عُثْمانُ بْنُ سَعيدٍ عنْ أبي عُبَيْدٍ قالَ : "جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَميعَ أمْرِ الآخِرَةِ في كَلِمَةٍ واحِدةٍ: " مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ"، وجَمَعَ أمْرَ الدُّنْيا في كلِمَةٍ واحِدَةٍ: "إنّما الأعْمالُ بالنّيّاتِ"، يَدْخُلانِ في كلِّ بابٍ" [8] .
يُفيدُ حديثُ ( إنّما الأعْمالُ بالنّيّاتِ ... ) قَصْرَ المَوْصوفِ (وهُوَ الأعْمالُ) عَلى الصِّفَة (وهيَ الارْتِباطُ بالنّيّاتِ). وفيه حَذْفٌ، وتقْديرُ المحذوفِ: إنّما صحّةُ الأعْمالِ أو كَمالُها أو قَبولُها، بالنّيّاتِ. كَما ورَدَ في [ ص: 117 ] حديثٍ آخَر: ( إنَّما الأعْمـالُ بالخواتيـمِ ) [9] ، أيْ صَـلاحُها وفَسادُها، أَوْ قَبولُها وعَدَمُها بِحَسبِ الخاتِمَةِ. والمقصودُ بها الأعمالُ الشّرْعيّةُ المفتقِرَةُ إلى النّيَّةِ. والنّيّةُ شرْعًا قصْدُ الشّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِه، وشُرِعَتِ النّيّةُ لتمْييزِ العادةِ عنِ العِبادةِ. والرّاجِحُ أنّ النّيّةَ في الحديثِ، إنّما يُرادُ بِها الإرادةُ والقصْدُ المُصاحِبُ للفِعْلِ كَما وَرَد في قَوْلِهِ تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=152 ( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ) ، (آل عمْران :152) أمّا تَسْمِيَةُ هذا المَعْنى بِلَفْظِ النِّيَّةِ فَقَدْ وَرَدَ كَثيرًا في السُّنَّةِ، نحْو قَوْله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَزا في سَبيلِ اللهِ، ولمْ يَنْوِ إلاّ عقالًا فَلَه ما نَوى ) [10] ، وقَوْلِهِ: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ( إِنَّما يُبْعَثُ النّاسُ على نيّاتِهِم ) [11] .
وقدْ أُطْلقَ لَفظُ ( الأعْمالِ ) وأُريدَ به أعْمالُ الطّاعاتِ دونَ أعْمالِ المُباحاتِ، ولا دخْلَ للأعْمـالِ المُحرَّمَةِ أو المكْروهةِ في المُرادِ من اللّفْظِ. [ ص: 118 ] وهذا الإطْلاقُ تُقيِّده نُصوصٌ أخْرى، وهو في ذاتِهِ يَسْتَوْعِبُ المَعانِيَ الْمُحْتمَلَةَ، فَيكون اللّفْظُ العامُّ في الحديثِ كالقاعِدةِ لِما تحْتَها من المَعاني المُحْتَمَلَةِ، وبهذا يُعْلَمُ ما رَوى الإمامُ أَحمـدُ أنّ أُصولَ الإسـلامِ ثلاثَةُ أحاديثَ: حديثُ "إنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ"، وحديثُ "مَن أحدثَ في أمرِنا ما ليسَ منهُ فهو ردٌّ"، وحديثُ "الحلالُ بيّنٌ والحرامُ بيّنٌ". فإنّ الدّينَ كلّه يرْجِعُ إلى فعلِ المأموراتِ وترْكِ المحظوراتِ والتّوقُّفِ عن الشُّبُهاتِ. فنصُّ الحَديثِ بهذا المَعْنى الكَلامِ البَليغِ ومِن جَوامِعِ الكَلِمِ؛ لأنّه يُتَّخَذُ كالقاعِدةِ الكلّيّةِ التي تَجمعُ وتسْتوعِبُ ما تحْتها ممّا يندرِجُ في بابِ النّيّةِ والإخْلاصِ.
وسأقْتَصِرُ على إيرادِ بعضِ الشّواهِدِ الحَديثيّةِ التي استعمِلَ فيها أُسْلوبُ القصْرِ بإنّما. وأداةُ الحَصْرِ "إنّما" لفظٌ لا تُفارِقُه المبالَغَةُ والتّأكيدُ حيثُ وقعَ، ويصْلُحُ مع ذلِك للحصْرِ، فإذا دخلَ في قصّةٍ، وساعدَ معناها على الانْحِصارِ [ ص: 115 ] صحّ ذلِك وترتّبَ، كقولِه تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110 ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (الكَهْف:110)، وغَيْر ذلِك مِن الأمْثِلةِ. وإذا كانت القصّةُ لا تتأتّى للانْحِصارِ، بقيتْ إِنَّما للمُبالغةِ فقط، كقولِه صلى الله عليه وسلم : "إِنَّما الرِّبا في النَّسيئَةِ" [3] .
ومن الأحاديثِ التي ورَدَ بِها القصْرُ بإِنَّما قوْلُه صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الذي رَواهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رضي الله عنه :
( إِنَّما الأَعْمالُ بِالنّيّاتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى، فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إِلى اللهِ ورَسولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسولِهِ، ومنْ كانتْ هجْرتُه لِدُنْيا يُصيبُها أو امْرَأَةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُه إلى ما هاجَرَ إليْه ) [4] .
يُعدُّ هذا الحديثُ البَليغُ من جَوامِعِ الكلِمِ، وهوَ حديثٌ مَشْهورٌ أَجْمَعَ العُلَماءُ عَلى عَظيمِ فائِدَتِهِ، حَتّى قالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: "حديثُ النّيّةِ يدْخُلُ في ثَلاثينَ بابًا من العِلْمِ"، ورُوِيَ عنِ الشّافِعِيّ أنّهُ قالَ: "هذا الحديثُ ثُلُثُ العِلْمِ، ويدْخُلُ في سَبْعينَ بابًا مِن الفِقْهِ" [5] . [ ص: 116 ]
ومِنْ قَواعِدِ الفِقْهِ التي اسْتُخْرِجَتْ مِن هذا الحَديثِ الجامِعِ، قاعِدَةُ "الأُمور بِمَقاصِدِها"، واتّفَقوا على صِحَّةِ الحديثِ وتلقّيهِ بالقَبولِ، وبِهِ صَدَّرَ البُخاري كِتابَه "الصَّحيح"، وأقامَه مقامَ الخُطْبَةِ لَهُ، إشارَةً إلى أنّ كُلَّ عملٍ لا يُرادُ بِه وَجْهُ اللهِ فهُو باطِلٌ لا ثَمَرَةَ لَه [6] . ورُوِيَ عن الإمامِ أحمدَ قوْلُه: "إِنَّ أُصولَ الإسْلامِ على ثَلاثَةِ أَحاديثَ: حَديث عُمَرَ "إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيّاتِ"، وحديثُ عائِشَةَ "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ"، وحَديثُ النُّعْمانِ بْنِ بَشيرٍ ( اَلْحَلالُ بَيِّنٌ والْحَرامُ بَيِّنٌ ) [7] . ورَوَى عُثْمانُ بْنُ سَعيدٍ عنْ أبي عُبَيْدٍ قالَ : "جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَميعَ أمْرِ الآخِرَةِ في كَلِمَةٍ واحِدةٍ: " مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ"، وجَمَعَ أمْرَ الدُّنْيا في كلِمَةٍ واحِدَةٍ: "إنّما الأعْمالُ بالنّيّاتِ"، يَدْخُلانِ في كلِّ بابٍ" [8] .
يُفيدُ حديثُ ( إنّما الأعْمالُ بالنّيّاتِ ... ) قَصْرَ المَوْصوفِ (وهُوَ الأعْمالُ) عَلى الصِّفَة (وهيَ الارْتِباطُ بالنّيّاتِ). وفيه حَذْفٌ، وتقْديرُ المحذوفِ: إنّما صحّةُ الأعْمالِ أو كَمالُها أو قَبولُها، بالنّيّاتِ. كَما ورَدَ في [ ص: 117 ] حديثٍ آخَر: ( إنَّما الأعْمـالُ بالخواتيـمِ ) [9] ، أيْ صَـلاحُها وفَسادُها، أَوْ قَبولُها وعَدَمُها بِحَسبِ الخاتِمَةِ. والمقصودُ بها الأعمالُ الشّرْعيّةُ المفتقِرَةُ إلى النّيَّةِ. والنّيّةُ شرْعًا قصْدُ الشّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِه، وشُرِعَتِ النّيّةُ لتمْييزِ العادةِ عنِ العِبادةِ. والرّاجِحُ أنّ النّيّةَ في الحديثِ، إنّما يُرادُ بِها الإرادةُ والقصْدُ المُصاحِبُ للفِعْلِ كَما وَرَد في قَوْلِهِ تَعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=152 ( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ) ، (آل عمْران :152) أمّا تَسْمِيَةُ هذا المَعْنى بِلَفْظِ النِّيَّةِ فَقَدْ وَرَدَ كَثيرًا في السُّنَّةِ، نحْو قَوْله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَزا في سَبيلِ اللهِ، ولمْ يَنْوِ إلاّ عقالًا فَلَه ما نَوى ) [10] ، وقَوْلِهِ: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ( إِنَّما يُبْعَثُ النّاسُ على نيّاتِهِم ) [11] .
وقدْ أُطْلقَ لَفظُ ( الأعْمالِ ) وأُريدَ به أعْمالُ الطّاعاتِ دونَ أعْمالِ المُباحاتِ، ولا دخْلَ للأعْمـالِ المُحرَّمَةِ أو المكْروهةِ في المُرادِ من اللّفْظِ. [ ص: 118 ] وهذا الإطْلاقُ تُقيِّده نُصوصٌ أخْرى، وهو في ذاتِهِ يَسْتَوْعِبُ المَعانِيَ الْمُحْتمَلَةَ، فَيكون اللّفْظُ العامُّ في الحديثِ كالقاعِدةِ لِما تحْتَها من المَعاني المُحْتَمَلَةِ، وبهذا يُعْلَمُ ما رَوى الإمامُ أَحمـدُ أنّ أُصولَ الإسـلامِ ثلاثَةُ أحاديثَ: حديثُ "إنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ"، وحديثُ "مَن أحدثَ في أمرِنا ما ليسَ منهُ فهو ردٌّ"، وحديثُ "الحلالُ بيّنٌ والحرامُ بيّنٌ". فإنّ الدّينَ كلّه يرْجِعُ إلى فعلِ المأموراتِ وترْكِ المحظوراتِ والتّوقُّفِ عن الشُّبُهاتِ. فنصُّ الحَديثِ بهذا المَعْنى الكَلامِ البَليغِ ومِن جَوامِعِ الكَلِمِ؛ لأنّه يُتَّخَذُ كالقاعِدةِ الكلّيّةِ التي تَجمعُ وتسْتوعِبُ ما تحْتها ممّا يندرِجُ في بابِ النّيّةِ والإخْلاصِ.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام


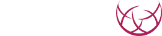








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات