- من مظاهر بلاغة النص الحديثي:
- أسلوب التأكيد:
قال صاحب كتاب "الطراز": "اعلم أن التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ كثير الفوائد، وله مجريان:
- المجرى الأول عام، وهو ما يتعلق بالمعاني الإعرابية، وينقسم إلى لفظي ومعنوي...
- والمجرى الثاني خاص يتعلق بعلوم البيان، ويقال التكرير أيضا" [1] .
وما من نص من نصوص الحديث النبوي إلا وفيه تأكيد لفكرة أو مبدأ أو قاعدة من القواعد بأداة من أدوات التأكيد؛ وذلك لأن الاهتمام بمخاطبة الناس، وانفعال المتكلم بالمعنى الذي يبلغه، يستوجب ضربا من التأكيد، وتطرأ مواقف يلجأ فيها المتكلم إلى إشباع المعنى وتوكيده وتكريره، دون الخروج عن جادة الاختصار والإيجاز. ويتخذ التأكيد في نصوص الحديث ألوانا وأضربا، وذلك بحسب حالة المخاطب في خلو الذهن أو الاستشراف والطلب، أو الشك، أو الإنكار... ويدل ذلك على أن الحديث نص لغوي يلفظه قائل، هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ويوجه إلى مخاطب، في ظروف معينة، /14 هي "أسباب ورود الحديث"، فتكون مراعاة المتكلم للمخاطب وسياق القول [ ص: 102 ] من باب مطابقة المقال لمقتضى الحال؛ إذ يخبر كل شخص بما هو الأفضل في حقه، وما يتنـزل منزلة الدواء الأصلح له [2] ، أو لأن نزول الأحكام مفترقة أيسر على المكلف من أن تكون جملة واحدة، وهو من اللطف بالعباد، أو لأن في دوام تعمير الأوقات بالأخبار المتعلقة بأمور الدين وبشائره وأحكامه، تنشيطا للنفوس وإظهارا للرحمة بها ودليلا على العناية بها.
وللتأكيد أدوات منها: التاكيد بالجملة البسيطة، وبتكرير اللفظ، وبالحروف مثل "إن" و"نون التوكيد" وأدوات القصر، وبأسلوب القسم، وغيرها...:
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- كتاب الأمة

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بو درع
- نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث
- بلاغة النص في الحديث النبوي الشريف مقاربة من زاوية علم لغة النص
- من مظاهر بلاغة النص الحديثي
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
أسلوب التأكيد
 صفحة
102
صفحة
102
 جزء
1
جزء
1
- مِنْ مَظاهِرِ بَلاغةِ النّصّ الحَديثيّ:
- أُسْلوبُ التَّأْكيدِ:
قالَ صاحِبُ كِتابِ "الطِّراز": "اعْلمْ أنّ التّأْكيدَ تمْكينُ الشّيْءِ في النّفْسِ وتقْوِيَةُ أمْرِه، وفائِدَتُه إزالَةُ الشُّكوكِ وإماطةُ الشُّبُهاتِ عمّا أنْتَ بِصَدَدِه، وهو دَقيقُ المأْخَذِ كَثيرُ الفَوائِدِ، ولَه مجْرَيانِ:
- المجْرى الأوّل عامٌّ، وهُو ما يتعلّقُ بالمَعاني الإعْرابِيّة، وينْقَسِمُ إلى لَفْظِيّ ومعْنَويٍّ...
- والمجْرى الثّاني خاصٌّ يتعلَّقُ بِعُلومِ البَيانِ، ويُقالُ التَّكْريرُ أَيْضًا" [1] .
وما مِنْ نَصٍّ من نُصوصِ الحَديثِ النّبَوِيّ إلاّ وفيه تأْكيدٌ لفِكْرَةٍ أو مَبْدَأ أو قاعِدَةٍ من القَواعِدِ بِأداةٍ من أدواتِ التّأْكيدِ؛ وذلِك لأنّ الاهْتِمامَ بِمُخاطَبَةِ النّاس، وانْفِعالَ المُتَكَلِّمِ بالمعْنى الذي يُبَلِّغُه، يَسْتَوْجِبُ ضَرْبًا من التّأْكيدِ، وتطْرأُ مواقِفُ يلْجَأُ فيها المتكلّمُ إلى إشباعِ المعنى وتوكيدِه وتكريرِه، دونَ الخُروجِ عن جادّةِ الاخْتِصارِ والإيجاز. ويتَّخِذُ التّأْكيدُ في نُصوصِ الحَديثِ ألْوانًا وأضْرُبًا، وذلِكَ بِحَسَبِ حالَةِ المُخاطَبِ في خُلُوِّ الذِّهْنِ أو الاسْتِشْرافِ والطَّلَبِ، أو الشَّكِّ، أو الإنْكارِ... ويدُلُّ ذلِكَ على أنّ الحَديثَ نَصٌّ لُغَوِيٌّ يَلْفظُه قائِلٌ، هوَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، ويُوَجَّهُ إلى مُخاطَبٍ، في ظُروفٍ مُعيَّنةٍ، /14 هيَ "أسْبابُ وُرودِ الحَديثِ"، فَتَكونُ مُراعاةُ المُتكلِّمِ للمُخاطَبِ وسِياقِ القَولِ [ ص: 102 ] مِن بابِ مُطابَقَةِ المقالِ لِمُقْتَضى الحالِ؛ إذْ يُخبَرُ كلُّ شخصٍ بما هو الأفضلُ في حقِّه، وما يتنـزَّلُ منزلةَ الدّواءِ الأصلحِ له [2] ، أو لأنّ نزولَ الأحكامِ مفترِقَةً أيسرُ على المكلَّفِ من أن تكونَ جملَةً واحدةً، وهو من اللّطفِ بالعبادِ، أو لأنّ في دوامِ تعميرِ الأوقاتِ بالأخبارِ المتعلّقةِ بأمورِ الدّينِ وبشائرِه وأحكامِه، تنشيطًا للنّفوسِ وإظهارًا للرّحمةِ بها ودليلًا على العنايةِ بها.
وللتّأْكيدِ أدواتٌ مِنْها: التّاْكيدُ بِالجُمْلَةِ البسيطَةِ، وبِتكريرِ اللّفظِ، وبالحُروفِ مِثْلِ "إنّ" و"نونِ التّوْكيدِ" وأدواتِ القَصْرِ، وبأُسْلوبِ القسَمِ، وغيْرِها...:
- أُسْلوبُ التَّأْكيدِ:
قالَ صاحِبُ كِتابِ "الطِّراز": "اعْلمْ أنّ التّأْكيدَ تمْكينُ الشّيْءِ في النّفْسِ وتقْوِيَةُ أمْرِه، وفائِدَتُه إزالَةُ الشُّكوكِ وإماطةُ الشُّبُهاتِ عمّا أنْتَ بِصَدَدِه، وهو دَقيقُ المأْخَذِ كَثيرُ الفَوائِدِ، ولَه مجْرَيانِ:
- المجْرى الأوّل عامٌّ، وهُو ما يتعلّقُ بالمَعاني الإعْرابِيّة، وينْقَسِمُ إلى لَفْظِيّ ومعْنَويٍّ...
- والمجْرى الثّاني خاصٌّ يتعلَّقُ بِعُلومِ البَيانِ، ويُقالُ التَّكْريرُ أَيْضًا" [1] .
وما مِنْ نَصٍّ من نُصوصِ الحَديثِ النّبَوِيّ إلاّ وفيه تأْكيدٌ لفِكْرَةٍ أو مَبْدَأ أو قاعِدَةٍ من القَواعِدِ بِأداةٍ من أدواتِ التّأْكيدِ؛ وذلِك لأنّ الاهْتِمامَ بِمُخاطَبَةِ النّاس، وانْفِعالَ المُتَكَلِّمِ بالمعْنى الذي يُبَلِّغُه، يَسْتَوْجِبُ ضَرْبًا من التّأْكيدِ، وتطْرأُ مواقِفُ يلْجَأُ فيها المتكلّمُ إلى إشباعِ المعنى وتوكيدِه وتكريرِه، دونَ الخُروجِ عن جادّةِ الاخْتِصارِ والإيجاز. ويتَّخِذُ التّأْكيدُ في نُصوصِ الحَديثِ ألْوانًا وأضْرُبًا، وذلِكَ بِحَسَبِ حالَةِ المُخاطَبِ في خُلُوِّ الذِّهْنِ أو الاسْتِشْرافِ والطَّلَبِ، أو الشَّكِّ، أو الإنْكارِ... ويدُلُّ ذلِكَ على أنّ الحَديثَ نَصٌّ لُغَوِيٌّ يَلْفظُه قائِلٌ، هوَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، ويُوَجَّهُ إلى مُخاطَبٍ، في ظُروفٍ مُعيَّنةٍ، /14 هيَ "أسْبابُ وُرودِ الحَديثِ"، فَتَكونُ مُراعاةُ المُتكلِّمِ للمُخاطَبِ وسِياقِ القَولِ [ ص: 102 ] مِن بابِ مُطابَقَةِ المقالِ لِمُقْتَضى الحالِ؛ إذْ يُخبَرُ كلُّ شخصٍ بما هو الأفضلُ في حقِّه، وما يتنـزَّلُ منزلةَ الدّواءِ الأصلحِ له [2] ، أو لأنّ نزولَ الأحكامِ مفترِقَةً أيسرُ على المكلَّفِ من أن تكونَ جملَةً واحدةً، وهو من اللّطفِ بالعبادِ، أو لأنّ في دوامِ تعميرِ الأوقاتِ بالأخبارِ المتعلّقةِ بأمورِ الدّينِ وبشائرِه وأحكامِه، تنشيطًا للنّفوسِ وإظهارًا للرّحمةِ بها ودليلًا على العنايةِ بها.
وللتّأْكيدِ أدواتٌ مِنْها: التّاْكيدُ بِالجُمْلَةِ البسيطَةِ، وبِتكريرِ اللّفظِ، وبالحُروفِ مِثْلِ "إنّ" و"نونِ التّوْكيدِ" وأدواتِ القَصْرِ، وبأُسْلوبِ القسَمِ، وغيْرِها...:
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام

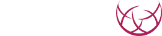








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات