من أم الناس فليخفف
هذه القاعدة ضابط في الإفتاء وما شـاكله من الخطط الشـرعية، التي يحتاج فيها إلى التقدم على الناس في أمر دينهم ودنياهم، كالإمامة والخطابة والإمارة.. إلخ، فقد ( قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شـيئا فرفق بهم، فارفق به ) [1] .
وطـلب التخفيف على الناس في إمامتهم دعت إليه الحاجة، إذ لا يخلو المجتـمع عـادة من الضـعيف والكـبير المسن والمريض والملهـوف وذي الحاجة.. إلخ، فرأف الإسلام بهؤلاء وراعى ظروفهم، بأن طلب من الإمام التخفيف فيما يتعلق بهم من أحكام وتكاليف.
لقد راعى الإسلام الفطرة البشرية المجبولة على «الضعف» والفرار من الإعنات والشدة، ولهذا جاء الإرشاد إلى التيسير على الناس والنهي من التشديد عليهم في نصوص كثيرة من السنة؛ لأن تنفيذ الأحكام مع الإعنات والتشـديد لا يسـتقيم لمنافاته الفطرة البشرية، ( فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، قـال: قـال رجل: يا رسـول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضـب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشـد غضبا منه يومئذ، ثم قـال: يا أيها الناس، إن منكم منـفرين، فمن أم الناس فليتجـوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة ) [2] . وهو الأصل في هذه القاعدة. [ ص: 75 ] وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم ، ومن بعدهم من التابعين بإحسان هذا المعنى، فكان شعارهم فيما يطلع عليه الناس من أعمالهم: «إنا أئمة» خشـية أن يقتدى بهم، أو يحمـل عنهم ما فعـلوه على غير وجهه، وهذا ما نقرؤه في هذا النموذج:
" عن مصـعب بن سـعد قال: كان أبي إذا صلى في المسـجد تجوز وأتم الركوع والسجود، وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة، قلت: يا أبتاه، إذا صليت في المسجد جوزت وإذا صليت في البيت أطلت؟ قال: يا بني إنا أئمة يقتدى بنا " [3] .
والتزام المفتي للتوسط في فتياه إنما هو في حق المستفتين وجمهور الناس، وأما هو في خاصة نفسـه فقد يسـوغ له أن يحمل نفسه ما هو فوق الوسط، بشـرط ألا يظهره خشية أن يقتدى به، وهو معنى نفيس نبه عليه الشاطبي ، رحمه الله [4] . [ ص: 76 ]
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- كتاب الأمة


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام





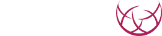








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات