
الإنسان من حيث هو إنسان، تكفلت الشريعة بحماية حياته، وحرمت الاعتداء على ماله وعرضه، فالإنسان في شريعة الله مجردا عن كل الاعتبارات العرقية والدينية والاجتماعية مصانة حقوقه عن الإهدار، وإنما يصبح الإنسان تحت طائلة العقوبة في الشريعة الإسلامية حين يتصف بصفات تنتقص من إنسانيته، وحين يتردى في دركات الحيوانية، وسفول الشذوذ والبهيمية، فيضع نفسه في مواجهة الفطرة ومعاندة الحقيقة، والإسلام وإن كان يدعو الناس للإيمان، لكنه في الإطار العام يدعو للاحتفاظ بالإنسانية كحد أدنى لاستمرار الحياة بتوازن وسلام.
ويدل على ذلك حرص الشريعة على عصمة دم الإنسان ولو كان غير مسلم، وهو مستفاد من عموم النصوص التي زجرت عن الظلم والعدوانية عموما، ولمزيد من العناية ورد في السنة النبوية وعيد شديد اللهجة في حق من يتسور هذه الحرمة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»، رواه البخاري.
وذلك أنه ربما ظن بادي الرأي أن غير المسلم لا حرمة لدمه، وأنه يستحق القتل لمجرد كفره، فجاءت السنة بهذا الوضوح الحازم، للرد على هذا الظن الخاطئ، مؤكدا بذلك النص النبوي على عالمية هذا الدين، وقبوله بالعيش الإنساني المشترك، وفق نظام عادل يضمن الحياة الآمنة للجميع.
وذلك أنه ربما ظن بادي الرأي أن غير المسلم لا حرمة لدمه، وأنه يستحق القتل لمجرد كفره، فجاءت السنة بهذا الوضوح الحازم، للرد على هذا الظن الخاطئ، مؤكدا بذلك النص النبوي على عالمية هذا الدين، وقبوله بالعيش الإنساني المشترك، وفق نظام عادل يضمن الحياة الآمنة للجميع.
وأيضا حرمة ماله، فلا يحل أخذ ماله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وقد ورد أيضا في قصة المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود: " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".رواه البخاري، وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال الحافظ ابن حجر: قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. انتهى.
فالحربي المعادي للإسلام أهدر حرمة ذاته بانتقاص إنسانيته، ومحاربة فطرته وبشريته، فهو إذن قد غادر دائرة الأمان، بمعاداة هذا الدين والصد عنه، جهلا منه بحقيقة الرحمة التي يضمنها له الإسلام، فهو الساعي في إهدار حقه في العيش المشترك، بعدوانيته على الإسلام الذي يمنح الإنسان حقوقه الكاملة.
وحتى المسلم حين يعتدي على حياة الآخرين أو أموالهم وأعراضهم، هو يتصف بعدوانية لا تتوافق مع القيم الإنسانية، وهنا يكون في مواجهة مباشرة مع الشريعة التي ترعى الحقوق، وتحارب الظلم من أي أحد كان، ولذلك ينزل به العقوبة وفق شروطها المقررة.
ومما يدل على الاهتمام بمبدأ الإنسانية في السنة النبوية الوصايا العسكرية للمقاتلين إذا تهيأوا للخروج، تذكيرا لهم بقيمة الإنسان ولو كان كافرا، وتحديد مهمتهم في دفع ظلم المعتدي، وإزاحة المتجبرين الحائلين بين الله وبين عباده، فليس المقصود هو القتال لذات القتال، أو لمجرد عدم دخولهم في الدين، فينهاهم عن قتل النساء والصبيان، والشيوخ، والرهبان في صوامعهم، لأن الموجب لقتالهم ليس مجرد كفرهم، وإنما ما فعلوه من الاعتداء، والحيلولة بين الناس وبين مراد الله منهم، ففي سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك، أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} " [البقرة: 195]، فالإنسان غير المقاتل باق على الأصل، وإنما استثني المقاتل لجرمه.
ومن التكريم للإنسان الميزة الغائية لوجوده، فهو مكرم على من سواه من المخلوقات بغاية الوجود، فينمو داخله الشعور بالقيمة الوجودية لذاته، ولذلك حرمت الشريعة اعتداء الإنسان على ذاته بإزهاق الروح استعجالا للموت؛ لأن هذا تعدٍّ على مبدأ الغائية التي كرمت بها النفس الإنسانية، كما في حديث ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به» رواه أحمد وغيره.
ومما يعزز هذا المعنى ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: «أليست نفسا».
وحين يقرر العلماء كليات الإسلام التي احتفَت الشريعة بالحفاظ عليها من جانب الطلب؛ وهو ما يتحقق به المقصد ابتداء، وجانب الدفع؛ وهو ما يحفظ به المقصد عند تعرضه للخطر؛ فهم يقررون حفظ كلية النفس مثلا بمفهوم النفس الكلي، أي: باستغراق النفس البشرية من حيث هي نفس منفوسة خلقها الله تعالى، ولا يخرج عن هذا الأصل لأي اعتبار من عرق أو جنس، أو دين، وإنما بحسب اعتبارات محددة، ومسوغات معقولة المعنى، كمن اختار أن يكون معتديا على غيره، أو معاديا حائلا بين الناس وبين الدين، ومع ذلك فليس كل أحد مخولا بإنفاذ هذا الاستثناء، إنما له نظامه ومرجعيته المقررة في كتب الفقه الإسلامي ومدوناته.
فالشريعة الإسلامية عززت من قيم الوجود الإنساني، والمحافظة على المشتركات الإنسانية وفق مراد الله تعالى، ويتجلى ذلك من خلال "وثيقة المدينة"، وهي وثيقة الإنسانية دون منافس، حيث يظهر من بنودها أن الشريعة الإسلامية حين تكون الحاكمة في الأرض، فإنها تضمن للوجود الإنساني حقه في العيش، وممارسة النشاطات الإنسانية غير المعادية، وفق معايير عادلة ومعقولة، فقد ورد في نص تلك الوثيقة التي تواردت على نقلها المصادر التأريخية: "وإنَّ ذمة الله واحدةٌ، يُجير عليهم أدناهم، وإنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعضٍ دون النَّاس، وإنَّـه مَنْ تبعنا من يهود، فإنَّ لـه النَّصرَ، والأُسوة غير مظلوميـن، ولا متناصرٍ عليهم، وإن يهود بني عوف أمَّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه، وأَثِمَ، فإنَّـه لا يُوتِغُ إلا نفسَه، وأهلَ بيته". "لا يوتغ: أي لا يهلك"، رواه ابن اسحاق ، ونقله عنه ابن كثير وقال: كذا أورده ابن إسحاق بنحوه، وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يطول.(السيرة النبوية لابن كثير).
ولذلك فإن أولوية رسالة المسلمين اليوم إلى مجتمعهم البشري هي الحفاظ على إنسانية الإنسان، والعودة به من دركات الحيوانية الموغلة في الماديات والشهوات إلى دائرة الإنسانية، ورتبة الآدمية، ومن ثم الدعوة إلى الإيمان بالله، ذلك أن الجاهلية المعاصرة سلبت كل خصاص الآدمية، وامتهنت الإنسان، وانتقصت من إنسانيته، بحيث حولته إلى مخلوق منتكس الفطرة في غرائزه، وأفكاره، وسلوكه، فأوصلته إلى تيه الإلحاد، وروجت له المثلية، وأغرته بالإباحية، وأغرقته في المادية، فلم يعد للقيم الإنسانية وجود يصلح البناء عليه، بل تنكر البشر لمشتركاتهم التي جاء الإسلام لتعزيزها.
ولذلك فإن أولوية رسالة المسلمين اليوم إلى مجتمعهم البشري هي الحفاظ على إنسانية الإنسان، والعودة به من دركات الحيوانية الموغلة في الماديات والشهوات إلى دائرة الإنسانية، ورتبة الآدمية، ومن ثم الدعوة إلى الإيمان بالله، ذلك أن الجاهلية المعاصرة سلبت كل خصاص الآدمية، وامتهنت الإنسان، وانتقصت من إنسانيته، بحيث حولته إلى مخلوق منتكس الفطرة في غرائزه، وأفكاره، وسلوكه، فأوصلته إلى تيه الإلحاد، وروجت له المثلية، وأغرته بالإباحية، وأغرقته في المادية، فلم يعد للقيم الإنسانية وجود يصلح البناء عليه، بل تنكر البشر لمشتركاتهم التي جاء الإسلام لتعزيزها.



 فتاوى الحج
فتاوى الحج مقالات الحج
مقالات الحج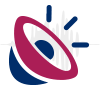 تسجيلات الحج
تسجيلات الحج استشارات الحج
استشارات الحج

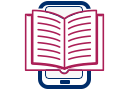












 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات