الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يرضيه عنا، وأن يشرح صدورنا للحق حيث كان، وبداية نحب أن نعلق على قول السائل: أغلب الشيوخ أصبحوا منافقين! فإن هذا الحكم إما أن تقوم عليه بينة؛ وإلا فهو تقول بلا علم، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء: 36}.
ونحن لا نشك في وقوع بعض المنتسبين للعلم والدين في النفاق، ولكن لا يصح الحكم بذلك على أغلبهم دون بينة، وقد قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري.
فالعلماء إما أن يستقيموا على مقتضى العلم؛ فيكونوا من السابقين، وإلا صار العلم حجة عليهم، وأصبحوا أسوأ حالا من الجهال، قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: في هذا الحديث من الفقه أن القارئ إذا استقام فإنه يسبق غيره سبقًا بعيدًا، فلا يدرك شأوَه غيرُه، وأنه إن أخذ عن القرآن وحدوده يمينًا وشمالًا مع كونه هو له مبلغًا ومن جملة حملته، فقد ضل ضلالًا بعيدًا، إذ الهدى كله فيما هو حامله، فإذا أخذ عنه يمينًا وشمالًا فقد سلب الهدى وضل ضلالًا بعيدًا. اهـ.
ومما يدل على حصول هذا الانحراف الخطير في بعض المنتسبين للعلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني.
قال الصنعاني في التنوير: ليس المراد هنا نفاق الشرك، بل نفاق العمل، وهو التصنع ببعض الأعمال الدينية لنيل الدنيا، وهذا واقع في القراء المتصلين بأهل الدنيا وملوكها، الطالبين لما في أيديهم، والوعيد في الأحاديث على ذلك كثير، وليس المراد كل القراء. اهـ.
وقال المناوي في فيض القدير: أي الذين يتأولونه على غير وجهه، ويضعونه في غير مواضعه، أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون خلافه، فكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ذكره ابن الأثير، وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرياء، لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن. انتهى.
وعلى أية حال، فوقوع مثل ذلك لا يعني غياب الصلاح والاستقامة من أهل العلم والدين، وإنما يعني أن مجرد هذه النسبة لا يغني عن صاحبها شيئا ما لم يقم بحقها من الإخلاص والعمل الصالح، فالخير في هذه الأمة باق إلى آخر الزمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
وإنما نقول ذلك لإثبات أن حجة الله تعالى لازالت قائمة على الناس، بوجود معالم رسالة الإسلام ووحيه المعصوم، والمبلغين له، والداعين إليه، والقائمين عليه، والذابين عنه، ممن لهم حظ وافر من قوله تعالى: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ {الأعراف: 181}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي، وصححه الألباني.
وأما ما ذكرته في سؤالك فقد يتجه السؤال عنه إذا كان الغرض من إرسال الرسل هو إهلاك المكذبين ومعاقبة المخالفين، ولكن الغرض من ذلك هو الدعوة والبلاغ وبيان الحق الذي يبشر المؤمنين وينذر المعرضين، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وتقوم به حجة الله البالغة، قال تعالى: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء: 165}.
وقال سبحانه: الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ {إبراهيم: 1}.
وقال عز وجل: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ {الحديد: 9}.
وإلا فأنت تعلم كيف قابل أهل مكة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإعراض والتكذيب والتنكيل، حتى اجتهدوا في قتله، وأخرجوه من بلده، وحاربوه عند هجرته، ومع ذلك لم يهلكم الله تعالى، بل فتح لهم باب الرحمة والتوبة، فعن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك! قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم، قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل باب التوبة والرحمة. رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال المنذري: ورواته رواة الصحيح ـ وصححه أحمد شاكر والألباني.
وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما ما حصل في غزوة أحد: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ {آل عمران: 128}.
قال السعدي: لما جرى يوم أحد ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب، رفع الله بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله: ليس لك من الأمر شيء ـ إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدع عليهم، بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم، فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل، وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام ـ رضي الله عنهم ـ وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره. اهـ.
والمقصود أن مجرد إهلاك المكذبين لا يصح أن يعلل به إرسال الرسل، وتناط به الحكمة من ذلك، وإنما هو البلاغ والبيان، والدعوة، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإقامة حجة الله على الناس، وهذا قد حصل على وجه التمام والكمال بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم الذي هو الحجة الباقية إلى آخر الزمان، يقوم به من بعده صلى الله عليه وسلم طائفة من أمته، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في رسالته: ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة: إذا تتبعنا آي القرآن بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من أمم الأرض، علمنا أن هذه الأسباب أربعة :
1ـ كانت هذه الأمة ما جاءها من الله نبي من قبل، ولا كان لتعاليم نبي مبعوث في أمة غيرها أن تصل إليها .
2ـ كان قد أرسل إليها نبي من قبل، ولكن كان تعليمه قد انمحى أو لعبت به يد النسيان أو التحريف حتى لم يعد بإمكان الناس أن يتبعوه اتباعا كاملا صحيحا .
3ـ كان قد أرسل إليها نبي من قبل، ولكن تعاليمه ما كانت كاملة ولا هدايته كانت شاملة ـ يعني لمتطلبات ما تلاه من العصور ـ فألحت الحاجة إلى المزيد من الأنبياء لإكمال الدين .
4ـ كان قد أرسل إليها نبي، ولكن كانت الحاجة تقتضي أن يرسل معه نبي آخر لتصديقه وتأييده .
وكل سبب من هذه الأسباب الأربعة قد زال بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للأمة الإسلامية ولا لأية أمة أخرى في العالم، إلى أن يرسل إليها نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد تولى القرآن بنفسه بيان أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الناس كافة ولهداية الدنيا كلها : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ـ وأيضا مما يدل عليه تاريخ الحضارة في الدنيا أن الظروف في العالم مازالت منذ بعثته صلى الله عليه وسلم ولا تزال مهيأة بحيث من الممكن أن تصل دعوته إلى كل صقع من أصقاع العالم، وإلى كل أمة من أممه، فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من أمم الدنيا أو صقع من أصقاعها، فبذلك قد زال السبب الأول ، ومما يشهد به القرآن كذلك وتؤيده عليه ذخيرة كتب الحديث والسيرة أن التعليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا محفوظا على صورته الحقيقية ولم تلعب به يد النسيان ولا التحريف والتبديل ، أما الكتاب الذي جاء به، فما وقع التحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه، ولا من الممكن أن يقع إلى يوم القيامة ، وأما الهداية التي أعطاها للناس بأقواله وأفعاله، فإننا نجد آثارها حتى اليوم حية مصونة، كأننا أمام شخصه صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، فبذلك قد زال السبب الثاني أيضا ، ثم إن القرآن ليصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك قد زال السبب الثالث أيضا ، ثم إن الحاجة لو كانت تقتضي إرسال نبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتأييده وتصديقه لأرسل في زمانه صلى الله عليه وسلم، فبذلك قد زال السبب الرابع أيضا.. فأي سبب خامس من بعد زوال هذه الأسباب الأربعة عسى أن يقتضي بعثة نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قيل إن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد!! قلنا: هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ إن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه، ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة أو إكمال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل، فلما قد قضيت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم فلم تبق الحاجة الآن إلى الأنبياء، وإنما هي إلى المصلحين. انتهى.
وأخيرا ندعو الأخ السائل لتدبر هاتين الآيتين: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ {الرعد: 31}.
قال السعدي: يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا ـ من الكتب الإلهية: سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ـ عن أماكنها: أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأرْضُ ـ جنانا وأنهارا: أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ـ لكان هذا القرآن: بَلْ لِلَّهِ الأمْرُ جَمِيعًا ـ فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته، فمابال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ـ فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء، ويضل من يشاء: وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ على كفرهم، لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منها، وهم مصرون على كفرهم: حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ـ الذي وعدهم به، لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه: إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ـ وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم.
والآية الثانية: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ {التوبة: 126}.
قال السعدي: قال تعالى موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ـ بما يصيبهم من البلايا والأمراض، وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم: ثُمَّ لا يَتُوبُونَ ـ عما هم عليه من الشر: وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ـ ما ينفعهم، فيفعلونه، وما يضرهم، فيتركونه، فالله تعالى يبتليهم ـ كما هي سنته في سائر الأمم ـ بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 162017.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

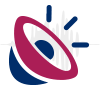
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات