الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكرك على تواصلك معنا، ونهنئك بالاشتغال بالعلم الشرعي، ونسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يتقبل منك، وأن يثبتك على الحق ويوفقك للمزيد من الخير والعمل الصالح، وننصحك بالبعد عن الخوض في القدر، عملاً بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني وصححه الألباني.
كما ننصحك بالحرص على التخلص من الخطرات النفسية والشيطانية الشريرة، فعليك بالتعوذ منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، فيقول كما في حديث مسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. وقد سأله أبو بكر فقال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
واحرصي على المزيد من التعلم انطلاقا من نصوص الشرع لا من الشبهات، والاستشكالات. فهذا الإشكال مثل قول البعض: لماذا خلق الله الكفار وأعطاهم القدرة على الكفر والظلم، وعذبهم عليها؟ والجواب على هذا أن تعلمي أن الكون كله ملك لله تعالى يفعل فيه ما يشاء، فيخلق ما يشاء، ويهب لمن يشاء ما يشاء، وأنه سبحانه أرسل الرسل لبيان طريق الهدى، والترغيب فيها، وبيان طريق الشر والتحذير منها، وأنه وهب عباده أهلية سلوك طريقي الخير والشر، وأنه يحاسبهم ويثيبهم، أو يعاقبهم على اختيارهم وأعمالهم، وأنه لا يحاسب العبد إلا على فعله وكسبه، وتصرفه واختياره، فالله تعالى قد أعطى عبده عقلاً وسمعاً، وإدراكاً وإرادة ليعرف الخير من الشر، والضار من النافع، وأعطاه إرادة ومشيئة، واستطاعة واختياراً، وقدرة على العمل بما شاء، تحت مشيئته وقدرته، وجعل فيه قابلية الخير والشر ليختار الطريق التي يفضلها، كما قال الله تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا {الشمس:8}.
وجعله ميسرا لما خلق له من الأعمال التي هي سبب لذلك؛ ففي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة . قال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاوة؟ قال : أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. رواه البخاري.
وقال ابن القيم رحمه الله: فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير الحمد والعلم، والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب، وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه، وطبعه، وموجبها، فصدر منه موجب الجهل، والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به، وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه، وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده، ويوفقه، ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل، ويليق به، ويثمر به، ويزكو به، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين {الأنعام:53}. فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها.... والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه، ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا، وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد، ومنه السبب والمسبب، ومن اعترض بقوله: فهلا جعل المحال كلها كذلك، وجعل القلوب على قلب واحد؟ فهو من أجهل الناس، وأضلهم وأسفههم، وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الأضداد، وهلا جعلها كلها سببا واحدا، فلم خلق الليل والنهار، والفوق والتحت، والحر والبرد، والدواء والداء، والشياطين والملائكة، والروائح الطيبة، والكريهة والحلو والمر، والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله، وفساد عقله؟... إلخ كلامه ـ رحمه الله ـ . اهـ.
وقال ابن قدامة- رحمه الله تعالى- في لمعة الاعتقاد: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يتجاوز ما خُط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته؛ قال الله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. وقال تعالى: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وقال تعالى: فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا... ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره، واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن بأن الله أقام علينا الحجة بإنزال الكتب، وبعثه الرسل؛ قال الله تعالى: لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحداً على معصية، ولا اضطره إلى ترك طاعة؛ قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وقال تعالى: الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يُجزى على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. انتهى.
وفي الإبانة الكبرى لابن بطة: لا ينبغي لأحد أن يتفكر ويضمر في نفسه لم ترك الله العباد حتى يجحدوه، ويشركوا به، ويعصوه، ثم يعذبهم على ذلك وهو قادر على هدايتهم، وهو قادر أن يمنع قلوبهم أن تدخلها شهوة شيء من معصيته، أو محبة شيء من مخالفته، وهو القادر على أن يبغّض إلى الخلق أجمعين معصيته ومخالفته، وقادر على أن يهلك من همَّ بمعصيته مع همته، وهو قادر على أن يجعلهم كلهم على أفضل عمل عبد من أوليائه، فلم لم يفعل ذلك؟ فمن تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع المشركين من أن يشركوا به، ولم يمنع القلوب أن يدخلها حب شيء من معصيته، ولم يهد العباد كلهم فقد كفر، ومن قال: إن الله أراد هداية الخلق وطاعتهم له، وأراد أن لا يعصيه أحد، ولا يكفر أحد، فلم يقدر، فقد كفر. ومن قال: إن الله قدر على هداية الخلق، وعصمتهم من معصيته ومخالفته، فلم يفعل ذلك، وهو جور من فعله، فقد كفر. وهذا مما يجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الخوض فيه، والمسألة عنه، وهو أن يعلم العبد أن الله عز وجل خلق الكفار وأمرهم بالإيمان، وحال بينهم وبين الإيمان، وخلق العصاة وأمرهم بالطاعة، وجعل حب المعاصي في قلوبهم، فعصوه بنعمته، وخالفوه بما أعطاهم من قوته، وحال بينهم وبين ما أمرهم به، وهو يعذبهم على ذلك، وهم مع ذلك ملومون غير معذورين، والله عز وجل عدل في فعله ذلك بهم، وغير ظالم لهم، ولله الحجة على الناس جميعاً، له الخلق والأمر تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا من علم القدر الذي لا يحل البحث عنه، ولا الكلام فيه، ولا التفكير فيه، وبكل ذلك مما قد ذكرته، وما أنا ذاكره، نزل القرآن، وجاءت السنة، وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه، لا يرد ذلك ولا ينكره إلا قدري خبيث، مشؤوم قد زاغ قلبه، وألحد في دين الله وكفر بالله، وسأذكر الآيات في ذلك من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.... انتهى. وراجعي بقية كلام ابن بطة في الإبانة.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله تعالى؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم الكفار مكتوب عملهم في الأزل، ويكتب عمل الإنسان أيضاً عند تكوينه في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه -أربعين يوماً- ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد. فأعمال الكفار مكتوبة عند الله عز وجل، معلومة عنده، والشقي شقي عند الله عز وجل في الأزل، والسعيد سعيد عند الله في الأزل، ولكن قد يقول قائل كما قال السائل: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول: إنهم يعذبون لأنهم قد قامت عليهم الحجة، وبين لهم الطريق، فأرسلت إليهم الرسل، وأنزلت الكتب، وبين الهدى من الضلال، ورُغبوا في سلوك طريق الهدى، وحذروا من سلوك طريق الضلال، ولهم عقول، ولهم إرادات، ولهم اختيارات، ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضاً يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار، ولا نجد أحداً منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه، أو يتهاون ويتكاسل في أمر نافع له، ثم يقول: إن هذا مكتوب علي. أبداً، فكل يسعى إلى ما فيه المنفعة، فكان عليهم أن يسعوا إلى ما فيه منفعة أمور دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة في أمور دنياهم، ولا فرق بينهما بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل، عليهم الصلاة والسلام، أكثر وأعظم من بيان الأمور الدنيوية، فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم، والتي فيها سعادتهم دون أن يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم. ثم نقول: هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبداً أن أحدا أكرهه، بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختياره، فهل كان حين إقدامه على الكفر عالماً بما كتب الله له؟ والجواب: لا؛ لأننا نحن لا نعلم أن الشيء مقدر علينا إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب؛ لأنه من علم الغيب. ثم نقول له: الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان: هداية، وضلال، فلماذا لا تسلك طريق الهدية مقدراً أن الله كتبه لك؟ لماذا تسلك طريق الضلال ثم بعد أن تسكله تحتج بأن الله كتبه؟ لأننا نقول لك قبل أن تدخل هذا الطريق: هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ فسيقول: لا، ولا يمكن أن يقول: نعم، فإذا قال: لا، قلنا: إذاً لماذا لم تسلك طريق الهداية، وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك؛ ولهذا يقول الله عز وجل: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. ويقول عز وجل: فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعدة من النار، قالوا: يا رسول الله؛ ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
فهذا جوابنا على هذا السؤال الذي أورده هذا السائل، وما أكثر من يحتج به من أهل الضلال، وهو عجب منهم؛ لأنهم لا يحتجون بمثل هذه الحجة على مسائل الدنيا أبداً، بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا ما هو أنفع لهم، ولا يمكن لأحد أن يقال له: هذا الطريق الذي أمامك طريق وعر صعب، فيه لصوص، وفيه سباع، وهذا الطريق الثاني طريق سهل، ميسر آمن. لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني مع أن هذا نظير الطريقين: طريق النار، وطريق الجنة، فالرسل بينت طريق الجنة وقالت: هو هذا، وبينت طريق النار، وقالت: هو هذا، وحذرت من الثاني، ورغبت في الأول، ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره -وهم لا يعلمونه- على معاصيهم، ومعايبهم التي فعلوها باختيارهم، وليس لهم في ذلك حجة عند الله تعالى. انتهى.
هذا وينبغي التنبه إلى أن آية الإسراء قد اختلف في تفسيرها، والراجح أن الأمر الذي ورد في الآية الكريمة هو أمر بالطاعة وليس أمرًا بالفسوق والفساد، فهذا هو المعنى الصحيح الذي رجحه المحققون من أهل التفسير كالقرطبي والشنقيطي وابن كثير وغيرهم.
قال الشنقيطي: أمرناهم بالطاعة فعصوا، وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: ومَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اهـ
وقال ابن كثير في تفسيره: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ. (الآية) قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم ...
وفي أحكام القرآن للجصاص: قوله تعالى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. قال سعيد: أمروا بالطاعة فعصوا...
وقد شاء الله تعالى وأراد أن يوجد إبليس وأعوانه، والأكابر المجرمون وغيرهم من أهل المكر والكيد، وذلك لحِكَم كثيرة عظيمة سبق بيان شيء منها في الفتوى رقم: 8546
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

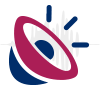
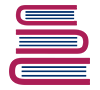
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات