[ ص: 106 ] [ ص: 107 ] من العلم ما هو من صلب العلم ، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه ، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه ، فهذه ثلاثة أقسام : .
القسم الأول : هو الأصل والمعتمد ، والذي عليه مدار الطلب ، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين ، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي ، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه ، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها ، كما قال الله تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [ الحجر : 9 ] ; لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين ، [ ص: 108 ] وهي الضروريات ، والحاجيات ، والتحسينات ، وما هو مكمل لها ، ومتمم لأطرافها ، وهي أصول الشريعة ، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها ، وسائر الفروع مستندة إليها ; فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان .
هذا وإن كانت وضعية لا عقلية ، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي ، وعلم الشريعة من جملتها ; إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها ، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة ، ثابتة غير زائلة ، ولا متبدلة ، وحاكمة غير محكوم عليها ، وهذه خواص الكليات العقليات .
وأيضا ; فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود ، وهو أمر وضعي لا عقلي ; فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار ، وارتفع الفرق بينهما .
فإذا لهذا القسم خواص ثلاث : بهن يمتاز عن غيره : إحداها : العموم والاطراد ، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق ، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى ؛ فلا عمل يفرض ، ولا حركة ، ولا سكون يدعى - إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا ، وتركيبا ، وهو معنى كونها عامة ، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما ; فهو راجع إلى عموم ; كالعرايا ، وضرب الدية على العاقلة ، والقراض ، [ ص: 109 ] والمساقاة ، والصاع في المصراة ، وأشباه ذلك ; فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها ، وهي أمور عامة ; فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة ، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك .
والثانية : الثبوت من غير زوال ; فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ، ولا تخصيصا لعمومها ، ولا تقييدا لإطلاقها ، ولا رفعا لحكم من أحكامها لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سببا ; فهو سبب أبدا لا يرتفع ، وما [ ص: 110 ] كان شرطا ; فهو أبدا شرط ، وما كان واجبا فهو واجب أبدا ، أو مندوبا فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ، ولا تبدل ، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك .
والثالثة : كون العلم حاكما لا محكوما عليه بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به ; فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه ، لا زائد على ذلك ، ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة ، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها ، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم .
فإذا ; كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث ; فهو من صلب العلم ، وقد تبين معناها ، والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب ، والحمد لله .
والقسم الثاني - وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه - : ما لم يكن قطعيا ، ولا راجعا إلى أصل قطعي ، بل إلى ظني ، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة ; فهو مخيل ، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول ، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ، ولا بمعنى غيره ، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم .
فأما تخلف الخاصية الأولى - وهو الاطراد والعموم - فقادح في جعله من صلب العلم لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح ، ويضعف جانب الاعتبار ; إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ، ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد فلا يوثق به ، ولا يبنى عليه .
وأما تخلف الخاصية الثانية - وهو الثبوت - فيأباه صلب العلم وقواعده ; [ ص: 111 ] فإنه إذا حكم في قضية ، ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا ، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص ; فعدم الناظر الوثوق بحكمه ، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم .
وأما تخلف الخاصية الثالثة - وهو كونه حاكما ومبنيا عليه - فقادح أيضا ; لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة ، غير مجرد راحات النفوس ، فاستوي مع سائر ما يتفرج به ، وإن لم يصح فأحرى في الاطراح ، كمباحث السوفسطائيين ، ومن نحا نحوهم .
ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها : أحدها : الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة ، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، وكونها على بعض الهيئات دون بعض ، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل ، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل ، والنهار ، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة ، وفي الأماكن المعروفة ، وإلى مسجد مخصوص ، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه ، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع ، وجميعها مبني على ظن [ ص: 112 ] وتخمين غير مطرد في بابه ، ولا مبني عليه عمل ، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ ، وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ، ولا دليل لنا عليه .
والثاني : تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ، ولا يطلب التزامها ، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد ، فالتزمها المتأخرون بالقصد ، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا لها ؛ بحيث يتعنى في استخراجها ، ويبحث عنها بخصوصها ، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل ، وإن صحبها العمل ; لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث ، كما في حديث : الراحمون يرحمهم الرحمن ; فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه [ ص: 113 ] التلميذ من شيخه ; فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره ؛ لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه ، [ كذا سائرها ;غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة ] ، وليس بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال : إنه مقصود ; فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه .
والثالث : التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة ، لا على قصد طلب تواتره ، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ، ومن جهات شتى ، وإن [ ص: 114 ] كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم ، فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم .
خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني ; قال : خرجت حديثا واحدا عن النبي من مائتي طريق أو من نحو مائتي طريق - شك الراوي - قال : فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل ، وأعجبت بذلك ; فرأيت يحيى بن معين في المنام ، فقلت له : يا أبا زكريا قد خرجت حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مائتي طريق . قال : فسكت عني ساعة ، ثم قال : أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر ؛ هذا ما قال . وهو صحيح في الاعتبار ; لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه ، فصار الزائد على ذلك فضلا .
والرابع : العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ، ولا نذارة ; فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات ، وما يتلقى منها تصريحا ; فإنها وإن كانت صحيحة ; فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر [ ص: 115 ] في الشريعة في مثلها ، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا ; فإن ما قال فيها يحيى بن معين صحيح ، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة ; فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام ، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا ، و على هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا .
والخامس : المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي ، إنما تعد من الملح ، كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه ، ويقع كثير منها في سائر العلوم ، وفي العربية منها كثير ، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر ، ومسألة اللهم ، ومسألة أشياء ، ومسألة الأصل في [ ص: 116 ] لفظ الاسم ، وإن انبنى البحث فيها على أصول مطردة ، ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة للاختلاف فيها ، فهي خارجة عن صلب العلم .
والسادس : الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية ، وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم ، وفي بيان مقاماتهم فينتزعون معاني الأشعار ، ويضعونها للتخلق بمقتضاها ، وهو في الحقيقة من الملح ؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع ، وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ، ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا ، وأدخلوه في أثناء وعظهم ، وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه ; فالاستشهاد بالمعنى ; فإن كان شرعيا ; فمقبول ، وإلا فلا .
والسابع : الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح ، بناء على مجرد تحسين الظن ، لا زائد عليه ; فإنه ربما تكون أعمالهم حجة ، حسبما هو مذكور في كتاب الاجتهاد ، فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسن [ ص: 117 ] الظن به ; فهو - عندما يسلم من القوادح - من هذا القسم ; لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل ، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب في عمله ، ولجواز تغيره ; فإنما يؤخذ - إن سلم - هذا المأخذ .
والثامن : كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية ; فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه ، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم ، حتى أعرضوا عن غيره جملة ، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله ، وأعربوا عن مقتضاه ، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور ، وهم إنما يكلمون به الجمهور ، وهو وإن كان حقا ; ففي رتبته لا مطلقا ؛ لأنه يصير - في حق الأكثر - من الحرج أو تكليف مالا يطاق ، بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه ، وفي حال دون حال ، فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة ، بخلاف أخذه على الجملة ; فليس على هذا من صلب العلم ، وإنما هو من ملحه ، ومستحسناته .
والتاسع : حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده ; حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر ، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي ، كما يحكى عن الفراء النحوي ; أنه قال : من برع في علم واحد سهل [ ص: 118 ] عليه كل علم . فقال له محمد بن الحسن القاضي - وكان حاضرا في مجلسه ذلك ، وكان ابن خالة الفراء - : فأنت قد برعت في علمك ، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك : ما تقول فيمن سها في صلاته ، ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا ؟
قال الفراء : لا شيء عليه .
قال : وكيف ؟
قال : لأن التصغير عندنا لا يصغر ، فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له ، لأنه بمنزلة تصغير التصغير ، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة ، والجبر لا يجبر ، كما أن التصغير لا يصغر .
فقال القاضي : ما حسبت أن النساء يلدن مثلك .
فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف ; إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي ، فيعتبر أحدهما بالآخر .
فلو جمعهما أصل واحد ; لم يكن من هذا الباب ، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد .
روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد ، والكسائي يداعبه ويمازحه ; فقال [ ص: 119 ] له أبو يوسف : هذا الكوفي قد استفرغك ، وغلب عليك .
فقال : يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي .
فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال : يا أبا يوسف هل لك في مسألة ؟
فقال : نحو أم فقه .
قال : بل فقه .
فضحك الرشيد حتى فحص برجله ، ثم قال : تلقي على أبي يوسف فقها ؟
قال : نعم . قال : يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار ، وفتح أن ؟
قال : إذا دخلت طلقت .
قال : أخطأت يا أبا يوسف .
فضحك الرشيد ، ثم قال : كيف الصواب ؟
قال : إذا قال أن فقد وجب الفعل ، ووقع الطلاق ، وإن قال إن فلم يجب ، ولم يقع الطلاق .
قال : فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي .
[ ص: 120 ] فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين .
فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر ; فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي ; فيقطع فيها عمره ، وليس وراءها ما يتخذ معتمدا في عمل ولا اعتقاد ، فيخيب في طلب العلم سعيه ، والله الواقي .
ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ : أن أبا العباس بن البناء سئل فقيل له : لم لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى : إن هذان لساحران الآية [ طه : 63 ] ؟
فقال في الجواب : لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول .
فقال السائل : يا سيدي ، وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في النبيين ؟
فقال له المجيب : يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها ; فأنت تريد أن تحكها بين يديك ، ثم تطلب منها ذلك الرونق - أو كلاما هذا معناه -
فهذا الجواب فيه ما ترى ، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم .
والقسم الثالث : وهو ما ليس من الصلب ، ولا من الملح - : ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني ، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال [ ص: 121 ] مما صح كونه من العلوم المعتبرة ، والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات ، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة ، فهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال فهو غير ثابت ، ولا حاكم ، ولا مطرد أيضا ، ولا هو من ملحه ؛ لأن الملح هي التي تستحسنها العقول ، وتستملحها النفوس ; إذ ليس يصحبها منفر ، ولا هي مما تعادي العلوم ; لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة بخلاف هذا القسم ; فإنه ليس فيه شيء من ذلك .
هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه ; فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله ، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل ، فمالوا إليه من ذلك الوجه ، وحقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له ، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء ، كالإغراب باستجلاب غير المعهود ، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون ، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص . . . ، وأنهم من الخواص ، وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ، ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان حسبما بينه الغزالي ، وابن العربي ، ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما .
ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره ، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ، ولا سبيل إلى نيله بعقل ، ولا نظر ، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام ، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى [ ص: 122 ] علم الحروف ، وعلم النجوم ، ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع ; فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية ، حتى آل ذلك إلى مالا يعقل على حال ، فضلا عن غير ذلك ، ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون ، وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ، [ ص: 123 ] ولا ثمرة تجنى منه ، فلا تعلق به بوجه .
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
 صفحة
106
صفحة
106
 جزء
1
جزء
1
[ ص: 106 ] [ ص: 107 ] nindex.php?page=treesubj&link=18466مِنَ الْعِلْمِ مَا هُوَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُلَحُ الْعِلْمِ لَا مِنْ صُلْبِهِ ، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ مِنْ صُلْبِهِ وَلَا مُلَحِهِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : .
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : هُوَ الْأَصْلُ وَالْمُعْتَمَدُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الطَّلَبِ ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي مَقَاصِدُ الرَّاسِخِينَ ، وَذَلِكَ مَا كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ رَاجِعًا إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ ، وَالشَّرِيعَةُ الْمُبَارَكَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مَنَزَّلَةٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [ الْحِجْرِ : 9 ] ; لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الْمَقَاصِدِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ صَلَاحُ الدَّارَيْنِ ، [ ص: 108 ] وَهِيَ الضَّرُورِيَّاتُ ، وَالْحَاجِيَّاتُ ، وَالتَّحْسِينَاتُ ، وَمَا هُوَ مُكَمِّلٌ لَهَا ، وَمُتَمَّمٌ لِأَطْرَافِهَا ، وَهِيَ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ الْقَطْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا ، وَسَائِرُ الْفُرُوعِ مُسْتَنِدَةٌ إِلَيْهَا ; فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهَا عِلْمٌ أَصِيلٌ رَاسِخُ الْأَسَاسِ ثَابِتُ الْأَرْكَانِ .
هَذَا وَإِنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لَا عَقْلِيَّةً ، فَالْوَضْعِيَّاتُ قَدْ تُجَارِي الْعَقْلِيَّاتِ فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ ، وَعِلْمُ الشَّرِيعَةِ مِنْ جُمْلَتِهَا ; إِذِ الْعِلْمُ بِهَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الِاسْتِقْرَاءِ الْعَامِّ النَّاظِمِ لِأَشْتَاتِ أَفْرَادِهَا ، حَتَّى تَصِيرَ فِي الْعَقْلِ مَجْمُوعَةً فِي كُلِّيَّاتٍ مُطَّرِدَةٍ عَامَّةٍ ، ثَابِتَةٍ غَيْرِ زَائِلَةٍ ، وَلَا مُتَبَدِّلَةٍ ، وَحَاكِمَةٍ غَيْرِ مَحْكُومٍ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ خَوَاصُّ الْكُلِّيَّاتِ الْعَقْلِيَّاتِ .
وَأَيْضًا ; فَإِنَّ الْكُلِّيَّاتِ الْعَقْلِيَّةَ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْوُجُودِ ، وَهُوَ أَمْرٌ وَضْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ ; فَاسْتَوَتْ مَعَ الْكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ، وَارْتَفَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا .
فَإِذًا لِهَذَا الْقِسْمِ خَوَاصٌّ ثَلَاثٌ : بِهِنَّ يَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهِ : إِحْدَاهَا : الْعُمُومُ وَالِاطِّرَادُ ، فَلِذَلِكَ جَرَتِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهَا الْخَاصَّةُ لَا تَتَنَاهَى ؛ فَلَا عَمَلَ يُفْرَضُ ، وَلَا حَرَكَةَ ، وَلَا سُكُونَ يُدَّعَى - إِلَّا وَالشَّرِيعَةُ عَلَيْهِ حَاكِمَةٌ إِفْرَادًا ، وَتَرْكِيبًا ، وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهَا عَامَّةٌ ، وَإِنْ فُرِضَ فِي نُصُوصِهَا أَوْ مَعْقُولِهَا خُصُوصٌ مَا ; فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى عُمُومٍ ; كَالْعَرَايَا ، وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقِرَاضِ ، [ ص: 109 ] وَالْمُسَاقَاةِ ، وَالصَّاعِ فِي الْمُصَرَّاةِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ; فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أُصُولٍ حَاجِيَّةٍ أَوْ تَحْسِينِيَّةٍ أَوْ مَا يُكَمِّلُهَا ، وَهِيَ أُمُورٌ عَامَّةٌ ; فَلَا خَاصَّ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا وَهُوَ عَامٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَالِاعْتِبَارُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ .
وَالثَّانِيَةُ : الثُّبُوتُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ ; فَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ فِيهَا بَعْدَ كَمَالِهَا نَسْخًا ، وَلَا تَخْصِيصًا لِعُمُومِهَا ، وَلَا تَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِهَا ، وَلَا رَفْعًا لِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا لَا بِحَسَبِ عُمُومِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَلَا بِحَسَبِ خُصُوصِ بَعْضِهِمْ ، وَلَا بِحَسَبِ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، وَلَا حَالٍ دُونَ حَالٍ ، بَلْ مَا أُثْبِتَ سَبَبًا ; فَهُوَ سَبَبٌ أَبَدًا لَا يَرْتَفِعُ ، وَمَا [ ص: 110 ] كَانَ شَرْطًا ; فَهُوَ أَبَدًا شَرْطٌ ، وَمَا كَانَ وَاجِبًا فَهُوَ وَاجِبٌ أَبَدًا ، أَوْ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ فَلَا زَوَالَ لَهَا ، وَلَا تَبَدُّلَ ، وَلَوْ فُرِضَ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ لَكَانَتْ أَحْكَامُهَا كَذَلِكَ .
وَالثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=18470كَوْنُ الْعِلْمِ حَاكِمًا لَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُفِيدًا لِعَمَلٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِمَّا يَلِيقُ بِهِ ; فَلِذَلِكَ انْحَصَرَتْ عُلُومُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يُفِيدُ الْعَمَلَ أَوْ يُصَوِّبُ نَحْوَهُ ، لَا زَائِدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا تَجِدُ فِي الْعَمَلِ أَبَدًا مَا هُوَ حَاكِمٌ عَلَى الشَّرِيعَةِ ، وَإِلَّا انْقَلَبَ كَوْنُهَا حَاكِمَةً إِلَى كَوْنِهَا مَحْكُومًا عَلَيْهَا ، وَهَكَذَا سَائِرُ مَا يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ .
فَإِذًا ; كُلُّ عِلْمٍ حَصَلَ لَهُ هَذِهِ الْخَوَاصُّ الثَّلَاثُ ; فَهُوَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مَعْنَاهَا ، وَالْبُرْهَانُ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي - وَهُوَ الْمَعْدُودُ فِي مُلَحِ الْعِلْمِ لَا فِي صُلْبِهِ - : مَا لَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا ، وَلَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ ، بَلْ إِلَى ظَنِّيٍّ ، أَوْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى قَطْعِيٍّ إِلَّا أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهُ خَاصَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ خَاصَّةٍ وَاحِدَةٍ ; فَهُوَ مُخَيَّلٌ ، وَمِمَّا يَسْتَفِزُّ الْعَقْلَ بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ الْأَوَّلِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِخْلَالٌ بِأَصْلِهِ ، وَلَا بِمَعْنَى غَيْرِهِ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَحَّ أَنْ يُعَدَّ فِي هَذَا الْقِسْمِ .
فَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الْأُولَى - وَهُوَ الِاطِّرَادُ وَالْعُمُومُ - فَقَادِحٌ فِي جَعْلِهِ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ لِأَنَّ عَدَمَ الِاطِّرَادِ يُقَوِّي جَانِبَ الِاطِّرَاحِ ، وَيُضْعِفُ جَانِبَ الِاعْتِبَارِ ; إِذِ النَّقْضُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْوُثُوقِ بِالْقَصْدِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِلْمُ ، وَيُقَرِّبُهُ مِنَ الْأُمُورِ الِاتِّفَاقِيَّةِ الْوَاقِعَةِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يُوثَقُ بِهِ ، وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ .
وَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الثَّانِيَةِ - وَهُوَ الثُّبُوتُ - فَيَأْبَاهُ صُلْبُ الْعِلْمِ وَقَوَاعِدُهُ ; [ ص: 111 ] فَإِنَّهُ إِذَا حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ ، ثُمَّ خَالَفَ حَكَمُهُ الْوَاقِعَ فِي الْقَضِيَّةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَوْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَانَ حُكْمُهُ خَطَأً وَبَاطِلًا ، مِنْ حَيْثُ أَطْلَقَ الْحُكْمَ فِيمَا لَيْسَ بِمُطْلَقٍ أَوْ عَمَّ فِيمَا هُوَ خَاصٌّ ; فَعَدِمَ النَّاظِرُ الْوُثُوقَ بِحُكْمِهِ ، وَذَلِكَ مَعْنَى خُرُوجِهِ عَنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الثَّالِثَةِ - وَهُوَ كَوْنُهُ حَاكِمًا وَمَبْنِيًّا عَلَيْهِ - فَقَادِحٌ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ إِنْ صَحَّ فِي الْعُقُولِ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهِ فَائِدَةٌ حَاضِرَةٌ ، غَيْرَ مُجَرَّدِ رَاحَاتِ النُّفُوسِ ، فَاسْتُوِيَ مَعَ سَائِرِ مَا يُتَفَرَّجُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَأَحْرَى فِي الِاطِّرَاحِ ، كَمَبَاحِثِ السُّوفِسْطَائِيِّينَ ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ .
وَلِتَخَلُّفِ بَعْضِ هَذِهِ الْخَوَاصِّ أَمْثِلَةٌ يُلْحَقُ بِهَا مَا سِوَاهَا : أَحَدُهَا : الْحِكَمُ الْمُسْتَخْرَجَةُ لِمَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عَلَى الْخُصُوصِ فِي التَّعْبُدَاتِ كَاخْتِصَاصِ الْوُضُوءِ بِالْأَعْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَالصَّلَاةِ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَالْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَكَوْنِهَا عَلَى بَعْضِ الْهَيْئَاتِ دُونَ بَعْضٍ ، وَاخْتِصَاصِ الصِّيَامِ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ ، وَتَعْيِينِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فِي تِلْكَ الْأَحْيَانِ الْمُعَيَّنَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنْ أَحْيَانِ اللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، وَاخْتِصَاصِ الْحَجِّ بِالْأَعْمَالِ الْمَعْلُومَةِ ، وَفِي الْأَمَاكِنِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَإِلَى مَسْجِدٍ مَخْصُوصٍ ، إِلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ وَلَا تَطُورُ نَحْوَهُ ، فَيَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ فَيُطَرِّقُ إِلَيْهِ حِكَمًا يَزْعُمُ أَنَّهَا مَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنْ تِلْكَ الْأَوْضَاعِ ، وَجَمِيعُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنٍّ [ ص: 112 ] وَتَخْمِينٍ غَيْرِ مُطَّرِدٍ فِي بَابِهِ ، وَلَا مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ عَمَلٌ ، بَلْ كَالتَّعْلِيلِ بَعْدَ السَّمَاعِ لِلْأُمُورِ الشَّوَاذِّ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يُعَدُّ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ لِجِنَايَتِهِ عَلَى الشَّرِيعَةِ فِي دَعْوَى مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ ، وَلَا دَلِيلَ لَنَا عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : تَحَمُّلُ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ عَلَى الْتِزَامِ كَيْفِيَّاتٍ لَا يَلْزَمُ مِثْلُهَا ، وَلَا يُطْلَبُ الْتِزَامُهَا ، كَالْأَحَادِيثِ الْمُسَلْسَلَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عَلَى وُجُوهٍ مُلْتَزَمَةٍ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ ، فَالْتَزَمَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِالْقَصْدِ ، فَصَارَ تَحَمُّلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ تَحَرِّيًا لَهَا ؛ بِحَيْثُ يَتَعَنَّى فِي اسْتِخْرَاجِهَا ، وَيَبْحَثُ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَصْدَ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلٌ ، وَإِنْ صَحِبَهَا الْعَمَلُ ; لِأَنَّ تَخَلُّفَهُ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْأَسَانِيدِ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337343الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ; فَإِنَّهُمُ الْتَزَمُوا فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ حَدِيثٍ يَسْمَعُهُ [ ص: 113 ] التِّلْمِيذُ مِنْ شَيْخِهِ ; فَإِنْ سَمِعَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا أَخَذَ عَنْهُ غَيْرَهُ ؛ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الِاسْتِفَادَةَ بِمُقْتَضَاهُ ، [ كَذَا سَائِرُهَا ;غَيْرَ أَنَّهُمُ الْتَزَمُوا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّبَرُّكِ وَتَحْسِينِ الظَّنِّ خَاصَّةً ] ، وَلَيْسَ بِمُطَّرِدٍ فِي جَمِيعِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا حَتَّى يُقَالَ : إِنَّهُ مَقْصُودٌ ; فَطَلَبُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مُلَحِ الْعِلْمِ لَا مَنْ صُلْبِهِ .
وَالثَّالِثُ : التَّأَنُّقُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، لَا عَلَى قَصْدِ طَلَبِ تَوَاتُرِهِ ، بَلْ عَلَى أَنْ يُعَدَّ آخِذًا لَهُ عَنْ شُيُوخٍ كَثِيرَةٍ ، وَمِنْ جِهَاتٍ شَتَّى ، وَإِنْ [ ص: 114 ] كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْآحَادِ فِي الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَالِاشْتِغَالُ بِهَذَا مِنَ الْمُلَحِ لَا مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
خَرَّجَ nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيِّ ; قَالَ : خَرَّجْتُ حَدِيثًا وَاحِدًا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ مِائَتَيْ طَرِيقٍ - شَكَّ الرَّاوِي - قَالَ : فَدَاخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْفَرَحِ غَيْرُ قَلِيلٍ ، وَأُعْجِبْتُ بِذَلِكَ ; فَرَأَيْتُ nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا زَكَرِيَّا قَدْ خَرَّجْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ . قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ؛ هَذَا مَا قَالَ . وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّ تَخْرِيجَهُ مِنْ طُرُقٍ يَسِيرَةٍ كَافٍ فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ ، فَصَارَ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ فَضْلًا .
وَالرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=18466الْعُلُومُ الْمَأْخُوذَةُ مِنَ الرُّؤْيَا مِمَّا لَا يَرْجِعُ إِلَى بِشَارَةٍ ، وَلَا نِذَارَةٍ ; فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ بِالْمَنَامَاتِ ، وَمَا يُتَلَقَّى مِنْهَا تَصْرِيحًا ; فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً ; فَأَصْلُهَا الَّذِي هُوَ الرُّؤْيَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ [ ص: 115 ] فِي الشَّرِيعَةِ فِي مِثْلِهَا ، كَمَا فِي رُؤْيَا الْكِنَانِيِّ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا ; فَإِنَّ مَا قَالَ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ حَتَّى عَرَضْنَاهُ عَلَى الْعِلْمِ فِي الْيَقَظَةِ ; فَصَارَ الِاسْتِشْهَادُ بِهِ مَأْخُوذًا مِنَ الْيَقَظَةِ لَا مِنَ الْمَنَامِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ الرُّؤْيَا تَأْنِيسًا ، وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الِاسْتِشْهَادِ بِالرُّؤْيَا .
وَالْخَامِسُ : الْمَسَائِلُ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِيهَا فَلَا يَنْبَنِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيهَا فَرْعٌ عَمَلِيٌّ ، إِنَّمَا تُعَدُّ مِنَ الْمُلَحِ ، كَالْمَسَائِلِ الْمُنَبَّهِ عَلَيْهَا قَبْلُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَيَقَعُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي سَائِرِ الْعُلُومِ ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ مِنْهَا كَثِيرٌ ، كَمَسْأَلَةِ اشْتِقَاقِ الْفِعْلِ مِنَ الْمَصْدَرِ ، وَمَسْأَلَةِ اللَّهُمَّ ، وَمَسْأَلَةِ أَشْيَاءَ ، وَمَسْأَلَةِ الْأَصْلِ فِي [ ص: 116 ] لَفْظِ الِاسْمِ ، وَإِنِ انْبَنَى الْبَحْثُ فِيهَا عَلَى أُصُولٍ مُطَّرِدَةٍ ، وَلَكِنَّهَا لَا فَائِدَةَ تُجْنَى ثَمَرَةً لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا ، فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَالسَّادِسُ : الِاسْتِنَادُ إِلَى الْأَشْعَارِ فِي تَحْقِيقِ الْمَعَانِي الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ ، وَكَثِيرًا مَا يَجْرِي مِثْلُ هَذَا لِأَهْلِ التَّصَوُّفِ فِي كُتُبِهِمْ ، وَفِي بَيَانِ مَقَامَاتِهِمْ فَيَنْتَزِعُونَ مَعَانِيَ الْأَشْعَارِ ، وَيَضَعُونَهَا لِلتَّخَلُّقِ بِمُقْتَضَاهَا ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمُلَحِ ؛ لِمَا فِي الْأَشْعَارِ الرَّقِيقَةِ مِنْ إِمَالَةِ الطِّبَاعِ ، وَتَحْرِيكِ النُّفُوسِ إِلَى الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ ، وَلِذَلِكَ اتَّخَذَهُ الْوُعَّاظُ دَيْدَنًا ، وَأَدْخَلُوهُ فِي أَثْنَاءِ وَعْظِهِمْ ، وَأَمَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْرِ فِي نَفْسِهِ ; فَالِاسْتِشْهَادُ بِالْمَعْنَى ; فَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا ; فَمَقْبُولٌ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَالسَّابِعُ : الِاسْتِدْلَالُ عَلَى تَثْبِيتِ الْمَعَانِي بِأَعْمَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاحِ ، بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ تَحْسِينِ الظَّنِّ ، لَا زَائِدَ عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ أَعْمَالُهُمْ حُجَّةً ، حَسْبَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ ، فَإِذَا أُخِذَ ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ فِيمَنْ يُحْسَنُ [ ص: 117 ] الظَّنُّ بِهِ ; فَهُوَ - عِنْدَمَا يَسْلَمُ مِنَ الْقَوَادِحِ - مِنْ هَذَا الْقِسْمِ ; لِأَجْلِ مَيْلِ النَّاسِ إِلَى مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ صَلَاحٌ وَفَضْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ اطِّرَادِ الصَّوَابِ فِي عَمَلِهِ ، وَلِجَوَازِ تَغَيُّرِهِ ; فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ - إِنْ سَلِمَ - هَذَا الْمَأْخَذَ .
وَالثَّامِنُ : كَلَامُ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ; فَإِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ مِنْ قَبِيلِ مَا نَحْنُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَوْغَلُوا فِي خِدْمَةِ مَوْلَاهُمْ ، حَتَّى أَعْرَضُوا عَنْ غَيْرِهِ جُمْلَةً ، فَمَالَ بِهِمْ هَذَا الطَّرَفُ إِلَى أَنْ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ الِاطِّرَاحِ لِكُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ ، وَأَعْرَبُوا عَنْ مُقْتَضَاهُ ، وَشَأْنُ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ لَا يُطِيقُهُ الْجُمْهُورُ ، وَهُمْ إِنَّمَا يُكَلِّمُونَ بِهِ الْجُمْهُورَ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ; فَفِي رُتْبَتِهِ لَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ - فِي حَقِّ الْأَكْثَرِ - مِنَ الْحَرَجِ أَوْ تَكْلِيفِ مَالَا يُطَاقُ ، بَلْ رُبَّمَا ذَمُّوا بِإِطْلَاقٍ مَا لَيْسَ بِمَذْمُومٍ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، وَفِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، فَصَارَ أَخْذُهُ بِإِطْلَاقٍ مُوقِعًا فِي مَفْسَدَةٍ ، بِخِلَافِ أَخْذِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ ; فَلَيْسَ عَلَى هَذَا مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُلَحِهِ ، وَمُسْتَحْسَنَاتِهِ .
وَالتَّاسِعُ : حَمْلُ بَعْضِ الْعُلُومِ عَلَى بَعْضٍ فِي بَعْضِ قَوَاعِدِهِ ; حَتَّى تَحْصُلَ الْفُتْيَا فِي أَحَدِهَا بِقَاعِدَةِ الْآخَرِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجْتَمِعَ الْقَاعِدَتَانِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ حَقِيقِيٍّ ، كَمَا يُحْكَى عَنِ الْفَرَّاءِ النَّحْوِيِّ ; أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَرَعَ فِي عِلْمٍ وَاحِدٍ سَهُلَ [ ص: 118 ] عَلَيْهِ كُلُّ عِلْمٍ . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي - وَكَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، وَكَانَ ابْنَ خَالَةِ الْفَرَّاءِ - : فَأَنْتَ قَدْ بَرَعْتَ فِي عِلْمِكَ ، فَخُذْ مَسْأَلَةً أَسْأَلُكَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِكَ : مَا تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فَسَهَا فِي سُجُودِهِ أَيْضًا ؟
قَالَ الْفَرَّاءُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَكَيْفَ ؟
قَالَ : لِأَنَّ التَّصْغِيرَ عِنْدَنَا لَا يُصَغَّرُ ، فَكَذَلِكَ السَّهْوُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَا يُسْجَدُ لَهُ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَصْغِيرِ التَّصْغِيرِ ، فَالسُّجُودُ لِلسَّهْوِ هُوَ جَبْرٌ لِلصَّلَاةِ ، وَالْجَبْرُ لَا يُجْبَرُ ، كَمَا أَنَّ التَّصْغِيرَ لَا يُصَغَّرُ .
فَقَالَ الْقَاضِي : مَا حَسِبْتُ أَنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ مِثْلَكَ .
فَأَنْتَ تَرَى مَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ التَّصْغِيرِ وَالسَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الضَّعْفِ ; إِذْ لَا يَجْمَعُهُمَا فِي الْمَعْنَى أَصْلٌ حَقِيقِيٌّ ، فَيُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ .
فَلَوْ جَمَعَهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ ; لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، كَمَسْأَلَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ .
رُوِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ يُدَاعِبُهُ وَيُمَازِحُهُ ; فَقَالَ [ ص: 119 ] لَهُ أَبُو يُوسُفَ : هَذَا الْكُوفِيُّ قَدِ اسْتَفْرَغَكَ ، وَغَلَبَ عَلَيْكَ .
فَقَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّهُ لَيَأْتِيَنِي بِأَشْيَاءَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا قَلْبِي .
فَأَقْبَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ عَلَى أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ هَلْ لَكَ فِي مَسْأَلَةٍ ؟
فَقَالَ : نَحْوٌ أَمْ فِقْهٌ .
قَالَ : بَلْ فِقْهٌ .
فَضَحِكَ الرَّشِيدُ حَتَّى فَحَصَ بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : تُلْقِي عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِقْهًا ؟
قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ ، وَفَتَحَ أَنْ ؟
قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ طَلَقَتْ .
قَالَ : أَخْطَأْتَ يَا أَبَا يُوسُفَ .
فَضَحِكَ الرَّشِيدُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ الصَّوَابُ ؟
قَالَ : إِذَا قَالَ أَنْ فَقَدْ وَجَبَ الْفِعْلُ ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ قَالَ إِنْ فَلَمْ يَجِبْ ، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ .
قَالَ : فَكَانَ أَبُو يُوسُفَ بَعْدَهَا لَا يَدْعُ أَنْ يَأْتِيَ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيَّ .
[ ص: 120 ] فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَصْلٍ لُغَوِيٍّ لَا بُدَّ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمَيْنِ .
فَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ تُرْشِدُ النَّاظِرَ إِلَى مَا وَرَاءَهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ فِيمَا يَأْتِي مِنَ الْعُلُومِ وَيَذَرُ ; فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا يَسْتَفِزُّ النَّاظِرَ اسْتِحْسَانُهَا بِبَادِئِ الرَّأْيِ ; فَيَقْطَعُ فِيهَا عُمْرَهُ ، وَلَيْسَ وَرَاءَهَا مَا يُتَّخَذُ مُعْتَمَدًا فِي عَمَلٍ وَلَا اعْتِقَادٍ ، فَيَخِيبُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَعْيُهُ ، وَاللَّهُ الْوَاقِي .
وَمِنْ طَرِيفِ الْأَمْثِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ الْبَنَّاءِ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ : لِمَ لَمْ تَعْمَلْ إِنَّ فِي هَذَانِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ الْآيَةَ [ طه : 63 ] ؟
فَقَالَ فِي الْجَوَابِ : لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرِ الْقَوْلُ فِي الْمَقُولِ لَمْ يُؤَثِّرِ الْعَامِلُ فِي الْمَعْمُولِ .
فَقَالَ السَّائِلَ : يَا سَيِّدِي ، وَمَا وَجْهُ الِارْتِبَاطِ بَيْنَ عَمَلِ إِنَّ وَقَوْلِ الْكُفَّارِ فِي النَّبِيِّينَ ؟
فَقَالَ لَهُ الْمُجِيبُ : يَا هَذَا إِنَّمَا جِئْتُكَ بِنُوَّارَةٍ يَحْسُنُ رَوْنَقُهَا ; فَأَنْتَ تُرِيدُ أَنَّ تَحُكَّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، ثُمَّ تَطْلُبَ مِنْهَا ذَلِكَ الرَّوْنَقَ - أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ -
فَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ مَا تَرَى ، وَبِعَرْضِهِ عَلَى الْعَقْلِ يَتَبَيَّنُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُوَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا لَيْسَ مِنَ الصُّلْبِ ، وَلَا مِنَ الْمُلَحِ - : مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ وَلَا ظَنِّيٍّ ، وَإِنَّمَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِالْإِبْطَالِ [ ص: 121 ] مِمَّا صَحَّ كَوْنُهُ مِنَ الْعُلُومِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهَا فِي الْأَعْمَالِ وَالِاعْتِقَادَاتِ ، أَوْ كَانَ مُنْهَضًا إِلَى إِبْطَالِ الْحَقِّ وَإِحْقَاقِ الْبَاطِلِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، فَهَذَا لَيْسَ بِعِلْمٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَلَا حَاكِمٍ ، وَلَا مُطَّرِدٍ أَيْضًا ، وَلَا هُوَ مِنْ مُلَحِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُلَحَ هِيَ الَّتِي تَسْتَحْسِنُهَا الْعُقُولُ ، وَتَسْتَمْلِحُهَا النُّفُوسُ ; إِذْ لَيْسَ يَصْحَبُهَا مُنَفِّرٌ ، وَلَا هِيَ مِمَّا تُعَادِي الْعُلُومَ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ أَصْلٍ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ هَذَا الْقِسْمِ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
هَذَا وَإِنْ مَالَ بِقَوْمٍ فَاسْتَحْسَنُوهُ وَطَلَبُوهُ ; فَلِشِبْهِ عَارِضَةٍ وَاشْتِبَاهٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ ، فَرُبَّمَا عَدَّهُ الْأَغْبِيَاءُ مَبْنِيًّا عَلَى أَصْلٍ ، فَمَالُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَحَقِيقَةُ أَصْلِهِ وَهْمٌ وَتَخْيِيلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ، مَعَ مَا يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْأَهْوَاءِ ، كَالْإِغْرَابِ بِاسْتِجْلَابِ غَيْرِ الْمَعْهُودِ ، وَالْجَعْجَعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ الرَّاسِخُونَ ، وَالتَّبَجُّحِ بِأَنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ مُطَالَبَ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا الْخَوَاصُّ . . . ، وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ مَطْلُوبٌ ، وَلَا يَحُورُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِالِافْتِضَاحِ عِنْدَ الِامْتِحَانِ حَسْبَمَا بَيَّنَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَّالِيُّ ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَمَنْ تَعَرَّضَ لِبَيَانِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا .
وَمِثَالُ هَذَا الْقِسْمِ مَا انْتَحَلَهُ الْبَاطِنِيَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ وَرَاءَ هَذَا الظَّاهِرِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَيْلِهِ بِعَقْلٍ ، وَلَا نَظَرٍ ، وَإِنَّمَا يُنَالُ مِنَ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ تَقْلِيدًا لِذَلِكَ الْإِمَامِ ، وَاسْتِنَادُهُمْ فِي جُمْلَةٍ مِنْ دَعَاوِيهِمْ إِلَى [ ص: 122 ] عِلْمِ الْحُرُوفِ ، وَعِلْمِ النُّجُومِ ، وَلَقَدِ اتَّسَعَ الْخَرْقُ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَلَى الرَّاقِعِ ; فَكَثُرَتِ الدَّعَاوَى عَلَى الشَّرِيعَةِ بِأَمْثَالِ مَا ادَّعَاهُ الْبَاطِنِيَّةُ ، حَتَّى آلَ ذَلِكَ إِلَى مَالَا يُعْقَلُ عَلَى حَالٍ ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَيَشْمَلُ هَذَا الْقِسْمُ مَا يَنْتَحِلُهُ أَهْلُ السَّفْسَطَةِ وَالْمُتَحَكِّمُونَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يَنْبَنِي عَلَيْهِ ، [ ص: 123 ] وَلَا ثَمَرَةَ تُجْنَى مِنْهُ ، فَلَا تَعَلُّقَ بِهِ بِوَجْهٍ .
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : هُوَ الْأَصْلُ وَالْمُعْتَمَدُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الطَّلَبِ ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي مَقَاصِدُ الرَّاسِخِينَ ، وَذَلِكَ مَا كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ رَاجِعًا إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ ، وَالشَّرِيعَةُ الْمُبَارَكَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مَنَزَّلَةٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [ الْحِجْرِ : 9 ] ; لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الْمَقَاصِدِ الَّتِي بِهَا يَكُونُ صَلَاحُ الدَّارَيْنِ ، [ ص: 108 ] وَهِيَ الضَّرُورِيَّاتُ ، وَالْحَاجِيَّاتُ ، وَالتَّحْسِينَاتُ ، وَمَا هُوَ مُكَمِّلٌ لَهَا ، وَمُتَمَّمٌ لِأَطْرَافِهَا ، وَهِيَ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ الْقَطْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا ، وَسَائِرُ الْفُرُوعِ مُسْتَنِدَةٌ إِلَيْهَا ; فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهَا عِلْمٌ أَصِيلٌ رَاسِخُ الْأَسَاسِ ثَابِتُ الْأَرْكَانِ .
هَذَا وَإِنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لَا عَقْلِيَّةً ، فَالْوَضْعِيَّاتُ قَدْ تُجَارِي الْعَقْلِيَّاتِ فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ ، وَعِلْمُ الشَّرِيعَةِ مِنْ جُمْلَتِهَا ; إِذِ الْعِلْمُ بِهَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الِاسْتِقْرَاءِ الْعَامِّ النَّاظِمِ لِأَشْتَاتِ أَفْرَادِهَا ، حَتَّى تَصِيرَ فِي الْعَقْلِ مَجْمُوعَةً فِي كُلِّيَّاتٍ مُطَّرِدَةٍ عَامَّةٍ ، ثَابِتَةٍ غَيْرِ زَائِلَةٍ ، وَلَا مُتَبَدِّلَةٍ ، وَحَاكِمَةٍ غَيْرِ مَحْكُومٍ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ خَوَاصُّ الْكُلِّيَّاتِ الْعَقْلِيَّاتِ .
وَأَيْضًا ; فَإِنَّ الْكُلِّيَّاتِ الْعَقْلِيَّةَ مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْوُجُودِ ، وَهُوَ أَمْرٌ وَضْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ ; فَاسْتَوَتْ مَعَ الْكُلِّيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ، وَارْتَفَعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا .
فَإِذًا لِهَذَا الْقِسْمِ خَوَاصٌّ ثَلَاثٌ : بِهِنَّ يَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهِ : إِحْدَاهَا : الْعُمُومُ وَالِاطِّرَادُ ، فَلِذَلِكَ جَرَتِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهَا الْخَاصَّةُ لَا تَتَنَاهَى ؛ فَلَا عَمَلَ يُفْرَضُ ، وَلَا حَرَكَةَ ، وَلَا سُكُونَ يُدَّعَى - إِلَّا وَالشَّرِيعَةُ عَلَيْهِ حَاكِمَةٌ إِفْرَادًا ، وَتَرْكِيبًا ، وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهَا عَامَّةٌ ، وَإِنْ فُرِضَ فِي نُصُوصِهَا أَوْ مَعْقُولِهَا خُصُوصٌ مَا ; فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى عُمُومٍ ; كَالْعَرَايَا ، وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقِرَاضِ ، [ ص: 109 ] وَالْمُسَاقَاةِ ، وَالصَّاعِ فِي الْمُصَرَّاةِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ; فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أُصُولٍ حَاجِيَّةٍ أَوْ تَحْسِينِيَّةٍ أَوْ مَا يُكَمِّلُهَا ، وَهِيَ أُمُورٌ عَامَّةٌ ; فَلَا خَاصَّ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا وَهُوَ عَامٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَالِاعْتِبَارُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ .
وَالثَّانِيَةُ : الثُّبُوتُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ ; فَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ فِيهَا بَعْدَ كَمَالِهَا نَسْخًا ، وَلَا تَخْصِيصًا لِعُمُومِهَا ، وَلَا تَقْيِيدًا لِإِطْلَاقِهَا ، وَلَا رَفْعًا لِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا لَا بِحَسَبِ عُمُومِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَلَا بِحَسَبِ خُصُوصِ بَعْضِهِمْ ، وَلَا بِحَسَبِ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، وَلَا حَالٍ دُونَ حَالٍ ، بَلْ مَا أُثْبِتَ سَبَبًا ; فَهُوَ سَبَبٌ أَبَدًا لَا يَرْتَفِعُ ، وَمَا [ ص: 110 ] كَانَ شَرْطًا ; فَهُوَ أَبَدًا شَرْطٌ ، وَمَا كَانَ وَاجِبًا فَهُوَ وَاجِبٌ أَبَدًا ، أَوْ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ فَلَا زَوَالَ لَهَا ، وَلَا تَبَدُّلَ ، وَلَوْ فُرِضَ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ لَكَانَتْ أَحْكَامُهَا كَذَلِكَ .
وَالثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=18470كَوْنُ الْعِلْمِ حَاكِمًا لَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُفِيدًا لِعَمَلٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِمَّا يَلِيقُ بِهِ ; فَلِذَلِكَ انْحَصَرَتْ عُلُومُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يُفِيدُ الْعَمَلَ أَوْ يُصَوِّبُ نَحْوَهُ ، لَا زَائِدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا تَجِدُ فِي الْعَمَلِ أَبَدًا مَا هُوَ حَاكِمٌ عَلَى الشَّرِيعَةِ ، وَإِلَّا انْقَلَبَ كَوْنُهَا حَاكِمَةً إِلَى كَوْنِهَا مَحْكُومًا عَلَيْهَا ، وَهَكَذَا سَائِرُ مَا يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ .
فَإِذًا ; كُلُّ عِلْمٍ حَصَلَ لَهُ هَذِهِ الْخَوَاصُّ الثَّلَاثُ ; فَهُوَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مَعْنَاهَا ، وَالْبُرْهَانُ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي - وَهُوَ الْمَعْدُودُ فِي مُلَحِ الْعِلْمِ لَا فِي صُلْبِهِ - : مَا لَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا ، وَلَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ ، بَلْ إِلَى ظَنِّيٍّ ، أَوْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى قَطْعِيٍّ إِلَّا أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهُ خَاصَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ خَاصَّةٍ وَاحِدَةٍ ; فَهُوَ مُخَيَّلٌ ، وَمِمَّا يَسْتَفِزُّ الْعَقْلَ بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ الْأَوَّلِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِخْلَالٌ بِأَصْلِهِ ، وَلَا بِمَعْنَى غَيْرِهِ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَحَّ أَنْ يُعَدَّ فِي هَذَا الْقِسْمِ .
فَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الْأُولَى - وَهُوَ الِاطِّرَادُ وَالْعُمُومُ - فَقَادِحٌ فِي جَعْلِهِ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ لِأَنَّ عَدَمَ الِاطِّرَادِ يُقَوِّي جَانِبَ الِاطِّرَاحِ ، وَيُضْعِفُ جَانِبَ الِاعْتِبَارِ ; إِذِ النَّقْضُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْوُثُوقِ بِالْقَصْدِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِلْمُ ، وَيُقَرِّبُهُ مِنَ الْأُمُورِ الِاتِّفَاقِيَّةِ الْوَاقِعَةِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يُوثَقُ بِهِ ، وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ .
وَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الثَّانِيَةِ - وَهُوَ الثُّبُوتُ - فَيَأْبَاهُ صُلْبُ الْعِلْمِ وَقَوَاعِدُهُ ; [ ص: 111 ] فَإِنَّهُ إِذَا حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ ، ثُمَّ خَالَفَ حَكَمُهُ الْوَاقِعَ فِي الْقَضِيَّةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَوْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَانَ حُكْمُهُ خَطَأً وَبَاطِلًا ، مِنْ حَيْثُ أَطْلَقَ الْحُكْمَ فِيمَا لَيْسَ بِمُطْلَقٍ أَوْ عَمَّ فِيمَا هُوَ خَاصٌّ ; فَعَدِمَ النَّاظِرُ الْوُثُوقَ بِحُكْمِهِ ، وَذَلِكَ مَعْنَى خُرُوجِهِ عَنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَأَمَّا تَخَلُّفُ الْخَاصِّيَّةِ الثَّالِثَةِ - وَهُوَ كَوْنُهُ حَاكِمًا وَمَبْنِيًّا عَلَيْهِ - فَقَادِحٌ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ إِنْ صَحَّ فِي الْعُقُولِ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهِ فَائِدَةٌ حَاضِرَةٌ ، غَيْرَ مُجَرَّدِ رَاحَاتِ النُّفُوسِ ، فَاسْتُوِيَ مَعَ سَائِرِ مَا يُتَفَرَّجُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَأَحْرَى فِي الِاطِّرَاحِ ، كَمَبَاحِثِ السُّوفِسْطَائِيِّينَ ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ .
وَلِتَخَلُّفِ بَعْضِ هَذِهِ الْخَوَاصِّ أَمْثِلَةٌ يُلْحَقُ بِهَا مَا سِوَاهَا : أَحَدُهَا : الْحِكَمُ الْمُسْتَخْرَجَةُ لِمَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عَلَى الْخُصُوصِ فِي التَّعْبُدَاتِ كَاخْتِصَاصِ الْوُضُوءِ بِالْأَعْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَالصَّلَاةِ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَالْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَكَوْنِهَا عَلَى بَعْضِ الْهَيْئَاتِ دُونَ بَعْضٍ ، وَاخْتِصَاصِ الصِّيَامِ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ ، وَتَعْيِينِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فِي تِلْكَ الْأَحْيَانِ الْمُعَيَّنَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنْ أَحْيَانِ اللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، وَاخْتِصَاصِ الْحَجِّ بِالْأَعْمَالِ الْمَعْلُومَةِ ، وَفِي الْأَمَاكِنِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَإِلَى مَسْجِدٍ مَخْصُوصٍ ، إِلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ وَلَا تَطُورُ نَحْوَهُ ، فَيَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ فَيُطَرِّقُ إِلَيْهِ حِكَمًا يَزْعُمُ أَنَّهَا مَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنْ تِلْكَ الْأَوْضَاعِ ، وَجَمِيعُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنٍّ [ ص: 112 ] وَتَخْمِينٍ غَيْرِ مُطَّرِدٍ فِي بَابِهِ ، وَلَا مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ عَمَلٌ ، بَلْ كَالتَّعْلِيلِ بَعْدَ السَّمَاعِ لِلْأُمُورِ الشَّوَاذِّ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يُعَدُّ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ لِجِنَايَتِهِ عَلَى الشَّرِيعَةِ فِي دَعْوَى مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ ، وَلَا دَلِيلَ لَنَا عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : تَحَمُّلُ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ عَلَى الْتِزَامِ كَيْفِيَّاتٍ لَا يَلْزَمُ مِثْلُهَا ، وَلَا يُطْلَبُ الْتِزَامُهَا ، كَالْأَحَادِيثِ الْمُسَلْسَلَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عَلَى وُجُوهٍ مُلْتَزَمَةٍ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ ، فَالْتَزَمَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِالْقَصْدِ ، فَصَارَ تَحَمُّلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ تَحَرِّيًا لَهَا ؛ بِحَيْثُ يَتَعَنَّى فِي اسْتِخْرَاجِهَا ، وَيَبْحَثُ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَصْدَ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلٌ ، وَإِنْ صَحِبَهَا الْعَمَلُ ; لِأَنَّ تَخَلُّفَهُ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْأَسَانِيدِ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337343الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ; فَإِنَّهُمُ الْتَزَمُوا فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ حَدِيثٍ يَسْمَعُهُ [ ص: 113 ] التِّلْمِيذُ مِنْ شَيْخِهِ ; فَإِنْ سَمِعَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا أَخَذَ عَنْهُ غَيْرَهُ ؛ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الِاسْتِفَادَةَ بِمُقْتَضَاهُ ، [ كَذَا سَائِرُهَا ;غَيْرَ أَنَّهُمُ الْتَزَمُوا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّبَرُّكِ وَتَحْسِينِ الظَّنِّ خَاصَّةً ] ، وَلَيْسَ بِمُطَّرِدٍ فِي جَمِيعِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا حَتَّى يُقَالَ : إِنَّهُ مَقْصُودٌ ; فَطَلَبُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مُلَحِ الْعِلْمِ لَا مَنْ صُلْبِهِ .
وَالثَّالِثُ : التَّأَنُّقُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، لَا عَلَى قَصْدِ طَلَبِ تَوَاتُرِهِ ، بَلْ عَلَى أَنْ يُعَدَّ آخِذًا لَهُ عَنْ شُيُوخٍ كَثِيرَةٍ ، وَمِنْ جِهَاتٍ شَتَّى ، وَإِنْ [ ص: 114 ] كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْآحَادِ فِي الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَالِاشْتِغَالُ بِهَذَا مِنَ الْمُلَحِ لَا مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
خَرَّجَ nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيِّ ; قَالَ : خَرَّجْتُ حَدِيثًا وَاحِدًا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ مِائَتَيْ طَرِيقٍ - شَكَّ الرَّاوِي - قَالَ : فَدَاخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْفَرَحِ غَيْرُ قَلِيلٍ ، وَأُعْجِبْتُ بِذَلِكَ ; فَرَأَيْتُ nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا زَكَرِيَّا قَدْ خَرَّجْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ . قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ؛ هَذَا مَا قَالَ . وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّ تَخْرِيجَهُ مِنْ طُرُقٍ يَسِيرَةٍ كَافٍ فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ ، فَصَارَ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ فَضْلًا .
وَالرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=18466الْعُلُومُ الْمَأْخُوذَةُ مِنَ الرُّؤْيَا مِمَّا لَا يَرْجِعُ إِلَى بِشَارَةٍ ، وَلَا نِذَارَةٍ ; فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ بِالْمَنَامَاتِ ، وَمَا يُتَلَقَّى مِنْهَا تَصْرِيحًا ; فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً ; فَأَصْلُهَا الَّذِي هُوَ الرُّؤْيَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ [ ص: 115 ] فِي الشَّرِيعَةِ فِي مِثْلِهَا ، كَمَا فِي رُؤْيَا الْكِنَانِيِّ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا ; فَإِنَّ مَا قَالَ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ حَتَّى عَرَضْنَاهُ عَلَى الْعِلْمِ فِي الْيَقَظَةِ ; فَصَارَ الِاسْتِشْهَادُ بِهِ مَأْخُوذًا مِنَ الْيَقَظَةِ لَا مِنَ الْمَنَامِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ الرُّؤْيَا تَأْنِيسًا ، وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الِاسْتِشْهَادِ بِالرُّؤْيَا .
وَالْخَامِسُ : الْمَسَائِلُ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِيهَا فَلَا يَنْبَنِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيهَا فَرْعٌ عَمَلِيٌّ ، إِنَّمَا تُعَدُّ مِنَ الْمُلَحِ ، كَالْمَسَائِلِ الْمُنَبَّهِ عَلَيْهَا قَبْلُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَيَقَعُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي سَائِرِ الْعُلُومِ ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ مِنْهَا كَثِيرٌ ، كَمَسْأَلَةِ اشْتِقَاقِ الْفِعْلِ مِنَ الْمَصْدَرِ ، وَمَسْأَلَةِ اللَّهُمَّ ، وَمَسْأَلَةِ أَشْيَاءَ ، وَمَسْأَلَةِ الْأَصْلِ فِي [ ص: 116 ] لَفْظِ الِاسْمِ ، وَإِنِ انْبَنَى الْبَحْثُ فِيهَا عَلَى أُصُولٍ مُطَّرِدَةٍ ، وَلَكِنَّهَا لَا فَائِدَةَ تُجْنَى ثَمَرَةً لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا ، فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَالسَّادِسُ : الِاسْتِنَادُ إِلَى الْأَشْعَارِ فِي تَحْقِيقِ الْمَعَانِي الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ ، وَكَثِيرًا مَا يَجْرِي مِثْلُ هَذَا لِأَهْلِ التَّصَوُّفِ فِي كُتُبِهِمْ ، وَفِي بَيَانِ مَقَامَاتِهِمْ فَيَنْتَزِعُونَ مَعَانِيَ الْأَشْعَارِ ، وَيَضَعُونَهَا لِلتَّخَلُّقِ بِمُقْتَضَاهَا ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ الْمُلَحِ ؛ لِمَا فِي الْأَشْعَارِ الرَّقِيقَةِ مِنْ إِمَالَةِ الطِّبَاعِ ، وَتَحْرِيكِ النُّفُوسِ إِلَى الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ ، وَلِذَلِكَ اتَّخَذَهُ الْوُعَّاظُ دَيْدَنًا ، وَأَدْخَلُوهُ فِي أَثْنَاءِ وَعْظِهِمْ ، وَأَمَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْرِ فِي نَفْسِهِ ; فَالِاسْتِشْهَادُ بِالْمَعْنَى ; فَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا ; فَمَقْبُولٌ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَالسَّابِعُ : الِاسْتِدْلَالُ عَلَى تَثْبِيتِ الْمَعَانِي بِأَعْمَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاحِ ، بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ تَحْسِينِ الظَّنِّ ، لَا زَائِدَ عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ أَعْمَالُهُمْ حُجَّةً ، حَسْبَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ ، فَإِذَا أُخِذَ ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ فِيمَنْ يُحْسَنُ [ ص: 117 ] الظَّنُّ بِهِ ; فَهُوَ - عِنْدَمَا يَسْلَمُ مِنَ الْقَوَادِحِ - مِنْ هَذَا الْقِسْمِ ; لِأَجْلِ مَيْلِ النَّاسِ إِلَى مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ صَلَاحٌ وَفَضْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ اطِّرَادِ الصَّوَابِ فِي عَمَلِهِ ، وَلِجَوَازِ تَغَيُّرِهِ ; فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ - إِنْ سَلِمَ - هَذَا الْمَأْخَذَ .
وَالثَّامِنُ : كَلَامُ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ; فَإِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ مِنْ قَبِيلِ مَا نَحْنُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَوْغَلُوا فِي خِدْمَةِ مَوْلَاهُمْ ، حَتَّى أَعْرَضُوا عَنْ غَيْرِهِ جُمْلَةً ، فَمَالَ بِهِمْ هَذَا الطَّرَفُ إِلَى أَنْ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ الِاطِّرَاحِ لِكُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ ، وَأَعْرَبُوا عَنْ مُقْتَضَاهُ ، وَشَأْنُ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ لَا يُطِيقُهُ الْجُمْهُورُ ، وَهُمْ إِنَّمَا يُكَلِّمُونَ بِهِ الْجُمْهُورَ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ; فَفِي رُتْبَتِهِ لَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ - فِي حَقِّ الْأَكْثَرِ - مِنَ الْحَرَجِ أَوْ تَكْلِيفِ مَالَا يُطَاقُ ، بَلْ رُبَّمَا ذَمُّوا بِإِطْلَاقٍ مَا لَيْسَ بِمَذْمُومٍ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، وَفِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، فَصَارَ أَخْذُهُ بِإِطْلَاقٍ مُوقِعًا فِي مَفْسَدَةٍ ، بِخِلَافِ أَخْذِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ ; فَلَيْسَ عَلَى هَذَا مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُلَحِهِ ، وَمُسْتَحْسَنَاتِهِ .
وَالتَّاسِعُ : حَمْلُ بَعْضِ الْعُلُومِ عَلَى بَعْضٍ فِي بَعْضِ قَوَاعِدِهِ ; حَتَّى تَحْصُلَ الْفُتْيَا فِي أَحَدِهَا بِقَاعِدَةِ الْآخَرِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجْتَمِعَ الْقَاعِدَتَانِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ حَقِيقِيٍّ ، كَمَا يُحْكَى عَنِ الْفَرَّاءِ النَّحْوِيِّ ; أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَرَعَ فِي عِلْمٍ وَاحِدٍ سَهُلَ [ ص: 118 ] عَلَيْهِ كُلُّ عِلْمٍ . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي - وَكَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، وَكَانَ ابْنَ خَالَةِ الْفَرَّاءِ - : فَأَنْتَ قَدْ بَرَعْتَ فِي عِلْمِكَ ، فَخُذْ مَسْأَلَةً أَسْأَلُكَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِكَ : مَا تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فَسَهَا فِي سُجُودِهِ أَيْضًا ؟
قَالَ الْفَرَّاءُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَكَيْفَ ؟
قَالَ : لِأَنَّ التَّصْغِيرَ عِنْدَنَا لَا يُصَغَّرُ ، فَكَذَلِكَ السَّهْوُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَا يُسْجَدُ لَهُ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَصْغِيرِ التَّصْغِيرِ ، فَالسُّجُودُ لِلسَّهْوِ هُوَ جَبْرٌ لِلصَّلَاةِ ، وَالْجَبْرُ لَا يُجْبَرُ ، كَمَا أَنَّ التَّصْغِيرَ لَا يُصَغَّرُ .
فَقَالَ الْقَاضِي : مَا حَسِبْتُ أَنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ مِثْلَكَ .
فَأَنْتَ تَرَى مَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ التَّصْغِيرِ وَالسَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الضَّعْفِ ; إِذْ لَا يَجْمَعُهُمَا فِي الْمَعْنَى أَصْلٌ حَقِيقِيٌّ ، فَيُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ .
فَلَوْ جَمَعَهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ ; لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، كَمَسْأَلَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ .
رُوِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ يُدَاعِبُهُ وَيُمَازِحُهُ ; فَقَالَ [ ص: 119 ] لَهُ أَبُو يُوسُفَ : هَذَا الْكُوفِيُّ قَدِ اسْتَفْرَغَكَ ، وَغَلَبَ عَلَيْكَ .
فَقَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّهُ لَيَأْتِيَنِي بِأَشْيَاءَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا قَلْبِي .
فَأَقْبَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ عَلَى أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ هَلْ لَكَ فِي مَسْأَلَةٍ ؟
فَقَالَ : نَحْوٌ أَمْ فِقْهٌ .
قَالَ : بَلْ فِقْهٌ .
فَضَحِكَ الرَّشِيدُ حَتَّى فَحَصَ بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : تُلْقِي عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِقْهًا ؟
قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : يَا أَبَا يُوسُفَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ ، وَفَتَحَ أَنْ ؟
قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ طَلَقَتْ .
قَالَ : أَخْطَأْتَ يَا أَبَا يُوسُفَ .
فَضَحِكَ الرَّشِيدُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ الصَّوَابُ ؟
قَالَ : إِذَا قَالَ أَنْ فَقَدْ وَجَبَ الْفِعْلُ ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ قَالَ إِنْ فَلَمْ يَجِبْ ، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ .
قَالَ : فَكَانَ أَبُو يُوسُفَ بَعْدَهَا لَا يَدْعُ أَنْ يَأْتِيَ nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيَّ .
[ ص: 120 ] فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَصْلٍ لُغَوِيٍّ لَا بُدَّ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمَيْنِ .
فَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ تُرْشِدُ النَّاظِرَ إِلَى مَا وَرَاءَهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ فِيمَا يَأْتِي مِنَ الْعُلُومِ وَيَذَرُ ; فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا يَسْتَفِزُّ النَّاظِرَ اسْتِحْسَانُهَا بِبَادِئِ الرَّأْيِ ; فَيَقْطَعُ فِيهَا عُمْرَهُ ، وَلَيْسَ وَرَاءَهَا مَا يُتَّخَذُ مُعْتَمَدًا فِي عَمَلٍ وَلَا اعْتِقَادٍ ، فَيَخِيبُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَعْيُهُ ، وَاللَّهُ الْوَاقِي .
وَمِنْ طَرِيفِ الْأَمْثِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ الْبَنَّاءِ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ : لِمَ لَمْ تَعْمَلْ إِنَّ فِي هَذَانِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=63إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ الْآيَةَ [ طه : 63 ] ؟
فَقَالَ فِي الْجَوَابِ : لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرِ الْقَوْلُ فِي الْمَقُولِ لَمْ يُؤَثِّرِ الْعَامِلُ فِي الْمَعْمُولِ .
فَقَالَ السَّائِلَ : يَا سَيِّدِي ، وَمَا وَجْهُ الِارْتِبَاطِ بَيْنَ عَمَلِ إِنَّ وَقَوْلِ الْكُفَّارِ فِي النَّبِيِّينَ ؟
فَقَالَ لَهُ الْمُجِيبُ : يَا هَذَا إِنَّمَا جِئْتُكَ بِنُوَّارَةٍ يَحْسُنُ رَوْنَقُهَا ; فَأَنْتَ تُرِيدُ أَنَّ تَحُكَّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، ثُمَّ تَطْلُبَ مِنْهَا ذَلِكَ الرَّوْنَقَ - أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ -
فَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ مَا تَرَى ، وَبِعَرْضِهِ عَلَى الْعَقْلِ يَتَبَيَّنُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُوَ مِنْ صُلْبِ الْعِلْمِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا لَيْسَ مِنَ الصُّلْبِ ، وَلَا مِنَ الْمُلَحِ - : مَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَصْلٍ قَطْعِيٍّ وَلَا ظَنِّيٍّ ، وَإِنَّمَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِالْإِبْطَالِ [ ص: 121 ] مِمَّا صَحَّ كَوْنُهُ مِنَ الْعُلُومِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهَا فِي الْأَعْمَالِ وَالِاعْتِقَادَاتِ ، أَوْ كَانَ مُنْهَضًا إِلَى إِبْطَالِ الْحَقِّ وَإِحْقَاقِ الْبَاطِلِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، فَهَذَا لَيْسَ بِعِلْمٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى أَصْلِهِ بِالْإِبْطَالِ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَلَا حَاكِمٍ ، وَلَا مُطَّرِدٍ أَيْضًا ، وَلَا هُوَ مِنْ مُلَحِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُلَحَ هِيَ الَّتِي تَسْتَحْسِنُهَا الْعُقُولُ ، وَتَسْتَمْلِحُهَا النُّفُوسُ ; إِذْ لَيْسَ يَصْحَبُهَا مُنَفِّرٌ ، وَلَا هِيَ مِمَّا تُعَادِي الْعُلُومَ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ أَصْلٍ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ هَذَا الْقِسْمِ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
هَذَا وَإِنْ مَالَ بِقَوْمٍ فَاسْتَحْسَنُوهُ وَطَلَبُوهُ ; فَلِشِبْهِ عَارِضَةٍ وَاشْتِبَاهٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ ، فَرُبَّمَا عَدَّهُ الْأَغْبِيَاءُ مَبْنِيًّا عَلَى أَصْلٍ ، فَمَالُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَحَقِيقَةُ أَصْلِهِ وَهْمٌ وَتَخْيِيلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ، مَعَ مَا يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْأَهْوَاءِ ، كَالْإِغْرَابِ بِاسْتِجْلَابِ غَيْرِ الْمَعْهُودِ ، وَالْجَعْجَعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ الرَّاسِخُونَ ، وَالتَّبَجُّحِ بِأَنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ مُطَالَبَ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا الْخَوَاصُّ . . . ، وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ مَطْلُوبٌ ، وَلَا يَحُورُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِالِافْتِضَاحِ عِنْدَ الِامْتِحَانِ حَسْبَمَا بَيَّنَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَّالِيُّ ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَمَنْ تَعَرَّضَ لِبَيَانِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا .
وَمِثَالُ هَذَا الْقِسْمِ مَا انْتَحَلَهُ الْبَاطِنِيَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ إِخْرَاجِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ وَرَاءَ هَذَا الظَّاهِرِ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى نَيْلِهِ بِعَقْلٍ ، وَلَا نَظَرٍ ، وَإِنَّمَا يُنَالُ مِنَ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ تَقْلِيدًا لِذَلِكَ الْإِمَامِ ، وَاسْتِنَادُهُمْ فِي جُمْلَةٍ مِنْ دَعَاوِيهِمْ إِلَى [ ص: 122 ] عِلْمِ الْحُرُوفِ ، وَعِلْمِ النُّجُومِ ، وَلَقَدِ اتَّسَعَ الْخَرْقُ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَلَى الرَّاقِعِ ; فَكَثُرَتِ الدَّعَاوَى عَلَى الشَّرِيعَةِ بِأَمْثَالِ مَا ادَّعَاهُ الْبَاطِنِيَّةُ ، حَتَّى آلَ ذَلِكَ إِلَى مَالَا يُعْقَلُ عَلَى حَالٍ ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَيَشْمَلُ هَذَا الْقِسْمُ مَا يَنْتَحِلُهُ أَهْلُ السَّفْسَطَةِ وَالْمُتَحَكِّمُونَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يَنْبَنِي عَلَيْهِ ، [ ص: 123 ] وَلَا ثَمَرَةَ تُجْنَى مِنْهُ ، فَلَا تَعَلُّقَ بِهِ بِوَجْهٍ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام



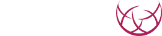








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات