أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ، ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ) وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل كافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة ، وقد لخصت منه مناسبة السور خاصة في جزء لطيف ، سميته تناسق الدرر في تناسب السور .
وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته ، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين ، فقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط .
وقال ابن العربي في سراج المريدين : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم ، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح الله لنا فيه ، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه .
وقال غيره : أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري ، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة .
[ ص: 217 ] وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك ، يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه ، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ، شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض .
وقال الشيخ ولي الدين الملوي : قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا ، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا ، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياتها بالتوقيف ، كما أنزل جملة إلى بيت العزة ، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر ، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جم ، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له انتهى .
وقال الإمام الرازي في سورة البقرة : ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه ، وشرف معانيه ، فهو أيضا بسبب ترتيبه ، ونظم آياته ، ولعل الذين قالوا : إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين على هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل :
والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام





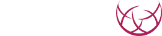








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات