3-4/3 بعض خصائص السنن الإلهية:
يرى رمضان خميس زكي، ولديه دراسة عن موضوع السنن الإلهية، أن أبرز خصائص هذه السنن: أنها سنن عامة، تنطبق على البشر جميعا، وليست خاصة بطائفة دون طائفة ولا لجيل دون جيل والذي يؤكد عمومية الموضوع.. ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع بصورة من يرى المسـتقبل من خـلال السـنن حين يقول: «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، أهل الكتاب، حذو القذة بالقذة» [1] ، حتى إنه يصـل في المشـابهة إلى أن يحشرهم في «جحر الضب».. ومثل هذا النظر إلى الموضوع هو الـذي نفتقده الآن، وعلينا أن نكتسبه.
هذه النظرة القرآنية، هي التي تجعـل المسلم قادرا على الاعتبار، الذي يلح عليه القرآن، فأمامنـا تجـارب القرون الماضية، تجارب كثيرة تظهر فيها سنن الأقوام التي يخضـع لها المسلمون أيضا كأي قوم من الأقوام..
وهذا النظر القرآني يجـرد الإنسان من ملابساته ويرجعه إلى أصـله المجـرد، الـذي يخضـع للسنن، فالسنة الإلهية تجري على الجميع، لا فرق بين مجتمع [ ص: 119 ] ومجتمع، ولا فرق بين ديانة وديانة، ولا فرق بين جيل وجيل، وإلا لما دعا القـرآن الكريم إلى التفكر في آثار السابقين!
فالذي يفهم السـنن الإلهية وعمومها يملك القـدرة على التـعامل، ويحسن الاسـتعداد لنتائـجهـا، وقد قال قـوم جهلوا ذلك، بلغـة النـدم، في الآخرة، قال تعالى: ... وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (الملك: 10).
كما تتسم السنن الإلهية (بالحاكمية والهيمنة) على الجميع، فهـي أيضا مطردة لا تتبدل، ومن هنا أمرنا الله بالاتعاظ والاعتبار.
ويرى أن القرآن الكريم حافل بالمعاني التي تؤكد هذا المعنى، كما أن السنة النبوية المطهرة قد أشـارت إلى ذلك، فمثـلا ما ذكره ابن كثير في تفسـيره عن زياد بن لبيد، رضي الله عنه، أنه قال:
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شـيئا فقال: «وذلك عند ذهاب العلم»، قلنا: يا رسول الله، وكيف يذهب العـلم ونحن نقرأ القرآن، ونقرئه أبنـاءنا، وأبنـاؤنا يقرؤونه لأبنـائهم إلى يـوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك [ ص: 120 ] يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجـل بالمدينـة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التـوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيها بشيء»؟
[2] .
أما رشيد كسوس، من جامعة القرويين، فقد نشر بحثا في ذات الموضوع، فهو يجمل خصائص السنن الإلهية، ضمن ما يلي:
أنها ربانية: أي أنها مرتبطـة بالله عز وجل، وهذا يمنـحها قدسـية؛ لأنها صادرة من مصدر علوي، ولم تصدر عن حكم البشر، الذين يحكمهم القصور والعجز؛
وأنها ثابتة: وهذه الدائرة الثابتة تضفي عليها الطمأنينة وتضمن للكون التناسق والتماسك في نظام، والهدف من الثبات هو إسقاط القول بالصدفة؛ وكذلك الاطراد من خصائص السنن؛
وهي عامة، كما أشرنا، تسـري على الجميـع؛
وهي كذلك واقعية: مثلا من سـنن الله فيمن خلق أن يعذب الظالم بيد ظالم آخر..
ومن الخصـائص أن السـنن طابعها الشـمول، فهي جامعة لا تقبل التجـزئة، وشـاملة لكل شـؤون الحيـاة؛ وهي أيضـا متـوازنة، قال تعالى: [ ص: 121 ] ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت (الملك:3).. ثم ذكر خصائص أخرى استنبطها من آيات الكتاب
[3] .
وبذات الطريقة يتجه كثير ممن تناول مسألة السنن الإلهية وخصائصها، ويعمد إلى التركيز نحو عناصر بعينها ضمن هذه الخصـائص موضحا أنها مسـتقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، على نحو الاسـتدلال بعدم التبدل أو التحول (الثبات) بقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (الأحزاب: 62) ، وقوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا (فاطر:43).
أو الاستدلال بخاصية حتمية الوقوع والنفاذ، فنجد ذلك في قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (مريم:35) ، فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا (فاطر:43) ،
أو الاستدلال بخاصية الشـمولية، بقوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا (النساء:123-124).
[ ص: 122 ]
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية

المعرفة التاريخية في ضوء القرآن الكريم
الدكتور / طارق أحمد عثمان محمد
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
 صفحة
119
صفحة
119
 جزء
1
جزء
1
3-4/3 بعض خصائص السنن الإلهية:
يرى رمضان خميس زكي، ولديه دراسة عن موضوع السنن الإلهية، أن أبرز خصائص هذه السنن: أنها سنن عامة، تنطبق على البشر جميعاً، وليست خاصة بطائفة دون طائفة ولا لجيل دون جيل والذي يؤكد عمومية الموضوع.. ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع بصورة من يرى المسـتقبل من خـلال السـنن حين يقول: «لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، أَهْلِ الْكِتَابِ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ» [1] ، حتى إنه يصـل في المشـابهة إلى أن يحشرهم في «جحر الضب».. ومثل هذا النظر إلى الموضوع هو الـذي نفتقده الآن، وعلينا أن نكتسبه.
هذه النظرة القرآنية، هي التي تجعـل المسلم قادرا على الاعتبار، الذي يلح عليه القرآن، فأمامنـا تجـارب القرون الماضية، تجارب كثيرة تظهر فيها سنن الأقوام التي يخضـع لها المسلمون أيضاً كأي قوم من الأقوام..
وهذا النظر القرآني يجـرد الإنسان من ملابساته ويرجعه إلى أصـله المجـرد، الـذي يخضـع للسنن، فالسنة الإلهية تجري على الجميع، لا فرق بين مجتمع [ ص: 119 ] ومجتمع، ولا فرق بين ديانة وديانة، ولا فرق بين جيل وجيل، وإلا لما دعا القـرآن الكريم إلى التفكر في آثار السابقين!
فالذي يفهم السـنن الإلهية وعمومها يملك القـدرة على التـعامل، ويحسن الاسـتعداد لنتائـجهـا، وقد قال قـوم جهلوا ذلك، بلغـة النـدم، في الآخرة، قال تعالى: ... nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=10وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك: 10).
كما تتسم السنن الإلهية (بالحاكمية والهيمنة) على الجميع، فهـي أيضاً مُطردة لا تتبدل، ومن هنا أمرنا الله بالاتعاظ والاعتبار.
ويرى أن القرآن الكريم حافل بالمعاني التي تؤكد هذا المعنى، كما أن السنة النبوية المُطهرة قد أشـارت إلى ذلك، فمثـلاً ما ذكره ابن كثير في تفسـيره عن زِيَادِ بْنِ لَبِيَدٍ، رضي الله عنه، أنه قال:
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شـيئاً فقال: «وَذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ»، قلنا: يا رسول الله، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِـلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَـاءَنَا، وأبنـاؤنا يقرؤونه لأبنـائهم إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فقال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ [ ص: 120 ] يا ابن لَبِيدٍ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُـلٍ بِالْمَدِينَـةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّـوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِا بِشَيْءٍ»؟
[2] .
أما رشيد كسوس، من جامعة القرويين، فقد نشر بحثاً في ذات الموضوع، فهو يجمل خصائص السنن الإلهية، ضمن ما يلي:
أنها ربانية: أي أنها مرتبطـة بالله عز وجل، وهذا يمنـحها قدسـية؛ لأنها صادرة من مصدر علوي، ولم تصدر عن حكم البشر، الذين يحكمهم القصور والعجز؛
وأنها ثابتة: وهذه الدائرة الثابتة تُضفي عليها الطمأنينة وتضمن للكون التناسق والتماسك في نظام، والهدف من الثبات هو إسقاط القول بالصدفة؛ وكذلك الاطراد من خصائص السنن؛
وهي عامة، كما أشرنا، تسـري على الجميـع؛
وهي كذلك واقعية: مثلاً من سـنن الله فيمن خلق أن يُعذب الظالم بيد ظالم آخر..
ومن الخصـائص أن السـنن طابعها الشـمول، فهي جامعة لا تقبل التجـزئة، وشـاملة لكل شـؤون الحيـاة؛ وهي أيضـاً متـوازنة، قال تعالى: [ ص: 121 ] nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=3مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ (الملك:3).. ثم ذكر خصائص أخرى استنبطها من آيات الكتاب
[3] .
وبذات الطريقة يتجه كثير ممن تناول مسألة السنن الإلهية وخصائصها، ويعمد إلى التركيز نحو عناصر بعينها ضمن هذه الخصـائص موضحاً أنها مسـتقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، على نحو الاسـتدلال بعدم التبدل أو التحول (الثبات) بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=62سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (الأحزاب: 62) ، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=43فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا (فاطر:43).
أو الاستدلال بخاصية حتمية الوقوع والنفاذ، فنجد ذلك في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مريم:35) ، nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=43فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا (فاطر:43) ،
أو الاستدلال بخاصية الشـمولية، بقوله سبحانه وتعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=123لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=124وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء:123-124).
[ ص: 122 ]
يرى رمضان خميس زكي، ولديه دراسة عن موضوع السنن الإلهية، أن أبرز خصائص هذه السنن: أنها سنن عامة، تنطبق على البشر جميعاً، وليست خاصة بطائفة دون طائفة ولا لجيل دون جيل والذي يؤكد عمومية الموضوع.. ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع بصورة من يرى المسـتقبل من خـلال السـنن حين يقول: «لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، أَهْلِ الْكِتَابِ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ» [1] ، حتى إنه يصـل في المشـابهة إلى أن يحشرهم في «جحر الضب».. ومثل هذا النظر إلى الموضوع هو الـذي نفتقده الآن، وعلينا أن نكتسبه.
هذه النظرة القرآنية، هي التي تجعـل المسلم قادرا على الاعتبار، الذي يلح عليه القرآن، فأمامنـا تجـارب القرون الماضية، تجارب كثيرة تظهر فيها سنن الأقوام التي يخضـع لها المسلمون أيضاً كأي قوم من الأقوام..
وهذا النظر القرآني يجـرد الإنسان من ملابساته ويرجعه إلى أصـله المجـرد، الـذي يخضـع للسنن، فالسنة الإلهية تجري على الجميع، لا فرق بين مجتمع [ ص: 119 ] ومجتمع، ولا فرق بين ديانة وديانة، ولا فرق بين جيل وجيل، وإلا لما دعا القـرآن الكريم إلى التفكر في آثار السابقين!
فالذي يفهم السـنن الإلهية وعمومها يملك القـدرة على التـعامل، ويحسن الاسـتعداد لنتائـجهـا، وقد قال قـوم جهلوا ذلك، بلغـة النـدم، في الآخرة، قال تعالى: ... nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=10وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك: 10).
كما تتسم السنن الإلهية (بالحاكمية والهيمنة) على الجميع، فهـي أيضاً مُطردة لا تتبدل، ومن هنا أمرنا الله بالاتعاظ والاعتبار.
ويرى أن القرآن الكريم حافل بالمعاني التي تؤكد هذا المعنى، كما أن السنة النبوية المُطهرة قد أشـارت إلى ذلك، فمثـلاً ما ذكره ابن كثير في تفسـيره عن زِيَادِ بْنِ لَبِيَدٍ، رضي الله عنه، أنه قال:
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شـيئاً فقال: «وَذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ»، قلنا: يا رسول الله، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِـلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَـاءَنَا، وأبنـاؤنا يقرؤونه لأبنـائهم إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فقال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ [ ص: 120 ] يا ابن لَبِيدٍ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُـلٍ بِالْمَدِينَـةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّـوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِا بِشَيْءٍ»؟
[2] .
أما رشيد كسوس، من جامعة القرويين، فقد نشر بحثاً في ذات الموضوع، فهو يجمل خصائص السنن الإلهية، ضمن ما يلي:
أنها ربانية: أي أنها مرتبطـة بالله عز وجل، وهذا يمنـحها قدسـية؛ لأنها صادرة من مصدر علوي، ولم تصدر عن حكم البشر، الذين يحكمهم القصور والعجز؛
وأنها ثابتة: وهذه الدائرة الثابتة تُضفي عليها الطمأنينة وتضمن للكون التناسق والتماسك في نظام، والهدف من الثبات هو إسقاط القول بالصدفة؛ وكذلك الاطراد من خصائص السنن؛
وهي عامة، كما أشرنا، تسـري على الجميـع؛
وهي كذلك واقعية: مثلاً من سـنن الله فيمن خلق أن يُعذب الظالم بيد ظالم آخر..
ومن الخصـائص أن السـنن طابعها الشـمول، فهي جامعة لا تقبل التجـزئة، وشـاملة لكل شـؤون الحيـاة؛ وهي أيضـاً متـوازنة، قال تعالى: [ ص: 121 ] nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=3مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ (الملك:3).. ثم ذكر خصائص أخرى استنبطها من آيات الكتاب
[3] .
وبذات الطريقة يتجه كثير ممن تناول مسألة السنن الإلهية وخصائصها، ويعمد إلى التركيز نحو عناصر بعينها ضمن هذه الخصـائص موضحاً أنها مسـتقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، على نحو الاسـتدلال بعدم التبدل أو التحول (الثبات) بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=62سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (الأحزاب: 62) ، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=43فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا (فاطر:43).
أو الاستدلال بخاصية حتمية الوقوع والنفاذ، فنجد ذلك في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=35إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مريم:35) ، nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=43فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا (فاطر:43) ،
أو الاستدلال بخاصية الشـمولية، بقوله سبحانه وتعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=123لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=124وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء:123-124).
[ ص: 122 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام


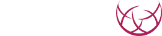








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات