المبحث الثالث
خصائص السياسة الوقائية في الإسلام
لا يمكن الوقوف على الأسس التنظيرية للسياسة الوقائية في الإسلام دون التأمل مليا في تلك الأبحاث الأصولية المعمقة التي سطرها العلماء المسلمون في موضوع: "سد الذرائع" [1] .
ومن أهم ما اشتملت عليه تلك الأبحاث مسألة الشروط التي تنضبط بها مسألة سد الذرائع "السياسة الوقائية"، بحيث تكون الإجراءات الوقائية محققة للغرض الوقائي دونما شطط يؤدي إلى التعسف أو الإضرار بالحقوق والمصالح [ ص: 59 ] الفردية والجماعية المشروعة، أو تهاون يؤدي إلى شيوع المفاسد وانتشارها.
وفي هذا السياق، ظهر حرص علماء الأصول على تأطير السياسة الوقائية بجملة من الضوابط الدقيقة، الجامعة بين فقه الشرع وفقه الواقع، فاشترطوا لسد الذرائع "= تنفيذ إجراءات المنع الوقائي" شروطا يمكن تلخيصها في الآتي:
أولا: أن يكون الفعل مفضيا إلى المفسدة كثيرا، بحيث تكون المفسدة أرجح من المصلحة، وذلك كبيع السلاح وقت الفتن، وكإجارة العقار لمن يتخذه محلا للقمار، وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرا، فهذه الأفعال وأمثالها حكمها التحريم من باب سد الذريعة.
وأما ما كان من الأفعال إفضاؤه إلى المفسدة قليلا أو نادرا، وكانت مصـلحته أرجـح من مفسـدته، وذلك كزراعـة العنب، فهذا يبقى على أصل الإباحة، ولا يمنع بحجة ما قد يترتب عليه من المفاسد؛ لأن المفسدة إن حدثت هنا فهي قليلة ونادرة ومغمورة في المصلحة الراجحة [2] .
[ ص: 60 ] ثانيا: أن لا تثبت الحاجة الملحة للإباحة، فأما إذا تعينت الحاجة الملحة فإن الحاجة تعتبر ويسقط العمل بسد الذريعة.
وهذا عام في كل أمر الأصل فيه المنع باعتبار المآل سـدا للذريعة، ولكنـه مما تمس الحـاجة إليه، وإذا حـرم شـق ذلك على النـاس وأوقعهم في الحرج، فإنه يستثنى من التحريم؛ لأن المشقة تجلب التيسير، "ولأن سد الذريعة مع الحاجة مناقض لانبناء الأحكام على المصالح" [3] .
ومثال ذلك إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبيع العرايا [4] مع نهيه عن بيع المزابنة [5] .
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على النخيل [ ص: 61 ] بخرصها [6] من التمر، مع أن "أصل هذا التعامل ربوي؛ لأنه بيع رطب بيابس من جنسه إلى أجل، وفيه كذلك غرر باعتبار أنه بيع معلوم بآخر مجهول، ولكنه أبيح للحاجة الملحة إلى ذلك، فلم يلتفت إلى المآل، وألغي سد الذريعة في هذا الباب" [7] .
وقد أبيحت العرايا مراعاة لحال الفقراء الذين لا نخل لهم، فأبيح لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخيل يأكلونه في شجره بخرصه من التمر [8] .
ثالثا: ألا يتعارض سد الذريعة مع نص شرعي [9] ، ومثاله: منع المرأة المسلمة الملتزمة باللباس الشرعي والآداب الشرعية من الذهاب إلى الصلاة في المساجد، بحجة سد الذريعة ومنع الفتنة. فمثل هذا الاحتجاج بسد الذريعة لا يقبل؛ لأنه يتعارض مع نصوص شرعية صحيحة وصريحة، كما في قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" [10] ، وقوله: "إذا اسـتأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" [11] ، [ ص: 62 ] وقوله: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن" [12] .
وقد ذهـب البعض إلى المنع من بـاب سـد الذريعة [13] ، واسـتدلوا لذلك بحديث أم المؤمنين عائـشـة، رضي الله عنها: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" [14] .
وما يجب ملاحظته هنا أن الإذن النبوي جاء محفوفا باشتراطات وقائية، منها: نهي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" [15] ، وقوله: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء [ ص: 63 ] الآخرة" [16] ، وأن لا تسبح إذا نابها شيء في الصلاة بل تصفق بباطن كفها على ظهر الأخرى [17] ، وأن تكون صفوف النساء خلف الرجال [18] .
فإذا ما التزمت المرأة المسلمة بالأحكام والآداب الشرعية في خروجها للمسجد لم يجز بحال أن تمنع منه، بحجة سد الذريعة، وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن!! قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن!! [19] .
- سمات السياسة الوقائية في الإسلام:
ومن خلال التأمل في هذه الضوابط التي وضعها علماء الأصول، وكذلك التأمل في الأحكام الشرعية التي كان منطلقها وقائيا، يمكن استنباط [ ص: 64 ] سمات وخصائص للسياسة الوقائية في الإسلام، وأهمها:
1- الواقعية:
ونعني بها التعامل بإيجابية مع الحقائق الموضوعية، ومن ذلك أخذ المصالح المعتبرة بعين الاعتبار في كل إجراء وقائي.
وقد رأينا هذه الواقعية في ذلك الضابط الذي يشترط إفضاء الفعل إلى مفسدة راجحة، أي أن يكون الغالب على الفعل هو حصول المفسدة منه، وبالتالي فالأفعال التي تؤدي إلى وقوع المفسدة غالبا هي التي يتم تطويقها بالإجراءات الوقائية، فتمنع من باب الوقاية وإن كانت مباحة في الأصل.
وأما الأفعال التي قد تنشأ عنها مفاسد محدودة، والمصلحة في وجودها أكبر، فهذه تبقى على أصل الإباحة رعاية لجانب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة [20] .
وذلك مثل زراعـة العنب الذي قد يتخذ منه الخمر، لكن المصـلحة في زراعته وانتفاع الناس بثمره أقوى من تلك المفسدة المحدودة، ولذلك يبقى على أصل الإباحة.
وهكذا، كل نشاط إنساني يحقق مصلحة راجحة، ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع، يجب تشجيعه، ولا يجوز منعه، أو الحد منه، بسبب حصول [ ص: 65 ] مفاسد قليلة أو نادرة بسببه، ما دامت المصلحة في وجوده أعظم، والنفع من ورائه أكبر.
ومن واقعية السياسة الوقائية في الإسلام مراعاتها لحاجات الناس، واستثناؤها ما تـمس الحـاجـة إليه من إجـراءات المنـع الوقـائي، كما رأيناه في استـثـنـاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيـع العرايا من التحريم، مراعاة لحاجة الفقراء.
وبهذه الرؤية الواقعية المحكومة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وبين ما تمس الحاجة إليه وما لا تمس، تسـلك السـياسة الوقائية في الإسلام سبيلا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط، وتؤدي دورها على أكمل وجه في حفظ المصالح المعتبرة، ودفع المفاسد المؤثرة، وتحقيق مصالح الناس، ودفع المشقة عنهم.
2- الشمول:
وهذه خاصية أخرى من خصائص السياسة الوقائية في الإسلام، ونعني بها تلك النظرة الشمولية التي ينظر بها الإسلام إلى المسألة الوقائية، وانعكاس تلك النظرة على الأحكام الشرعية التي يمكن وصفها بأنها ذات طابع وقائي.
فالتشريع الإسلامي حين يتوجه نحو معالجة ظاهرة ما بالإجراءات والتدابير الوقائية نجده يطوق تلك الظاهرة من جميع الجوانب، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية والتي هي في حقيقتها أحكام ملزمة، وطاعتها واجبة على كل مسلم ومسلمة.
[ ص: 66 ] وعلى سبيل المثال، نجد الإسلام يولي عنايته لمكافحة جريمة الزنا، ويسن جملة من الأحكام يمكن توصيفها بأنها أحكام أو تدابير وقائية، من ذلك:
ـ الأمر للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر:
قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن (النور:30-31).
ـ نهي النساء عن التبرج وعن إبداء الزينة:
قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (الأحزاب:33).
وقال سـبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون (النور:31).
ـ الحث على الزواج وتيسير المهور:
[ ص: 67 ] وفي ذلك آيات وأحاديث كثيرة نذكر منها:
قـوله تعـالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (النـور:32).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" [21] .
وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: "إياكم والمغالاة في مهور النسـاء، فإنها لو كانـت تقـوى عند الله أو مكرمة عند النـاس لكان رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - أولاكم بها.. ما نكح رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من اثني عشرة أوقية، وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما" [22] .
ـ أمر من لا يقدر على الزواج بالاستعفاف:
[ ص: 68 ] قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله (النور:33).
ومن الاستعفاف أمره صلى الله عليه وسلم للشباب غير القادرين على الزواج بالصيام: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" [23] .
ـ إقامة الحد على مرتكب جريمة الزنا:
وبعد هذه الجملة من الأحكام، التي يمكن ملاحظة المقصد الوقائي فيها بوضوح، يأتي الحكم بإقامة الحد على الزاني.
والحدود الشرعية تتسم بأنها عقوبات شديدة ورادعة، والمقصد الوقائي ظاهر فيها، بل هو أهم مقصد فيها، وهي "وإن كانت نادرا ما تقام في المجتمع المسلم، إلا أن هيبة الحد الشرعي تفعل في النفوس فعلها، فيرتدع أهل الشر والفساد، وينزجر أهل الغواية ومن في قلبه مرض، فتؤتي الحدود ثمارها أمنا وطمأنينة وعفافا وصلاحا في المجتمع..." [24] .
وهكذا، فالإسلام له رؤيته الشمولية في باب الوقاية، وتأتي الأحكام [ ص: 69 ] الشرعية لتعبر عن تلك الرؤية.
وفي الفصل القادم من هذا البحث سنقف على مثال تفصيلي على شمولية السياسة الوقائية في الإسلام، وذلك من خلال استعراضنا للإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
3- العدل:
العدل في الإسلام هو القيمة العليا، وكل القيم الأخرى ترتبط به، وهو قيمة مطلقة، فقد أمر الله به أمرا عاما شاملا مطلقا، وقدمه على غيره في الأمر به، فقال سـبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (النحل:90).
والعدل في الإسلام قيمة ناظمة لسائر القيم الأخرى، وموجهة لكل أعمال وأقوال الإنسان، وقد تنوعت الأوامر بالعدل في القرآن الكريم، فجاء فيه الأمر بالعدل في الحكم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء:58).
والعدل في القول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى (الأنعام:152).
والعدل في الكتابة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقرة:282).
[ ص: 70 ] والعدل في الصلح: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (الحجرات:9).
والعدل في حال البغض: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (المائدة:8).
والعدل مع الأقربين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (النساء:135).
والآيات في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم كثيرة، وقد بين الله في كتابه أنه ما أرسـل رسـله وأنزل كتبه إلا لإقـامـة العدل بين الناس، فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ... (الحديد:25) ، يقول ابن تيمية (ت728ه): "فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه..." [25] .
[ ص: 71 ] وشريعة الإسلام مدارها كلها على العدل، وغايتها تحقيق العدل، يقول الإمام ابن القيم (ت751هـ):
"فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه" [26] .
والسـياسة الوقائية في الإسـلام - شأن سائر القيم والمبادئ والأحكام والأقوال والأفعال - محـكومة بالعدل، فالعـدل هو الميـزان الذي توزن به كل الإجراءات والتدابير الوقـائية، وبالتالي فلا مجال في الإسلام للظلم أو التعدي على حقوق الآخرين في أي إجراء أو تدبير وقائي، ولا يمكن بحال في ظل شريعة الإسلام أن يتم تسويغ هضم الحقوق أو الانتقاص منها بذريعة السياسة الوقائية، أو تبرير الظلم والعدوان بحجة مكافحة الشر قبل وقوعه.
إن الدولة في الإسلام ملزمة برعاية حقوق ومصالح رعاياها كافة، مواطنين كانوا أم أجانب، والسـياسة الوقائية في الدولة الإسلامية تمارس تحت سـقف العدل، وهو ما يعني أنه عند اتخـاذ أي تـدابير أو إجراءات أو أحكام وقائية لمواجهة ظـاهرة أو مشـكلة ما فيجب [ ص: 72 ] أن يراعى فيها مبدأ العدل كمعيار وميزان توزن به كل الإجـراءات والتدابير والأحكام الوقائية.
[ ص: 73 ]
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية

الفساد المالي والإداري - رؤية إسلامية - في الوقاية والعلاج
الأستاذ / أمين نعمان الصلاحي
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
 صفحة
59
صفحة
59
 جزء
1
جزء
1
المبحث الثالث
خصائص السياسة الوقائية في الإسلام
لا يمكن الوقوف على الأسس التنظيرية للسياسة الوقائية في الإسلام دون التأمل ملياً في تلك الأبحاث الأصولية المعمقة التي سطرها العلماء المسلمون في موضوع: "سد الذرائع" [1] .
ومن أهم ما اشتملت عليه تلك الأبحاث مسألة الشروط التي تنضبط بها مسألة سد الذرائع "السياسة الوقائية"، بحيث تكون الإجراءات الوقائية محققةً للغرض الوقائي دونما شططٍ يؤدي إلى التعسف أو الإضرار بالحقوق والمصالح [ ص: 59 ] الفردية والجماعية المشروعة، أو تهاونٍ يؤدي إلى شيوع المفاسد وانتشارها.
وفي هذا السياق، ظهر حرص علماء الأصول على تأطير السياسة الوقائية بجملةٍ من الضوابط الدقيقة، الجامعة بين فقه الشرع وفقه الواقع، فاشترطوا لسد الذرائع "= تنفيذ إجراءات المنع الوقائي" شروطاً يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: أن يكون الفعل مفضياً إلى المفسدة كثيراً، بحيث تكون المفسدة أرجح من المصلحة، وذلك كبيع السلاح وقت الفتن، وكإجارة العقار لمن يتخذه محلاً للقمار، وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمراً، فهذه الأفعال وأمثالها حكمها التحريم من باب سد الذريعة.
وأما ما كان من الأفعال إفضاؤه إلى المفسدة قليلاً أو نادراً، وكانت مصـلحته أرجـح من مفسـدته، وذلك كزراعـة العنب، فهذا يبقى على أصل الإباحة، ولا يمنع بحجة ما قد يترتب عليه من المفاسد؛ لأن المفسدة إن حدثت هنا فهي قليلةٌ ونادرةٌ ومغمورةٌ في المصلحة الراجحة [2] .
[ ص: 60 ] ثانياً: أن لا تثبت الحاجة الملحة للإباحة، فأما إذا تعينت الحاجة الملحة فإن الحاجة تعتبر ويسقط العمل بسد الذريعة.
وهذا عام في كل أمرٍ الأصل فيه المنع باعتبار المآل سـداً للذريعة، ولكنـه مما تمس الحـاجة إليه، وإذا حـرم شـق ذلك على النـاس وأوقعهم في الحرج، فإنه يستثنى من التحريم؛ لأن المشقة تجلب التيسير، "ولأن سد الذريعة مع الحاجة مناقض لانبناء الأحكام على المصالح" [3] .
ومثال ذلك إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الْعَرَايَا [4] مع نهيه عن بيع الْمُزَابَنَةِ [5] .
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على النخيل [ ص: 61 ] بِخَرْصِهَا [6] من التمر، مع أن "أصل هذا التعامل ربوي؛ لأنه بيع رطب بيابس من جنسه إلى أجل، وفيه كذلك غرر باعتبار أنه بيع معلوم بآخر مجهول، ولكنه أبيح للحاجة الملحة إلى ذلك، فلم يلتفت إلى المآل، وألغي سد الذريعة في هذا الباب" [7] .
وقد أبيحت الْعَرَايَا مراعاة لحال الفقراء الذين لا نخل لهم، فأبيح لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخيل يأكلونه في شجره بخرصه من التمر [8] .
ثالثاً: ألا يتعارض سد الذريعة مع نص شرعي [9] ، ومثاله: منع المرأة المسلمة الملتزمة باللباس الشرعي والآداب الشرعية من الذهاب إلى الصلاة في المساجد، بحجة سد الذريعة ومنع الفتنة. فمثل هذا الاحتجاج بسد الذريعة لا يقبل؛ لأنه يتعارض مع نصوص شرعية صحيحة وصريحة، كما في قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" [10] ، وقوله: "إِذَا اسْـتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا" [11] ، [ ص: 62 ] وقوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ" [12] .
وقد ذهـب البعض إلى المنع من بـاب سـد الذريعة [13] ، واسـتدلوا لذلك بحديث أم المؤمنين عائـشـة، رضي الله عنها: "لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ" [14] .
وما يجب ملاحظته هنا أن الإذن النبوي جاء محفوفاً باشتراطات وقائية، منها: نهي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا" [15] ، وقوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ [ ص: 63 ] الْآخِرَةَ" [16] ، وأن لا تسبح إذا نابها شيء في الصلاة بل تصفق بباطن كفها على ظهر الأخرى [17] ، وأن تكون صفوف النساء خلف الرجال [18] .
فإذا ما التزمت المرأة المسلمة بالأحكام والآداب الشرعية في خروجها للمسجد لم يجز بحال أن تمنع منه، بحجة سد الذريعة، وقد روى مسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ، رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا". فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! [19] .
- سمات السياسة الوقائية في الإسلام:
ومن خلال التأمل في هذه الضوابط التي وضعها علماء الأصول، وكذلك التأمل في الأحكام الشرعية التي كان منطلقها وقائياً، يمكن استنباط [ ص: 64 ] سماتٍ وخصائصَ للسياسة الوقائية في الإسلام، وأهمها:
1- الواقعية:
ونعني بها التعامل بإيجابيةٍ مع الحقائق الموضوعية، ومن ذلك أخذ المصالح المعتبرة بعين الاعتبار في كل إجراءٍ وقائي.
وقد رأينا هذه الواقعية في ذلك الضابط الذي يشترط إفضاء الفعل إلى مفسدةٍ راجحة، أي أن يكون الغالب على الفعل هو حصول المفسدة منه، وبالتالي فالأفعال التي تؤدي إلى وقوع المفسدة غالباً هي التي يتم تطويقها بالإجراءات الوقائية، فتمنع من باب الوقاية وإن كانت مباحةً في الأصل.
وأما الأفعال التي قد تنشأ عنها مفاسد محدودة، والمصلحة في وجودها أكبر، فهذه تبقى على أصل الإباحة رعايةً لجانب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة [20] .
وذلك مثل زراعـة العنب الذي قد يتُخذ منه الخمر، لكن المصـلحة في زراعته وانتفاع الناس بثمره أقوى من تلك المفسدة المحدودة، ولذلك يبقى على أصل الإباحة.
وهكذا، كل نشاطٍ إنساني يحقق مصلحةً راجحة، ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع، يجب تشجيعه، ولا يجوز منعه، أو الحد منه، بسبب حصول [ ص: 65 ] مفاسدَ قليلةٍ أو نادرةٍ بسببه، ما دامت المصلحة في وجوده أعظم، والنفع من ورائه أكبر.
ومن واقعية السياسة الوقائية في الإسلام مراعاتها لحاجات الناس، واستثناؤها ما تـمس الحـاجـة إليه من إجـراءات المنـع الوقـائي، كما رأيناه في استـثـنـاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيـع الْعَرَايَا من التحريم، مراعاة لحاجة الفقراء.
وبهذه الرؤية الواقعية المحكومة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وبين ما تمس الحاجة إليه وما لا تمس، تسـلك السـياسة الوقائية في الإسلام سبيلاً وسطاً لا إفراط فيه ولا تفريط، وتؤدي دورها على أكمل وجهٍ في حفظ المصالح المعتبرة، ودفع المفاسد المؤثرة، وتحقيق مصالح الناس، ودفع المشقة عنهم.
2- الشمول:
وهذه خاصيةٌ أخرى من خصائص السياسة الوقائية في الإسلام، ونعني بها تلك النظرة الشمولية التي ينظر بها الإسلام إلى المسألة الوقائية، وانعكاس تلك النظرة على الأحكام الشرعية التي يمكن وصفها بأنها ذات طابعٍ وقائي.
فالتشريع الإسلامي حين يتوجه نحو معالجة ظاهرةٍ ما بالإجراءات والتدابير الوقائية نجده يطوق تلك الظاهرة من جميع الجوانب، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية والتي هي في حقيقتها أحكام ملزمة، وطاعتها واجبة على كل مسلم ومسلمة.
[ ص: 66 ] وعلى سبيل المثال، نجد الإسلام يولي عنايته لمكافحة جريمة الزنا، ويسنُ جملةً من الأحكام يمكن توصيفها بأنها أحكامٌ أو تدابيرُ وقائيةٌ، من ذلك:
ـ الأمر للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر:
قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (النور:30-31).
ـ نهي النساء عن التبرج وعن إبداء الزينة:
قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (الأحزاب:33).
وقال سـبحانه: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور:31).
ـ الحث على الزواج وتيسير المهور:
[ ص: 67 ] وفي ذلك آياتٌ وأحاديثُ كثيرةٌ نذكر منها:
قـوله تعـالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النـور:32).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" [21] .
وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: "إِيَّاكُمْ وَالْمُغَالَاةَ فِي مُهُورِ النِّسَـاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَـتْ تَقْـوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّـاسِ لَكَانَ رَسُـولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - أَوْلَاكُمْ بِهَا.. مَا نَكَحَ رَسُـولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا" [22] .
ـ أمر من لا يقدر على الزواج بالاستعفاف:
[ ص: 68 ] قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور:33).
ومن الاستعفاف أمره صلى الله عليه وسلم للشباب غير القادرين على الزواج بالصيام: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" [23] .
ـ إقامة الحد على مرتكب جريمة الزنا:
وبعد هذه الجملة من الأحكام، التي يمكن ملاحظة المقصد الوقائي فيها بوضوح، يأتي الحكم بإقامة الحد على الزاني.
والحدود الشرعية تتسم بأنها عقوباتٌ شديدةٌ ورادعة، والمقصد الوقائي ظاهر فيها، بل هو أهم مقصدٍ فيها، وهي "وإن كانت نادراً ما تقام في المجتمع المسلم، إلا أن هيبة الحد الشرعي تفعل في النفوس فعلها، فيرتدع أهل الشر والفساد، وينزجر أهل الغواية ومن في قلبه مرض، فتؤتي الحدود ثمارها أمناً وطمأنينةً وعفافاً وصلاحاً في المجتمع..." [24] .
وهكذا، فالإسلام له رؤيته الشمولية في باب الوقاية، وتأتي الأحكام [ ص: 69 ] الشرعية لتعبر عن تلك الرؤية.
وفي الفصل القادم من هذا البحث سنقف على مثالٍ تفصيلي على شمولية السياسة الوقائية في الإسلام، وذلك من خلال استعراضنا للإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
3- العدل:
العدل في الإسلام هو القيمة العليا، وكل القيم الأخرى ترتبط به، وهو قيمةٌ مطلقة، فقد أمر الله به أمراً عاماً شاملاً مطلقاً، وقدمه على غيره في الأمر به، فقال سـبحانه: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل:90).
والعدل في الإسلام قيمةٌ ناظمةٌ لسائر القيم الأخرى، وموجهةٌ لكل أعمال وأقوال الإنسان، وقد تنوعت الأوامر بالعدل في القرآن الكريم، فجاء فيه الأمر بالعدل في الحكم: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء:58).
والعدل في القول: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (الأنعام:152).
والعدل في الكتابة: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة:282).
[ ص: 70 ] والعدل في الصلح: nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات:9).
والعدل في حال البغض: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8).
والعدل مع الأقربين: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوِ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوِ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء:135).
والآيات في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم كثيرة، وقد بين الله في كتابه أنه ما أرسـل رسـله وأنزل كتبه إلا لإقـامـة العدل بين الناس، فقال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=25لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... (الحديد:25) ، يقول ابن تيمية (ت728ه): "فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه..." [25] .
[ ص: 71 ] وشريعة الإسلام مدارها كلها على العدل، وغايتها تحقيق العدل، يقول الإمام ابن القيم (ت751هـ):
"فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه" [26] .
والسـياسة الوقائية في الإسـلام - شأن سائر القيم والمبادئ والأحكام والأقوال والأفعال - محـكومةٌ بالعدل، فالعـدل هو الميـزان الذي توزن به كل الإجراءات والتدابير الوقـائية، وبالتالي فلا مجال في الإسلام للظلم أو التعدي على حقوق الآخرين في أي إجراءٍ أو تدبيرٍ وقائي، ولا يمكن بحالٍ في ظل شريعة الإسلام أن يتم تسويغ هضم الحقوق أو الانتقاص منها بذريعة السياسة الوقائية، أو تبرير الظلم والعدوان بحجة مكافحة الشر قبل وقوعه.
إن الدولة في الإسلام ملزمةٌ برعاية حقوق ومصالح رعاياها كافةً، مواطنين كانوا أم أجانب، والسـياسة الوقائية في الدولة الإسلامية تمارس تحت سـقف العدل، وهو ما يعني أنه عند اتخـاذ أي تـدابيرَ أو إجراءاتٍ أو أحكامٍ وقائيةٍ لمواجهة ظـاهرةٍ أو مشـكلةٍ ما فيجب [ ص: 72 ] أن يراعى فيها مبدأ العدل كمعيار وميزان توزن به كل الإجـراءات والتدابير والأحكام الوقائية.
[ ص: 73 ]
خصائص السياسة الوقائية في الإسلام
لا يمكن الوقوف على الأسس التنظيرية للسياسة الوقائية في الإسلام دون التأمل ملياً في تلك الأبحاث الأصولية المعمقة التي سطرها العلماء المسلمون في موضوع: "سد الذرائع" [1] .
ومن أهم ما اشتملت عليه تلك الأبحاث مسألة الشروط التي تنضبط بها مسألة سد الذرائع "السياسة الوقائية"، بحيث تكون الإجراءات الوقائية محققةً للغرض الوقائي دونما شططٍ يؤدي إلى التعسف أو الإضرار بالحقوق والمصالح [ ص: 59 ] الفردية والجماعية المشروعة، أو تهاونٍ يؤدي إلى شيوع المفاسد وانتشارها.
وفي هذا السياق، ظهر حرص علماء الأصول على تأطير السياسة الوقائية بجملةٍ من الضوابط الدقيقة، الجامعة بين فقه الشرع وفقه الواقع، فاشترطوا لسد الذرائع "= تنفيذ إجراءات المنع الوقائي" شروطاً يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: أن يكون الفعل مفضياً إلى المفسدة كثيراً، بحيث تكون المفسدة أرجح من المصلحة، وذلك كبيع السلاح وقت الفتن، وكإجارة العقار لمن يتخذه محلاً للقمار، وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمراً، فهذه الأفعال وأمثالها حكمها التحريم من باب سد الذريعة.
وأما ما كان من الأفعال إفضاؤه إلى المفسدة قليلاً أو نادراً، وكانت مصـلحته أرجـح من مفسـدته، وذلك كزراعـة العنب، فهذا يبقى على أصل الإباحة، ولا يمنع بحجة ما قد يترتب عليه من المفاسد؛ لأن المفسدة إن حدثت هنا فهي قليلةٌ ونادرةٌ ومغمورةٌ في المصلحة الراجحة [2] .
[ ص: 60 ] ثانياً: أن لا تثبت الحاجة الملحة للإباحة، فأما إذا تعينت الحاجة الملحة فإن الحاجة تعتبر ويسقط العمل بسد الذريعة.
وهذا عام في كل أمرٍ الأصل فيه المنع باعتبار المآل سـداً للذريعة، ولكنـه مما تمس الحـاجة إليه، وإذا حـرم شـق ذلك على النـاس وأوقعهم في الحرج، فإنه يستثنى من التحريم؛ لأن المشقة تجلب التيسير، "ولأن سد الذريعة مع الحاجة مناقض لانبناء الأحكام على المصالح" [3] .
ومثال ذلك إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الْعَرَايَا [4] مع نهيه عن بيع الْمُزَابَنَةِ [5] .
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب على النخيل [ ص: 61 ] بِخَرْصِهَا [6] من التمر، مع أن "أصل هذا التعامل ربوي؛ لأنه بيع رطب بيابس من جنسه إلى أجل، وفيه كذلك غرر باعتبار أنه بيع معلوم بآخر مجهول، ولكنه أبيح للحاجة الملحة إلى ذلك، فلم يلتفت إلى المآل، وألغي سد الذريعة في هذا الباب" [7] .
وقد أبيحت الْعَرَايَا مراعاة لحال الفقراء الذين لا نخل لهم، فأبيح لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخيل يأكلونه في شجره بخرصه من التمر [8] .
ثالثاً: ألا يتعارض سد الذريعة مع نص شرعي [9] ، ومثاله: منع المرأة المسلمة الملتزمة باللباس الشرعي والآداب الشرعية من الذهاب إلى الصلاة في المساجد، بحجة سد الذريعة ومنع الفتنة. فمثل هذا الاحتجاج بسد الذريعة لا يقبل؛ لأنه يتعارض مع نصوص شرعية صحيحة وصريحة، كما في قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" [10] ، وقوله: "إِذَا اسْـتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا" [11] ، [ ص: 62 ] وقوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ" [12] .
وقد ذهـب البعض إلى المنع من بـاب سـد الذريعة [13] ، واسـتدلوا لذلك بحديث أم المؤمنين عائـشـة، رضي الله عنها: "لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ" [14] .
وما يجب ملاحظته هنا أن الإذن النبوي جاء محفوفاً باشتراطات وقائية، منها: نهي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا" [15] ، وقوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ [ ص: 63 ] الْآخِرَةَ" [16] ، وأن لا تسبح إذا نابها شيء في الصلاة بل تصفق بباطن كفها على ظهر الأخرى [17] ، وأن تكون صفوف النساء خلف الرجال [18] .
فإذا ما التزمت المرأة المسلمة بالأحكام والآداب الشرعية في خروجها للمسجد لم يجز بحال أن تمنع منه، بحجة سد الذريعة، وقد روى مسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ، رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا". فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! [19] .
- سمات السياسة الوقائية في الإسلام:
ومن خلال التأمل في هذه الضوابط التي وضعها علماء الأصول، وكذلك التأمل في الأحكام الشرعية التي كان منطلقها وقائياً، يمكن استنباط [ ص: 64 ] سماتٍ وخصائصَ للسياسة الوقائية في الإسلام، وأهمها:
1- الواقعية:
ونعني بها التعامل بإيجابيةٍ مع الحقائق الموضوعية، ومن ذلك أخذ المصالح المعتبرة بعين الاعتبار في كل إجراءٍ وقائي.
وقد رأينا هذه الواقعية في ذلك الضابط الذي يشترط إفضاء الفعل إلى مفسدةٍ راجحة، أي أن يكون الغالب على الفعل هو حصول المفسدة منه، وبالتالي فالأفعال التي تؤدي إلى وقوع المفسدة غالباً هي التي يتم تطويقها بالإجراءات الوقائية، فتمنع من باب الوقاية وإن كانت مباحةً في الأصل.
وأما الأفعال التي قد تنشأ عنها مفاسد محدودة، والمصلحة في وجودها أكبر، فهذه تبقى على أصل الإباحة رعايةً لجانب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة [20] .
وذلك مثل زراعـة العنب الذي قد يتُخذ منه الخمر، لكن المصـلحة في زراعته وانتفاع الناس بثمره أقوى من تلك المفسدة المحدودة، ولذلك يبقى على أصل الإباحة.
وهكذا، كل نشاطٍ إنساني يحقق مصلحةً راجحة، ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع، يجب تشجيعه، ولا يجوز منعه، أو الحد منه، بسبب حصول [ ص: 65 ] مفاسدَ قليلةٍ أو نادرةٍ بسببه، ما دامت المصلحة في وجوده أعظم، والنفع من ورائه أكبر.
ومن واقعية السياسة الوقائية في الإسلام مراعاتها لحاجات الناس، واستثناؤها ما تـمس الحـاجـة إليه من إجـراءات المنـع الوقـائي، كما رأيناه في استـثـنـاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيـع الْعَرَايَا من التحريم، مراعاة لحاجة الفقراء.
وبهذه الرؤية الواقعية المحكومة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وبين ما تمس الحاجة إليه وما لا تمس، تسـلك السـياسة الوقائية في الإسلام سبيلاً وسطاً لا إفراط فيه ولا تفريط، وتؤدي دورها على أكمل وجهٍ في حفظ المصالح المعتبرة، ودفع المفاسد المؤثرة، وتحقيق مصالح الناس، ودفع المشقة عنهم.
2- الشمول:
وهذه خاصيةٌ أخرى من خصائص السياسة الوقائية في الإسلام، ونعني بها تلك النظرة الشمولية التي ينظر بها الإسلام إلى المسألة الوقائية، وانعكاس تلك النظرة على الأحكام الشرعية التي يمكن وصفها بأنها ذات طابعٍ وقائي.
فالتشريع الإسلامي حين يتوجه نحو معالجة ظاهرةٍ ما بالإجراءات والتدابير الوقائية نجده يطوق تلك الظاهرة من جميع الجوانب، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية والتي هي في حقيقتها أحكام ملزمة، وطاعتها واجبة على كل مسلم ومسلمة.
[ ص: 66 ] وعلى سبيل المثال، نجد الإسلام يولي عنايته لمكافحة جريمة الزنا، ويسنُ جملةً من الأحكام يمكن توصيفها بأنها أحكامٌ أو تدابيرُ وقائيةٌ، من ذلك:
ـ الأمر للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر:
قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (النور:30-31).
ـ نهي النساء عن التبرج وعن إبداء الزينة:
قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (الأحزاب:33).
وقال سـبحانه: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور:31).
ـ الحث على الزواج وتيسير المهور:
[ ص: 67 ] وفي ذلك آياتٌ وأحاديثُ كثيرةٌ نذكر منها:
قـوله تعـالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النـور:32).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" [21] .
وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: "إِيَّاكُمْ وَالْمُغَالَاةَ فِي مُهُورِ النِّسَـاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَـتْ تَقْـوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّـاسِ لَكَانَ رَسُـولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - أَوْلَاكُمْ بِهَا.. مَا نَكَحَ رَسُـولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا" [22] .
ـ أمر من لا يقدر على الزواج بالاستعفاف:
[ ص: 68 ] قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور:33).
ومن الاستعفاف أمره صلى الله عليه وسلم للشباب غير القادرين على الزواج بالصيام: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" [23] .
ـ إقامة الحد على مرتكب جريمة الزنا:
وبعد هذه الجملة من الأحكام، التي يمكن ملاحظة المقصد الوقائي فيها بوضوح، يأتي الحكم بإقامة الحد على الزاني.
والحدود الشرعية تتسم بأنها عقوباتٌ شديدةٌ ورادعة، والمقصد الوقائي ظاهر فيها، بل هو أهم مقصدٍ فيها، وهي "وإن كانت نادراً ما تقام في المجتمع المسلم، إلا أن هيبة الحد الشرعي تفعل في النفوس فعلها، فيرتدع أهل الشر والفساد، وينزجر أهل الغواية ومن في قلبه مرض، فتؤتي الحدود ثمارها أمناً وطمأنينةً وعفافاً وصلاحاً في المجتمع..." [24] .
وهكذا، فالإسلام له رؤيته الشمولية في باب الوقاية، وتأتي الأحكام [ ص: 69 ] الشرعية لتعبر عن تلك الرؤية.
وفي الفصل القادم من هذا البحث سنقف على مثالٍ تفصيلي على شمولية السياسة الوقائية في الإسلام، وذلك من خلال استعراضنا للإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
3- العدل:
العدل في الإسلام هو القيمة العليا، وكل القيم الأخرى ترتبط به، وهو قيمةٌ مطلقة، فقد أمر الله به أمراً عاماً شاملاً مطلقاً، وقدمه على غيره في الأمر به، فقال سـبحانه: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=90إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل:90).
والعدل في الإسلام قيمةٌ ناظمةٌ لسائر القيم الأخرى، وموجهةٌ لكل أعمال وأقوال الإنسان، وقد تنوعت الأوامر بالعدل في القرآن الكريم، فجاء فيه الأمر بالعدل في الحكم: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء:58).
والعدل في القول: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (الأنعام:152).
والعدل في الكتابة: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة:282).
[ ص: 70 ] والعدل في الصلح: nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات:9).
والعدل في حال البغض: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8).
والعدل مع الأقربين: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوِ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوِ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء:135).
والآيات في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم كثيرة، وقد بين الله في كتابه أنه ما أرسـل رسـله وأنزل كتبه إلا لإقـامـة العدل بين الناس، فقال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=25لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... (الحديد:25) ، يقول ابن تيمية (ت728ه): "فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه..." [25] .
[ ص: 71 ] وشريعة الإسلام مدارها كلها على العدل، وغايتها تحقيق العدل، يقول الإمام ابن القيم (ت751هـ):
"فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه" [26] .
والسـياسة الوقائية في الإسـلام - شأن سائر القيم والمبادئ والأحكام والأقوال والأفعال - محـكومةٌ بالعدل، فالعـدل هو الميـزان الذي توزن به كل الإجراءات والتدابير الوقـائية، وبالتالي فلا مجال في الإسلام للظلم أو التعدي على حقوق الآخرين في أي إجراءٍ أو تدبيرٍ وقائي، ولا يمكن بحالٍ في ظل شريعة الإسلام أن يتم تسويغ هضم الحقوق أو الانتقاص منها بذريعة السياسة الوقائية، أو تبرير الظلم والعدوان بحجة مكافحة الشر قبل وقوعه.
إن الدولة في الإسلام ملزمةٌ برعاية حقوق ومصالح رعاياها كافةً، مواطنين كانوا أم أجانب، والسـياسة الوقائية في الدولة الإسلامية تمارس تحت سـقف العدل، وهو ما يعني أنه عند اتخـاذ أي تـدابيرَ أو إجراءاتٍ أو أحكامٍ وقائيةٍ لمواجهة ظـاهرةٍ أو مشـكلةٍ ما فيجب [ ص: 72 ] أن يراعى فيها مبدأ العدل كمعيار وميزان توزن به كل الإجـراءات والتدابير والأحكام الوقائية.
[ ص: 73 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتب PDF
كتب PDF كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام


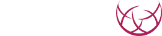








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات