الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليطب السائل الكريم نفسا، فإننا نرد السلام على أية حال، ولكننا نكتب أحيانا، ونكتفي بالرد بألسنتنا أحيانا، وإن لم نثبته في الجواب. ونرجو أن يلتمس لنا في ذلك العذر.
وأما ما سألت عنه فيتلخص جوابه في إيضاح مسألتين:
ـ الأولى: الفرق بين البدع، والمصالح المرسلة.
ـ والثانية: حكم فعل ما يُتقرَّب به إلى الله مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام.
وقد سبق لنا بيان هاتين المسألتين في الفتويين: 215017، 158183. وينظر للفائدة: الفتوى رقم: 134076.
وأما الأمثلة المذكورة في السؤال، كقول السلف في نصوص الصفات: "أمروها كما جاءت" فهذا لا يعنى النهي عن بيان معناها، وإنما يعني الإمساك عن الخوض في كيفيتها، ولذلك جاءت هذه العبارة بلفظ: "أمروها كما جاءت بلا كيف" والمراد بذلك: إثبات حقيقة المعاني، والإيمان بها، مع نفي العلم بالكيفية. وليس المقصود أنهم يؤمنون باللفظ من غير فهم لحقيقة معناه، فهم يفهمون المعنى، ويفوضون في الكيفية.
قال شخ الإسلام ابن تيمية: لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول» ، ولما قالوا: «أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومًا، بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية، أو الصفات مطلقًا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: (بلا كيف) فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا (بلا كيف).
وأيضا: فقولهم: أمروها كما جاءت، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإن هذه الألفاظ جاءت دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: "أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد" أو "أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقة. اهـ.
وأما وضع كتب الفقه المقارن، أو التفاسير المطولة أو غيرها من كتب العلم التي لم يوجد مثلها في عصر الصحابة، فليس له علاقة بالنهي عن التكلف! فإن أصل كتابة العلم بدأ في عصر الصحابة، ثم زادت الحاجة إلى حفظه، وضبطه، فكثر التأليف. ثم إن وقع تكلف أو تنطع في بعض الكتب المتأخرة، فهذا يذم بخصوصه!
وأما قصة عمر مع قوله تعالى: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا {عبس:31}. فليس لها علاقة بقضية الابتداع في الدين، والاستدلال بها هنا ليس في محله؛ فإن كل من خفي عليه شيء من القرآن لم يجز له أن يتكلم فيه بلا علم، وهذا لا ينفي أن يتكلم غيره ممن عنده بذلك علم، وقد فسر ابن عباس هذه الآية بمحضر عمر فلم ينكر عليه.
قال ابن حجر في (فتح الباري): قد جاء أن ابن عباس فسر الأبّ عند عمر، فأخرج عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير قال: كان عمر يدني ابن عباس ـ فذكر نحو القصة الماضية في تفسير: {إذا جاء نصر الله}. وفي آخرها: وقال تعالى: {أنا صببنا الماء صبا ـ إلى قوله ـ وأبّا} قال: فالسبعة رزق لبني آدم، والأب ما تأكل الأنعام. ولم يذكر أن عمر أنكر عليه. اهـ.
وقال ابن الجوزي في (كشف المشكل): هذا الحديث يحتمل ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يكون عمر قد علم الأب؛ لأنها كلمة شائعة بين العرب، وأنه الذي ترعاه البهائم، ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لا يعلم، كما كان يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله، وأنا شريككم. يريد الاحتراز، فإن من احترز قلت روايته.
والثاني: أن يكون ذلك خفي عنه كما خفي عن ابن عباس معنى: {فاطر السماوات} [الأنعام: 14] .
والثالث: أن يكون قد ظن بهذه الكلمة أنها تقع على مسميين، فتورع عن إطلاق القول. وأصل التكلف: تتبع ما لا منفعة فيه، أو ما لا يؤمر به الإنسان، ولا يحصل إلا بمشقة. فأما إذا كان مأمورا به، وفيه منفعة، فلا وجه للذم. وقد فسر رسول الله آيات، وفسر كثير من الصحابة كثيرا من القرآن. قال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيم أنزلت، وماذا عني بها. اهـ.
وأما ما طلبه السائل من التعريف المنهجي الكامل، لا تتشوف النفس إلى شرح بعده، فهذا مما يتعذر علينا هنا؛ لأنه يحتاج إلى كتاب متخصص، ولا يسعنا القيام بذلك في مجال الفتوى. ولتحصيل ذلك يمكن أن يرجع السائل إلى كتاب متخصص ـ وهي كثيرة بحمد الله ـ في باب البدع، ومن هذه الكتب الميسرة السهلة كتاب: (قواعد معرفة البدع) للدكتور محمد حسين الجيزاني.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
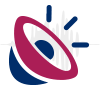
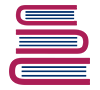
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات