الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعجبُ مرضٌ قلبيٌ خطير، وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو لم تذنبوا لخشيتُ عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. رواه البيهقي في الشعب وحسنه الألباني، ومما يعينكَ على التخلص منه:
1- استحضارُ خطره ، واستشعار أنه مما يتلف دين العبد، ويحبطُ عمله .
2- معرفة قدر النفس وأنها داعيةٌ إلى كل شر، وأن ما بها من خير وفضل فإنما هو محضُ منة الله عليها: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}
3- النظرُ في سير الصالحين والمجتهدين في عبادة الله عز وجل حقا ، وكيف كانوا مع شدة اجتهادهم يجمعون إلى ذلك الخوف من أن تحبط أعمالهم ، وما نحنُ بالنسبة إليهم في العبادة إلا كالحصاةِ إلى الجبل ، فالتأسي بهم هو الواجبُ على المسلم الصادق .
4- معرفةُ أن العجبَ سجيةُ إبليس فمن اتصف به كان متشبهاً بهذا اللعين ، فإنه هو القائل كما أخبر الله تعالى عنه: أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين .
5- مداومة النظر في الذنوب ، ولزوم الاستغفار منها والحذرُ من أن تكون سبباً لهلاك العبد.
وأما ما ذكرته من تركك لبعض الصلوات فهو والله من أعظم ما يُتعجب منه ، فكيفَ يصيبك عجبٌ ، وبأي شيءٍ تُعجب وأنت ترتكبُ هذه الكبيرة التي هي شرٌ من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ، بل هي كفرٌ عند طائفة من أهل العلم ، وأما نسبتكَ ذلك إلى القدر ، ونسبتك الطاعة إلى نفسك فهو من تلبيس الشيطان عليك ، والذي ينبغي هو عكس تلك القضية ، فينسبُ الإنسان معصيته إلى نفسه لأنه هو المتسبب فيها والمكتسبُ لها ، وينسبُ الفضل في طاعته إلى ربه لأنه هو المانَّ والمتفضل بها ، والكل بقدر الله كما قال عز وجل {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ {النساء :79 }.
قال السعدي رحمه الله: { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ } أي: في الدين والدنيا { فَمِنَ اللَّهِ } هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها. { وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ } في الدين والدنيا { فَمِنْ نَفْسِكَ } أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. انتهى
وأما بطلان الاحتجاج بالقدر على الذنوب فقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 67894
وقد فصلنا القول في الحسد وكيفية علاجه في الفتوى رقم: 5557 ، والواجبُ عليكَ الأخذُ بأسباب العلاج المفصلة في تلك الفتوى.
وما دمت تُجاهد نفسك للتخلص من هذا الداء ، ولا تعمل بما يوجبه من السعي في أذية المسلمين والنيل منهم ، بل تحاولُ أن تطهر قلبك من الحسد لهم ، وتحرص على سلامتهم من لسانك ويدك فلا إثم عليك إن شاء الله ، وقد بين العلماء الحد الذي يأثمُ به من وقع في قلبه الحسد والذي يُعفى عنه منه ، قال الصنعاني في سبل السلام : ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه، بل لعله مأجور في مدافعة نفسه، فإن سعى في زوال نعمة المحسود فهو باغٍ، وإن لم يسع ولم يظهره لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور وإلا فلا؛ أي لا وزر عليه لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها.
وفي الإحياء: فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة فهو حسود حسداً مذموماً، وإن كان نزعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة من محسوده مهما كان كارهاً لذلك من نفسه بعقله ودينه. اهـ
وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعاً: ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظنّ والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ. وأخرج أبو نعيم: كل ابن آدم حسود، ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد. وفي معناه أحاديث لا تخلو عن مقال.
وفي الزواجر لابن حجر الهيثمي: إن الحسد مراتب: وهي إما محبة زوال نعمة الغير، وإن لم تنتقل إلى الحاسد، وهذا غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه أو انتقال مثلها إليه، وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه أو لا مع محبة زوالها، وهذا الأخير هو المعفوّ عنه من الحسد إن كان في الدنيا، والمطلوب إن كان في الدين. انتهى.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

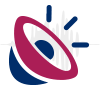
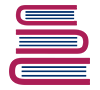
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات